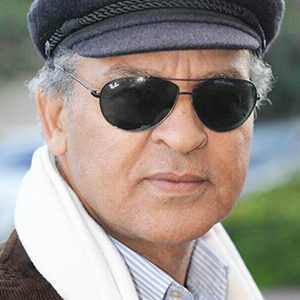أية دلالة لاحتجاجات الريف؟

عادت الاحتجاجات بقوة مع مطلع هذه السنة إلى منطقة الريف، بعدما تفاعل الرأي العام المغربي في الأشهر القليلة الماضية عبر حركاته الاحتجاجية ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، وغير مسبوق مع وفاة الشاب محسن فكري بائع السمك، وإبن منطقة الريف، بعدما لقي حتفه في شاحنة لنقل الأزبال نتيجة محاولته منع سلعته المصادرة من طرف رجال الشرطة ومحاولة إتلافها. وقد كانت هذه الاحتجاجات على السلطة، وتنديدا للإحساس المشترك لدى المغاربة بالظلم الاجتماعي والذي يعبر عنه في صيغته المغربية بالإحساس ب”الحُكرة”. الأمر الذي أخرجهم للاحتجاج خريف السنة الماضية في جل المدن المغربية، وجعلهم يتضامنون مع مقتله بشكل كبير بعد انتشار الرمز الوهمي بعبارة “طحن مو” الذي يشير إلى “الحُكرة”، والذي رافق نقل الحادث إلى مواقع التواصل الحديثة، وخلق فهما لدى ساكنة الريف ولدى باقي المغاربة، على أنه قتل بسبب رجال الشرطة، مما كان محرضا على الاحتجاج. واستمرت هذه الاحتجاجات بمدينة الحسيمة على خلفية التباطؤ في التحقيق في محاكمة المتورطين في مقتله، حاولت السلطات الحد منها، مما دشن لموجة ثانية من الاحتجاج، تطالب برفع الحصار والتهميش عن المنطقة، تضامنت معها ساكنة الريف.
آراء أخرى
فأية دلالة لهذه الاحتجاجات؟ وكيف تستمر بمنطقة الريف؟
تُفهم هذه الاحتجاجات خلال الموجة الأولى، والتي امتدت جغرافيا إلى باقي مدن المغرب عبر حملة تضامن واسعة، في سياق الإحساس بالظلم الاجتماعي. فقد أيقظ الحادث الإحساس الدفين لدى المغاربة ب”الحُكرة”، والذي تراكم لديهم لعدة عقود. في حين تفهم الموجة الثانية، والتي اقتصرت على مدينة الحسيمة، وتضامن كل من طنجة، والناظور، ومارتيل، في سياق عقود من “الحُكرة” والتهميش، استبطنها المحتجون من تاريخهم السياسي الطويل إزاء السلطة، المليء بالمقاومة والتهميش، فقد بات محسن فكري رمزا ل”الحُكرة” بالمغرب، والنقطة التي أفاضت الكأس، وعرت واقع منطقة الريف. وبالتالي شكلت في كلتا الحالتين، النقطة التي أفاضت الكأس عن الإحساس المتراكم لدى المغاربة ب”الحُكرة”.
إن هذا التحليل لهذه الاحتجاجات عبر وجود إطار تأويلي عام مفسر لاحتجاجات مغرب اليوم، يدحض بشكل كبير أطروحة الفتنة، والتي سعت إلى الحد من التضامن مع هذه الاحتجاجات التي لا تعدو أن تكون كسائر احتجاجات مغرب اليوم التي يحركها الإحساس الدفين بعقود من التهميش، سيما بمنطقة الريف التي تشهد خصوصية تاريخها السياسي إزاء السلطة المركزية، والذي لم تمحوه الإجراءات العديدة التي دشنها العهد الجديد للمصالحة، وذلك بحكم أن مشاريع التنمية بالريف لا تطمح إلى حجم انتظارات الساكنة.
وما يعزز من هذا التفسير كمحدد للاحتجاجات ويستبعد أطروحة الفتنة، هما معطيين واقعيين:
أولا، تغير موقف الملكية تجاه الريف وتطور تعريف الهوية الوطنية في دستور 2011 عبر صياغة تعريف واسع تتداخل فيه الملكية الدين والأمة، ساهم في تهميش “حركة من أجل الحكم الذاتي للريف” ، كما أن هذا التعريف يتحدى تعريف الهوية التي تحركها الحركة الريفية. وحتى إذا كانت مرجعيات هذه الأخيرة قوية إيديولوجيا، فهي لا زالت مدعومة بشكل أقل. فأعمال الحركة تقتصر في الوقت الحاضر على مشاركة خجولة في ندوات الجمعيات الجهوية الأوروبية أو في دعم فريق كرة القدم الريفي من أجل المشاركة في كأس عالم الشعوب الأقليات .
ثانيا، منذ حصول المغرب على الاستقلال، وضعت الدولة المغربية مجموعة من الشروط البنيوية لا تحصن فقط من الثورات، وإنما لا تعطي الإمكانية لتشكل “حركات سياسية”، أهمها استراتيجية التحييد عبر نزع الطابع السياسي عن الحركات الاجتماعية من خلال استراتيجيتين تشتغلان كضمانة لهذا التحييد، وهما تجزيء النضال ثم شراء السلم الاجتماعي. وهما ما تعبر عنهما أطروحة النقابية الضيقة l’Anarcho- syndicalisme ، ثم أطروحة الصفقة السلطوية The Authoritarian Bargain ، ويعبر عنهما في السياق المغربي بسياسة الخبز وشراء السلم الاجتماعي. واتسمت مرحلة التسعينات بوجود ظرفية مائعة في الاحتجاج conjoncture fluide ، تجلت في التقاء الإيديولوجيات المختلفة في حركة اجتماعية واحدة لأنها أصبحت حركات لا سياسية بفعل التحييد.
ألم يتم تحييد الحركة النقابية في الستينات عبر سياسة الخبز وتجزيئها عبر ظهير 1960 حول التعددية النقابية ؟ ألم يتم تحييدها كذلك في ظل الربيع المغربي سنة 2011 عبر اتفاق 26 أبريل؟ وتحييد الحركة النقابية يعني تحييد نضالات موظفي القطاع العام، ومستخذمي القطاع الخاص التي كانت من الممكن أن تشكل قاعدة قوية لحركة 20 فبراير . ألم تلجأ الدولة إلى تحييد حركة الشباب العاطل عبر استراتيجية “التوظيف مقابل عدم التسييس” ؟ ألم تظهر حركة 20 فبراير بدون إيديولوجية أو إطار تأويلي موحد سنة 2011 في سياق ما يسميه الباحثون بالظرفية المائعة ؟
في ظل هذا السياق الواسع، لا تُطرح مسألة الفتنة في احتجاجات الحسيمة بقدر ما يُطرح واقع التهميش و”الحُكرة” التي يشعر بها كل المغاربة الذين ينضمون إلى الحركات الاجتماعية. إذ باتت “الحُكرة” بمثابة إطار تأويلي رئيسي master frame ، يفسر جل الحركات الاجتماعية المغربية في الوقت الحاضر. وبالتالي تبقى مفسرة لاحتجاجات الحسيمة، التي لا تنفصل عن احتجاجات مغرب اليوم. إذ تشكل “الحُكرة” إطارا تأويليا رئيسيا ، يستمد شرعيته من بنية اجتماعية وثقافية تأطرت على هذا الإحساس منذ نشوء الحركة الوطنية.
تاريخ “الحُكرة” بالمغرب
يمكن قراءة الحيف الذي يؤطر حركات مغرب اليوم، بحسب مصطفى بوعزيز ، في الزمن الطويل للحركات الاجتماعية، بحيث يرتبط بعقلية الاحتجاج لدى المغاربة. إذ يعتبر على أن المغاربة يوجدون في مرحلة الدونية على مستوى الحركات الاجتماعية، وبأن الحركات الاجتماعية المغربية إلى حدود حركة 20 فبراير، خاضعة لما يمكن أن نسميه نموذجا مغربيا للحركات الاجتماعية، والذي يتمثل في الإحساس بالدونية أي الإحساس بالحيف. ويلتقي هذا المفهوم المرتبط بالحيف مع المعنى الذي يقدمه التاريخيون للحركة الاجتماعية، بحيث يعتبرونها بأنها “تحرك جماعي وسط المجتمع يتأسس على قاعدة حيف وشعور بالدونية، وينطلق بهدف رفع الغبن وجبر الضرر”.
وتعود جذور هذا الحيف إلى نشأة الحركة الوطنية، حيث يرى مصطفى بوعزيز على أن الحركة الوطنية المغربية هي حركة اجتماعية كبيرة قبل أن تكون حركة سياسية، تشكلت كرد فعل ضد الحيف، فهم أغلبية في البلاد، ولكن في المجتمع هم دون الآخرين mise au minorité. وهذا رُكز في المغرب في شتى الميادين، ليس فقط في الثقافة، رُكز في الفلاحة العصرية/ الفلاحة التقليدية، المدينة القديمة/ المدينة العصرية، رُكز في مجال الشغل، ولو أنهم يقومون بنفس العمل، فهذا بأجر معين وهذا بأجر أقل، بمعنى أن المغاربة موجودين في مرحلة الدونية. وهو نفس المفهوم الذي سيكون عند الحركات التي تفرعت لاحقا من الحركة الوطنية.
ويضيف بأن المغاربة عندما بدؤوا في القيام بالعمل المدني كانت مطالباتهم أن يكونوا مثل الأوروبيين بالمغربة، نفس الحقوق، الحق في التعليم، في الصحة، الحق في نفس الأجر، الحق في الفضاءات، إذ كانت هناك فضاءات غير مسموح بأن يلجها الأهالي، كان هذا الحيف موجودا، وتراكم مدة، وسيؤدي بالحركة الوطنية أن تصبح حركة اجتماعية لرفع الحيف. وهذا هو الذي يشرح لماذا فيها العامل، لماذا فيها المديني والبدوي، لماذا فيها البورجوازي. حتى البورجوازيين كلهم كانوا في الحركة الوطنية، ومستوياتهم الاجتماعية مختلفة عن الآخرين، ولكن ما كان يجمعهم أنهم في مرتبة اجتماعية دونية أمام الآخرين. ومن هنا، كان رد فعل واجتمعوا. وهذه الحملة الكبيرة للحركة الوطنية كحركة اجتماعية خرجت منها الحركة النسائية في الأربعينات، الحركات الكشفية، الحركات الرياضية، الحركة المسرحية، حركة الشباب الذين سيعطون فيما بعد الاتحادات الطلابية. هذه التنظيمات كلها تفرعت من الحركة الوطنية.
وحتى في ظل أكبر حركة للتغيير عرفها المغرب بعد الحركة الوطنية، والتي سميت بحركة 20 فبراير، فقد تميزت بتبني خطابات وشعارات ترمي في مجملها إلى المجاهرة باللامساواة وانعدام العدالة الاجتماعية، فتم تنصيب مفهوم “الحكرة” ككلمة مفتاح لحركة 20 فبراير في الفضاء الواقعي والفضاء الافتراضي . وقد ظهرت كاستمرارية وتجديد للنضال الديمقراطي بجميع أشكاله. إذ جسدت هذه الحركة بعثا لمشروع سياسي سابق لم يتسن له أن يرى النور، ولا يزال يحتفظ براهنيته، يتمثل في مشروع إحقاق الكرامة ورد الاعتبار للمغاربة .
كما حملت الحركة مطلبا رئيسيا تمثل في فصل السلطة عن الثروة. وهو فصل يندرج في منطق متعلق بإقامة حدود جديدة بين الأنشطة السياسية والأنشطة الاقتصادية. إذ يعبر فصل هذين النشاطين عن انتظارات المواطنينن في مجال توزيع الثروات ومحاسبة المسؤولين. وفي مستوى آخر، يبين هذا المطلب بأن الاقتصاد مضمن في الاجتماعي، إذ يعبر فاعلو الحركة من خلاله عن العدالة وتحديد ما هو مسموح به أو ما هو غير مسموح به في مجال التعاملات الاقتصادية. وبالتالي، تتيح مطالب حركة 20 فبراير التفكير برؤى ما هو عادل وغير عادل في مجال الاقتصاد . وفي مارس 2011، استمر خروج الحركة ورفع شعارات تطالب بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وفي أبريل من نفس السنة، نظمت الحركة خرجات أسبوعية للتنديد بمهرجان موازين، وبطريقة عمل لجنة المنوني، والتأكيد على شعار الحرية والكرامة والعدالة، وشعار “الشعب يريد مغربا جديدا” .
إن “الحُكرة” كمفسر لحركات مغرب اليوم تظهره مجموعة من الدراسات التي تطرقت إلى الظاهرة الاحتجاجية بالمغرب، تجمع على وجود هذا المحرك الرئيسي للاحتجاجات. فبحسب دراسة لعبد الرحمان رشيق، فخلال السنوات الأخيرة، اغتنى الخطاب الاحتجاجي المرتكز على فكرة التهميش والإقصاء الاجتماعي بمفردات جديدة للاحتجاج مرتبطة بالكرامة و”الحُكرة”. وتعبر هذه الأخيرة عن الحرمان الاجتماعي لبعض الفئات الاجتماعية، وعن شعور فئة اجتماعية بعدم الاعتبار الاجتماعي لها وفقا لقيمتها الصحيحة. والتكرار المنتظم لموضوع “الحُكرة” المقترن بالكرامة له دور معبئ . وبحسب سعيد بنيس، يمكننا استنتاج أن مفهوم “الحُكرة” تحول من البنية الاجتماعية العامة إلى فاعلين محددين، ويمثل توظيفه بحسب نفس الباحث، شحنة ناقلة للتعبئة والفعل الاحتجاجي والنضالي .
إن احتجاجات الحسيمة ليست بمعزل عن احتجاجات مغرب اليوم. فبعدما شهدت عدة مدن مغربية مظاهرات واسعة منددة بإهانة كرامة المواطنين بعد مقتل محسن فكري. فقد استمرت هذه الاحتجاجات على خلفية التحقيق بمدينة الحسيمة، لتستقر بالمدينة وبمنطقة الريف، عبر موجة ثانية، لا تطالب فقط بالكشف عن نتيجة التحقيق، وإنما إخراج المدينة من التهميش. لكن، إذا كانت الموجة الأولى من الاحتجاج أججتها عقود من التهميش والإحساس بالظلم الاجتماعي، فما الذي يفسر انتعاشها بمنطقة الريف، عبر موجة ثانية من الاحتجاج، وعدم استمرارها بنفس الوتيرة في باقي مدن المغرب التي تعاني أيضا ولعدة عقود من التهميش؟
إن هذه الملاحظة تجعلنا نستنتج وجود محدد آخر في هذه الاحتجاجات إلى جانب الإحساس بالظلم الاجتماعي، يشتغل كمحفز، وكآلية في التعبئة على المستوى المحلي، يفسر لنا كيف تستمر الحركات الاجتماعية بمغرب اليوم. وهو في حالة مدينة الحسيمة، وجود روابط مشتركة سهلت عملية التضامن وأنعشت الاحتجاج، أولا، بحكم أنها مدينة صغيرة مجاليا، حيث يكون الرابط الاجتماعي قويا، يضاف إلى ذلك، رابط منظومة الاعتقاد، حيث لدى المحتجين مخيال جماعي يستلهم تمثلاته من التاريخ السياسي للمنطقة تجاه السلطة، وهو تاريخ مليء بالنضال والتهميش، ويعبر عن هوية مشتركة لساكنة الريف.
خلال السنوات الأخيرة، اغتنى الخطاب الاحتجاجي المرتكز على فكرة التهميش والإقصاء الاجتماعي بمفردات جديدة للاحتجاج مرتبطة بالكرامة و”الحُكرة”. وتعبر هذه الأخيرة عن الحرمان الاجتماعي لبعض الفئات الاجتماعية
الرابط الاجتماعي
تشكل الروابط الاجتماعية نظريا موارد علائقية لترجمة استياء إلى احتجاج. إذ تؤدي إلى تماسك التنظيم عبر الروابط الاجتماعية، وتشمل الموارد العلائقية، نظريا، العلاقات الاجتماعية التي تؤسس التماسك والتنظيم الداخلي للمجموعة المعنية، ويعطي هذا النوع من الموارد القدرة على الانخراط في تعبئة مستدامة بحكم وجود روابط داخل التنظيم تضمن تماسك الحركة، في حين أن المجموعات التي تفتقر إلى التماسك والتنظيم الداخلي يكون لديها صعوبة أكبر في إعطاء استيائها بعدا جماعيا .
وهذا ما تبينه احتجاجات الحسيمة. فجل المحتجين ينتمون إلى نفس المدينة وإلى منطقة الريف. كذلك، المعطى النظري السابق، هو ما تبينه مثلا، الفوارق بين التعبئة في مدينة كبيرة، حيث يغيب عنصر التضامن وتكون الروابط الاجتماعية مفككة، وبين التعبئة على المستوى المحلي، في مدينة صغيرة، حيث تسود روابط التضامن. إذ يوفر الفضاء المحلي، نظريا، وسائل مصغرة للتعبئة. وهو جانب ركزت عليه نظريات التعبئة، بعدما ركزت في السابق على عنصر التنظيم، حيث تشمل تعبئة الموارد كل الوسائل الشكلية وغير الشكلية التي يتعبئ من خلالها الأفراد وينخرطون في فعل جمعي، فهي تضم مثلا، الأماكن الاعتيادية التي تسهل بناء الفعل الجمعي(الحي، مكان العمل…إلخ)، والتي تعد بنيات غير شكلية يسميها ماك آدم ب contextes de micro-mobilisation .
إن هذا ما يبينه تضامن كل من الناظور ومارتيل مع الحسيمة، إلى جانب إضراب عام في الحسيمة تمثل في إغلاق المقاهي والمحلات التجارية، ووقفات احتجاجية تضامنية بكل من طنجة والناظور. وحمل المواطنين بشكل مجاني من طرف سائقي سيارات الأجرة يوم جنازة محسن فكري، وقدوم المواطنين للجنازة من وجدة ومن المدن التي تحادي الحسيمة وتعاني بدورها التهميش، وتضامن من جميع المهنيين عندما خرج الناس للاحتجاج في الحسيمة منذ الصباح الباكر خلال جنازة محسن فكري، وتنظيم مسيرة احتجاجية في المساء. من هنا يمثل الفضاء الجغرافي espace géographique وسيلة للتعبئات الجماعية . ويساهم التنظيم المكاني المشكل بيئيا، ثقافيا واجتماعيا في جمع، أو، على العكس، تشتت السكان والمجموعات الاجتماعية. وانطلاقا من هذا المعطى، يكون له ثقل على ميله إلى التعبئة، وحتى في غياب الشبكات الموجودة مسبقا، يمكن للمظهر المكاني أن يعمل كمحدد للتعبئة .
إن الرابط الاجتماعي لم يكن متاحا في المجال العام إلا في حدود التسعينات. إذ ساهمت الدولة في تفكيكه ومنع تشكله. فبحسب عبد الرحمان رشيق، كان النظام في الفترة التالية لاستقلال المغرب حتى مطلع التسعينات، يعبر من خلال أفعاله، عن كراهيته وحنقه تجاه الجمهور، والاحتشاد، وتجاه كل الفضاءات التي يمكن لها أن تخلق سيرورات التواصل الاجتماعي اليومي. وكان إفراغ الفضاءات العمومية قد صار هدفا أمنيا، والذي تجلى في منع كل احتشاد لأكثر من خمسة أشخاص، مداهمات عامة للمارة ابتداءا من الساعة الثامنة ليلا، إغلاق أبواب المساجد فور انتهاء الصلاة، إلخ. والدولة بهذا الموقف تبطل تأثير الفضاءات العمومية. وإلى حدود التسعينات، سيظهر المجال العام .
ورغم ذلك، يبقى الشارع خاليا من تشكل روابط الهوية والمجال بين أشخاص لا يتعارفون مسبقا، وهذا ما يمكننا استنتاجه من التقرير الوطني حول الرابط الاجتماعي والذي يقدم معطى أن الروابط الجماعية المؤسسة للمجال العام، هي هشة، كما يخلص إلى معطى أن الرابط السياسي والمدني، الذي من الممكن أن يوحد، من جهة، المواطنين بينهم، ومن جهة أخرى، الدولة والمواطنين، يبقى ضعيفا. كما يقدم نفس التقرير، معطى أن الاحتجاج المنظم أو العفوي ذو طبيعة منتظمة هو شكل للتعبئة السياسية الذي يقدم درجة الالتزام في المجال العام، وحظوظ نسج روابط جديدة اقل اتفاقية.
وهذا ما تظهره احتجاجات الحسيمة، فبعد واقعة محسن فكري، تغيرت الذهنيات لدى الساكنة، ومن لم يسبق له أن شارك في حركة احتجاجية أصبح ينخرط في هذه الاحتجاجات، وهذا في رأينا راجع إلى وجود مجال عام “مصغر” يساعد على نسج روابط اجتماعية جديدة، ويقوي الروابط القديمة.
التاريخ السياسي للمنطقة
يُفهم تاريخ “الحُكرة” والتهميش بمنطقة الريف في سياق خصوصية علاقته مع السلطة، والذي يبينه التاريخ السياسي للمنطقة، الذي نستنتج من خلاله وجود سبب رئيسي للإحساس بالتهميش لدى هذه المناطق، وهو ضعف المصالحة مع السلطة المركزية، بحكم أن هذه المناطق تعتبر نفسها لم تستفد من التنمية بالحجم الذي كانت تنتظره من العهد الجديد.
هذا ما يبينه مضمون الاحتجاجات التي لم تعد تطالب فقط بالكشف عن نتائج التحقيق في قضية مقتل محسن فكري، وإنما إنصاف ساكنة الحسيمة عبر رفع التهميش، عبر ما يسمونه احتجاجات ضد سياسة التهميش التي تنهجها الدولة في مختلف الميادين بالريف. وهو تهميش مترسخ في مخيال هذه المناطق ومستمد من التاريخ السياسي لمنطقة الريف والذي لم يتكلل بمصالحة “تامة” رغم المجهودات الكبيرة التي بدلتها الدولة على مستوى التنمية وعلى المستوى الدبلوماسي، بقدر ما أدت إلى مزيد من الصراع من أجل تحقيق مطالب اجتماعية محضة، لكن عبر الاستلهام من رموز التاريخ السياسي للمنطقة.
يعود تاريخ تهميش منطقة الريف من طرف الدولة إلى حرب الريف والفترة القصيرة لتشكل جمهورية الريف(1921- 1926)، حيث تم تهميش الجهة من طرف المخزن، والذي تجلى في غياب البنيات التحتية، المدارس والتطور الاقتصادي. ولم يهدأ الصراع السياسي للريف مع الدولة منذ الخمسينات إلى حين الانفتاح السياسي في التسعينات ليتبعه صراع آخر تمثل في الاحتجاج على عقود من التهميش .
خلال المرحلة الأولى، قامت ثورة كبرى من سنة 1957 إلى سنة 1959 بعد تنصيب محمد الخامس على العرش، وسيما إغلاق الحدود مع الجزائر حيث اعتاد الآلاف من الريفيين العمل. وقد ابتدأت هذه الثورة عندما تم اكتشاف جسد عباس المساعدي، قائد جيش التحرير الوطني الريفي في فاس ليتم دفنه مرة أخرى بأجدير العاصمة القديمة ل”مملكة” الريف، فشك رجال جيش التحرير في أعضاء الحكومة الاستقلاليين في قتل قائدهم ورغبوا في نقل رفاته إلى مسقط رأسه، لكن موظفي حزب الاستقلال، رفضوا إعطاء الترخيص، فقام كل من الدكتور الخطيب وأحرضان بنقله ونظموا جنازة كبيرة سرعان ما تحولت إلى مظاهرة .
تضخمت الانتفاضة عندما قام كل من أمزيان أحد قادة الحزب الديمقراطي للاستقلال وعضو قبيلة بني ورياغل، وعضوين آخرين من عائلة الخطابي بتقديم برنامج من 18 نقطة إلى الملك محمد الخامس يتضمن مطالبهم التي منها: عودة عبد الكريم الخطابي إلى المغرب، وخلق مناصب الشغل، ثم التقليص من الضرائب. لكن، السنة التي بعدها لاحظوا بأن هذه المطالبات لم تؤخذ بعين الاعتبار، وسنة 1959، تم قمع الانتفاضة من طرف القوات المسلحة الملكية مخلفة العديد من القتلى بالرصاص، معلنين تهميشا كبيرا للريف من طرف الحكومة للعقود التالية .
وسنة 1984، شهدت منطقة الريف انتفاضة أخرى تبعا لاحتجاجات على ارتفاع أثمنة المواد الغذائية. وتفاقمت التوترات عندما دعا الحسن الثاني أهل المنطقة بالأوباش خلال خطاب تلفزي، معلنا عن حملة قمع عنيفة، ومحددا المناطق الأكثر تهديدا في الناظور، الحسيمة، تطوان والقصر الكبير .
لكن، بين سنة 1987 و1991، أعلن الملك عدة مرات عن جولة رسمية للريف، غير أنها لم تحدث، فنشأ إحساس عند الريفيين بأنهم متخلى عنهم. وابتداءا من سنوات التسعينيات، سمح انفتاح النظام السياسي بالتحدث عن تاريخ الريف، حيث تعبأ الفنانون والفاعلون النقابيون والجمعويون والطلبة من أجل الدفاع عن هويتهم التاريخية. ومن أجل التكيف مع هذا الجيل الجديد من المجتمع المدني، دشن محمد السادس لأسلوب أكثر شعبية، سيما عبر تخفيف الأمن الملكي تجاه شخصه، كما كان أول سفر رسمي له للريف، وذهب كذلك إلى أجدير من أجل التحدث مع عائلة عبد الكريم الخطابي، العمل الرمزي للمصالحة مع ذاكرة الريف. وفي الجهة الجبلية، دشن عدة مشاريع تنموية .
ورغم ذلك، فهذا المجهود الدبلوماسي لم يصالح سوى لفترة قصيرة الريف مع الملكية، لأن التغيرات التي كانت منتظرة لم تكن عميقة بالحجم الذي نُظر به إلى وصول ملك الفقراء. وهذا ما تبينه المرحلة الثانية من “ضعف” المصالحة، فللسبب السابق المتمثل في واقع التنمية بالمقارنة مع حجم الانتظارات، شاركت مشارب مختلفة من المجتمع الريفي في حركة 20 فبراير: الشباب العاطل من حملة الشهادات، النقابيين، الفنانين، الطلبة، المعلمون والعمال. وقد شكلت حركة آيت بوعياش الحدث البارز للربيع الريفي، حيث قام العديد من المحتجين باعتصام استمر ما يقارب ستة أشهر في مركز المكتب الوطني للماء الصالح للشرب للاحتجاج على الظروف السيئة للحصول على المياه .
ضعف المصالحة هو ما يبينه كذلك إعلان الريف الذي تم نشره في فبراير 2005 من طرف بعض الفاعلين الذين يجمعون على أن الريف ما زال لم يتصالح مع الحكومة المركزية. إذ طالب الإعلان بالاعتراف بالممارسات القمعية ضد الساكنة الريفية في سنوات 1958، 1984 وسنة 1987، وكذلك، إصلاح هذه الأضرار. ورغم أن هيأة الإنصاف والمصالحة استجابت لهذا الطلب عبر التوصية بخلق متحف للريف، وهي المبادرة المدعومة من طرف محمد السادس وإدريس اليزمي سنة 2011، فإن الندوة التي كانت تهدف إلى مناقشة الأهداف والأرشيفات لعرضها لم تشرك الفاعلين المحليين أو الجمعيات المستقلة. وسنة 2013، انتهت كذلك برصيد سلبي في المنطقة، فمن جهة، خفتت شبكة 20 فبراير بسبب المنع في الحسيمة والقمع في شفشاون. ومنذ سنة 2011، في سياق الربيع المغربي، لقي العديد من الريفيين حتفهم .
في هذا السياق، تخلص الباحثة المغربية يسرى أبو رابي إلى أن استعمال المرجعيات الرمزية لجمهورية الريف ولزعيمها عبد الكريم الخطابي، رغم أنها لم تبدأ سنة 2011، وجدت داخل حركة 20 فبراير ميدانا جيدا للتعبير. هذه المرجعيات الرمزية تحمل معنى جد قوي بالنسبة للريفيين، حيث يتميز التاريخ بالصراعات المتكررة مع الحكومة المركزية والتي يمكنها أن تطفو على السطح في أي وقت . فهل ينطبق نفس الشيء على احتجاجات الحسيمة ضد “الحُكرة” والتهميش؟
بالفعل، لكن مع فارق بسيط، وهو أن توظيف المرجعيات السابقة في الاحتجاجات الأخيرة للمنطقة هي احتجاجات بمطالب اجتماعية واقتصادية محضة تهدف إلى رفع التهميش عن المنطقة. فرفع علم جمهورية الريف هدفه من وجهة نظر المحتجين هو المطالبة برفع الحصار الاقتصادي على الريف، إذ يتم باعتباره كرمز للمقاومة، وكجزء من تاريخ منطقة الريف الحافل بالنضال. ويبرز ضعف المصالحة في مخيال الريفيين، وربطهم لهذه الأخيرة بتنمية المنطقة. وهذا ما يبينه تصريح لأحد قادة الاحتجاج بالريف، والذي اعتبر على أن المصالحة الوطنية ينبغي أن تكون مع الريف عن طريق رفع الحصار وتنمية المنطقة اقتصاديا واجتماعيا، لأن الريف منكوب ومتضرر .
وهذا ما يبينه مفهوم “الحُكرة” في السياق المغربي. إذ لا تعني “الحُكرة” أو الإحساس بالظلم الاجتماعي في تمثلات المحتجين شيئا رمزيا، بقدر ما يعبر عن رغبتهم في تحقيق مطالب مادية ملموسة. هذا مع فارق جد ضئيل في الاحتجاجات الأخيرة لمدينة الحسيمة، والتي إلى جانب أنها تهدف، في جزء كبير، إلى رفع التهميش عن المنطقة، فإنها كذلك، تحمل شيئا من الرمزية في المطالبة بالكرامة والتنديد ب”الحُكرة”، وهو رفض “السياسة المخزنية” والمتمثلة في قمع حركة احتجاجية مطالبها اجتماعية اقتصادية.
بيبليوغرافيا
Abourabi, Yousra,
La réapparition du drapeau de la république du rif lors du printemps arabe au Maroc. Sous la direction de : B. Dupret, Z. Rhani, A. Boutaleb, J.- Noel. Ferrié, Dans l’ouvrage « Le Maroc au présent, d’une époque à l’autre, une société en mutation ». Pp (617- 626). Edition Fondation Abdul – Aziz Al Saoud et Centre Jacques Berque, Collection Dialogue des deux rives. 2015.
Anne, Revillard,
La sociologie des mouvements sociaux : structures de mobilisations, opportunités politiques et processus de cadrage, juin 2003. in:http://www.melissa.enscachan.fr/IMG/pdf/2003_sociologie_des_mouvements_sociaux.pdf
Benford, Robert
Master frame. In the Wiley- Blackwell Encyclopedia of social and political movements, Edited by David A Snow, Donatella dalla Porta, Bert Klandermans, and Doug Mc Adam, 2013. Blackwell Publishing.Published Online: 14 JAN 2013. In Wiley online library. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9780470674871.wbespm126/full
Bennani- Chraïbi M., Jeghlally M.,
La dynamique protestataire du mouvement du 20 février à Casablanca », Revue Française de science politique, Vol. 62, n° 5, 2012, P. 867- 894.
Heydemann, Steven,
Toward a new social contract in the Middle East and North Africa, in Arab Reform Bulletin : January 14, 2004, volume 2, Issue 1.
Hmed, Choukri,
Espace géographique et mouvements sociaux, in dictionnaire des mouvements sociaux, sous la direction d’Olivier Fillieule, Lilian Mathieu, Cécile Péchu, sciences po les presses, 2009, pp 220, 227.
Madani, Mohamed,
« 20 Février », séparer le pouvoir de la richesse. In la revue Economia n° 13/ Novembre 2011- Février 2012. Economicus, La chronique de l’Economiste.
Mathieu, Lilian,
Les mobilisations improbables: pour une approche contextuelle et compréhensive, in passer à l’action: les mobilisation émergentes, l’harmattan 2007.
Snow, David A. And D. Benford, Robert,
Master frames and cycles of protest, in Frontiers in social movement theory. Edited by Aldon D ; Morris and Carol McClurg Mueller. Yale University Press, New Haven and London. Aug, 26, 1992. PP 133- 155.
الأندلوسي، نبيل،
بعد أن أطفأت شمعتها الأولى، رصد لإشراقات وإخفاقات “حركة 20 فبراير”، الخميس 16 فبراير 2012. في مجلة وجهة نظر، العدد 461.
المنوني، عبد اللطيف،
تحولات الحركة النقابية المغربية المنوني، عبد اللطيف، عياد محمد، الحركة العمالية المغربية، صراعات وتحولات، الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، 1985. سلسلة المعرفة الاجتماعية.
بنيس، سعيد،
المجتمع المدني والفعل الاحتجاجي في المغرب الأنساق المفاهيمية الجديدة. في مجلة أبحاث(الفعل الاحتجاجي بالمغرب مقاربة الأنساق والسلوكات والقيم)، العدد 61- 62، مطبعة النجاح الجديدة، 2015. صفحات 6- 11.
بوعزيز، مصطفى،
مداخلة في إطار ورشة عمل منهجية حول “تحولات الحركات الاجتماعية بالمغرب” يوم 26 مارس 2015 بمركز جاك بيرك للدراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية بالمغرب.
حوليات العمل النقابي بالمغرب سنة 2011،
تنسيق وإشراف: رشيد بوصيري، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط- 2013.
رشيق، عبد الرحمان،
الحركات الاحتجاجية في المغرب، من التمرد إلى التظاهر. ترجمة الحسين سحبان، يناير 2014. ملتقى بدائل المغرب، مشروع: “حريات التجمعات والتظاهرات بالمغرب” بدعم من الاتحاد الأوروبي.
نعيمي، محمد،
الربيع العربي في المغرب، الإرهاصات والتفاعلات، حركة 20 فبراير نموذجا، في مجلة أبحاث، عدد بعنوان(الفعل الاحتجاجي بالمغرب، مقاربة الأنساق والسلوكات والقيم، العدد 61- 62، 2015. صفحات 23- 37.
جريدة التجديد،
الوزير الأول يوقع على “تخصيص مناصب شغل للأطر العليا المعطلة”، العدد 2558، الأربعاء 19 يناير 2011، ص1.
جريدة التجديد،
التزام رسمي بتشغيل 1880 معطل من حاملي الشهادات العليا، العدد 2562، الثلاثاء 25 يناير 2011، الصفحة الأولى.
جريدة التجديد،
الحكومة “تسابق” الزمن لتوظيف المعطلين في فاتح مارس، العدد 2576، الاثنين 14 فبراير 2011، ص 1 و3.
جريدة التجديد،
عدد 2577، الثلاثاء 15 فبراير 2011، ص 9.
جريدة العلم،
15 فبراير 2011.
الموقع الإخباري لكم،
10 ديسمبر 2016: http://www.lakome2.com/mobile/politique/21249.html