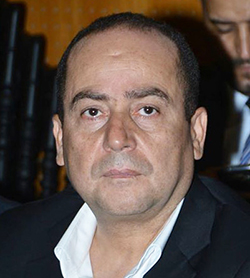السلوك الاحتجاجي بالريف .. محددات التشخيص ومحاولات التمحيص

تشهد مدينة الحسيمة، منذ أزيد من خمسة شهور، احتجاجات تكاد تكون أسبوعية، بشعارات متفاوتة وغير واضحة وتفتقد إلى الدقة من حيث المضمون والسقف، وبمشاركة فئات مختلفة تضم كافة المشارب الاجتماعية والفئات العمرية؛ لكنها تتسم بالتنظيم المحكم وبالنزعة السلمية، الأمر الذي شجع على تجاوب وانخراط ساكنة بعض المناطق المجاورة، ما أدى إلى اتساع دائرة الاحتجاج، بالرغم من الإجراءات والمبادرات التي اتخذتها السلطات العمومية لاحتواء هذه الأوضاع التي باتت تثير القلق وتطرح أكثر من علامة استفهام.
آراء أخرى
وفي إطار محاولة تحليل وفهم السلوك الاحتجاجي بمنطقة الريف وبالتحديد بمدينة الحسيمة، لا بد من استحضار كافة الاتجاهات والقراءات التفسيرية، سواء التي حاولت تبرير هذا السلوك والدفاع عنه أو التي شككت في نوايا متزعمي المظاهرات وبالتالي محاولة شيطنتهم من خلال اتهامهم بخدمة أجندات أجنبية لزعزعة استقرار المغرب.
وبين هذا وذاك، امتزج التحليل الموضوعي بالذاتي والعلمي بالانطباعي، وساد نوع من الارتجال والتسرع على مستوى التعاطي ليس مع ظاهرة الاحتجاج في حد ذاتها؛ ولكن مع “طول مدة ظاهرة الاحتجاج وتمددها بالمنطقة”.
على العموم، يمكن تقسيم واختزال الاتجاهات المبررة أو الرافضة لهذا السلوك الاحتجاجي إلى اتجاهين أساسيين؛ الأول، يمثله أنصار التيار الاحتجاجي من أبناء المنطقة وخارجها، بحيث يرون أن تلك المظاهرات هي تعبير عن فشل السياسات والمقاربات التنموية التي نهجتها الدولة منذ سنوات بالمنطقة. ومن ثمّ، فالساكنة تعبر عن مطالبها تعبيرا سلميا ومشروعا.
أما الاتجاه الثاني، فيرى أن الاحتجاج وفق الطريقة والسقف الحاليين يحاول أنصاره الركوب على المشاكل الاجتماعية لتحقيق أهداف سياسية غير مشروعة تمس الوحدة الوطنية والترابية.
وفي خضم تباعد الاتجاهين، يلاحظ أنه على الأرض أصبحت مدينة الحسيمة مفتوحة على كافة الاحتمالات، خاصة في ظل الاحتقان الموجود.
السلوك الاحتجاجي بالحسيمة.. السياق ومحددات التشخيص
اندلعت الاحتجاجات الشعبية في مدينة الحسيمة منذ خمسة شهور، عندما توفي بائع سمك جراء حادث بواسطة شاحنة قمامة؛ فقد أشعلت الحادثة غضبًا شعبيًّا وطنيًا واسعًا آنذاك، تضامنًا مع “بائع السمك”، ثم سرعان ما تحولت المظاهرات من التنديد بوفاة محسن فكري بتلك الطريقة إلى رفع شعارات تتضمن عبارات تمحورت في مجملها حول التنديد بسياسية التهميش و”الحكرة”، التي بحسب المحتجين طالت منطقة الريف لسنوات.
بعد ذلك، انتقلت تلك المطالب من التوصيفات العامة التي تفتقر إلى الدقة والوضوح إلى أشكال أخرى أكثر واقعية ووضوحا من سابقاتها، بحيث بدت وكأنها مطالب اجتماعية وحقوقية صرفة، ممثلة في توفير فرص عمل للشباب العاطل وبناء مستشفيات بالمدينة ومطالب أخرى.
وظل الحراك السلمي في المدينة متواصلًا كل نهاية أسبوع، بل امتد إلى الضواحي خاصة القرى والمداشر المجاورة دون أن تنطفئ شرارته؛ الأمر الذي شكل مصدر قلق للسلطات العمومية، لا سيما أن متزعمي المظاهرات رفضوا التفاعل بإيجابية مع جميع الخطوات والمبادرات التي قامت بها الدولة لامتصاص ولتلطيف أجواء الاحتقان.
استمرار الأشكال الاحتجاجية، بالرغم من المجهودات الرامية إلى حصر تمددها والتحكم في سقفها وتناقضاتها وانعكاساتها على واقع ومستقبل المنطقة، يطرح عدة تساؤلات حول خلفيات فشل السياسات التنموية السابقة ومدى نجاعة المقاربات المعتمدة في تدبير المجال الترابي ككل
ويمكن فهم هذا الرفض بالنظر إلى عدة عوامل، يبقى أبرزها حالة الاحتقان التي تسببت فيها وفاة محسن فكري، ينضاف إليها غياب عنصر الثقة بين المركز وبين هذه المنطقة بفعل الموروث التاريخي والثقافي، بالرغم من المجهودات المبذولة في هذا الاتجاه، بالإضافة إلى الأوضاع الاجتماعية الهشة التي شكلت البنية التحتية وأسهمت في تأجيج الوضع.
وعلى مستوى السلوك الاحتجاجي للساكنة، وفي ظل غياب معطيات دقيقة حول الاتهامات والأصوات المشككة في نوايا متزعمي الاحتجاج، جرى تسجيل مجموعة من الملاحظات الأولية من خلال تفكيك بعض الشعارات وأخذ عينات من تصريحات مؤطري المظاهرات وتحليل بعض المشاهد من الوقفات التي يتم نقلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر تقنية المباشر.
ويمكن اختزالها في أربع ملاحظات رئيسية:
الأولى، غياب سقف محدد خلال التظاهر، بحيث يمتزج ما هو اجتماعي وثقافي بما هو سياسي وتاريخي، خاصة عندما يتحول الشكل الاحتجاجي من سقف اجتماعي يتضمن مطالب ملحة كالشغل والبنيات الأساسية (المستشفيات، الطرق..) إلى سقف سياسي غير منضبط وفضفاض ويكتسي أبعادا رمزية، بحيث تصبح المظاهرات في بعض الأحيان عبارة عن محاكمة علنية لسياسات الدولة في المنطقة، محاكمات ممتدة عبر الزمن لا تستحضر الحاضر بقدر ما تغلب الماضي ورواسبه وتسقطه على الواقع الحالي بأثر رجعي.
ثانيا، عدم رفع العلم المغربي خلال المظاهرات والاكتفاء باللافتات التي تبرز النزعة الأمازيغية، بالرغم من أنها تعبر عن المكون الثقافي لهذه المنطقة، فإن ذلك يطرح أكثر من علامات استفهام ويسمح ببروز مجموعة من القراءات المتوجسة إزاء أهداف وخلفيات متزعمي هذا الحراك، ويطرح كذلك إشكالية التوفيق بين الهوية الثقافية والوطنية في الفضاء العمومي.
ثالثا، احتكار مجموعة من الشباب بالمنطقة مسألة الدعوة إلى المظاهرات وتنظيمها وتأطيرها وعدم انفتاحهم على باقي المكونات الأخرى مثل الطلبة وممثلي بعض الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني، حيث لوحظ أن متزعمي الاحتجاج اعتمدوا منهجا يقوم بحسب منتقديهم على الانغلاق وتخوين الآخرين من أبناء المنطقة الذين يخالفونهم الرأي.
رابعا، التباس مواقف متزعمي التظاهر تجاه بعض الأصوات الانفصالية المحدودة التي ظهرت عبر بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لأشخاص ومنظمات مغمورة مقيمة بكل من بلجيكا وهولندا، حيث إن عدم تحديد موقفهم بشكل صريح تجاه أصحاب هذا الطرح والركون إلى الصمت في أقصى الحالات جعل بعض الأوساط الرسمية تتوجس وتشكك في نوايا وخلفيات الأفراد الداعين إلى التظاهر.
الدولة وتدبير ملف الاحتجاج بمنطقة الريف
في البداية، يمكن القول إن السلوك الاحتجاجي بالمغرب عرف تحولا نوعيا أواخر سنة 2010 مع الحراك الشعبي الذي شهدته الرقعة العربية. وقد بدا هذا التحول جليا خلال عدة محطات، خاصة خلال واقعة كالفان وأحداث الحسيمة الأخيرة، حيث أصبحت السمة البارزة هي خروج الجماهير للاحتجاج وللتعبير عن الغضب دون تحديد الجهات الداعية إلى الاحتجاج ودون الاتفاق مسبقا على سقف المطالب أو الشعارات، حيث أن السمة البارزة أن دعوات الاحتجاج تأتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي من لدن مجموعة من الشباب الذي في الغالب غير منتم إلى الأحزاب السياسية، وتسمح السلطات العمومية في الغالب لهذه المظاهرات التي تمر سلمية، حيث تفضل عدم الاحتكاك بهم. وهذا الأمر ينم عن تطور على مستوى التدبير الأمني لمثل هاته الحركات الاحتجاجية التي تصل عبر التراب الوطني إلى أزيد من 120 شكلا احتجاجيا تستحوذ العاصمة الإدارية للمملكة على أزيد من ثلثيها، بحيث تدبر ولاية الرباط لوحدها يوميا أزيد من 80 وقفة احتجاجية.
ويمكن قراءة الفعل الاحتجاجي، الذي ظهر خلال الست سنوات الأخيرة، في إطار السياقات الداخلية والإقليمية والدولية التي عصفت بمجموعة من النظم الحاكمة وأثرت على خريطة التوازنات داخل الدول، حيث أضحى الشباب العربي مع مواقع التواصل الاجتماعي وسرعة نقل المعلومة وانتشارها أكثر تأثيرا في الواقع السياسي من الأحزاب والنقابات، حيث وظف الشباب وسائل الاتصال الحديثة للتعبئة من أجل الخروج في المظاهرات، وفضح ونشر كل التجاوزات والممارسات والحقائق عبر شبكة التواصل الاجتماعي خاصة الفيسبوكوتويتر؛ الأمر الذي أدى إلى استنفار المواطنين وانخراط كافة الفئات التي جزء كبير منها ينتمي إلى الطبقة المتوسطة إلى جانب الفئات الشعبية الكادحة.
وبالعودة إلى الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة لمدة تقارب خمسة شهور، وباستقراء المعطيات الإحصائية والميدانية المرتبطة بتدخل الدولة على مختلف الاصعدة لامتصاص الغضب الشعبي سواء من خلال المبادرات والزيارات واللقاءات التي قام بها بعض المسؤولين، حيث سجل ما يقارب سبع زيارات لوزير الداخلية إلى المنطقة وترؤسه اجتماعات مكثفة مع المسؤولين المحليين والمنتخبين وكافة ممثلي الأحزاب والمجتمع المدني، أو من خلال إعفاء عامل الإقليم والعشرات من رجال السلطة ومندوبي الوزرات واستقدام أبناء المنطقة مكانهم وتقديم مجموعة من البرامج التنموية الاستعجالية، فإن ذلك لم يساعد على تخفيف الاحتقان الموجود بالمنطقة؛ بل مع مرور الوقت امتدت الأشكال الاحتجاجية إلى ضواحي المدينة وانخراط فئات جديدة لم تكن حاضرة في البداية مثل النساء والشيوخ.
بطبيعة الحال، هذا المعطى يبقى مجرد ملاحظة أولية يمكن مشاهدتها من خلال النقل المباشر للمظاهرات ولا يمكن اعتمادها مؤشرا علميا بحكم أن ذلك يستلزم الخضوع لشروط صارمة قبل إقراره.
لذلك، فاستمرار الأشكال الاحتجاجية، بالرغم من المجهودات الرامية إلى حصر تمددها والتحكم في سقفها وتناقضاتها وانعكاساتها على واقع ومستقبل المنطقة، يطرح عدة تساؤلات حول خلفيات فشل السياسات التنموية السابقة ومدى نجاعة المقاربات المعتمدة في تدبير المجال الترابي ككل. وهنا، يمكن استحضار ثلاثة مستويات يمكن من خلالها تشخيص مكامن الخلل التي أسهمت في تفاقم الوضع وحالت دون إيجاد حلول وبدائل عملية.
الأول، ضعف تأثير الوسائط والقنوات الأخرى مثل الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني بالمنطقة، فبالرغم من أن رئيس الجهة يعتبر من أبناء المنطقة ويمتلك رصيدا نضاليا غنيا اكتسبه نتيجة الاشتغال سابقا ضمن الجمعيات المدنية المحلية على ملفات مهمة وحساسة كملف ضحايا الغازات السامة المرتبط بحقبة الاستعمار الإسباني للمنطقة، وكذلك من خلال انخراطه في الصف النضالي التي كان يمثلها اليسار المغربي خلال ما يصطلح عليه بسنوات الرصاص؛ لكن سرعان ما تلاشى هذا الرصيد الغني وفقد بريقه بسبب انخراطه وزعامتها لحزب الأصالة والمعاصرة، هذا الاخير الذي يجر وراءه “خطيئة النشأة” بالإضافة لطرق الاشتغال والاستقطاب المعتمدة منذ التأسيس من خلال الارتهان كليا إلى محترفي الانتخابات والأعيان وكذلك افتقار هذا التنظيم إلى قواعد وامتدادات شعبية حقيقية يمكنها أن تلعب دورا مهما في مثل هذه المحطات.
ثانيا، لجوء الدولة إلى المقاربات المعتمدة نفسها سواء من خلال القيام بإجراءات استعجالية أو القيام بتغيرات ترقيعية والاكتفاء بالمسلك التفاوضي بالرغم من محدوديته، يعكس حالة التخبط والعشوائية في تدبير السلوك الاحتجاجي بالرغم من تراكم التجارب السابقة.. هذا إذا ما استثنينا المقاربة الأمنية التي تنم على نوع من التطور والاحترافية، سواء من خلال تفادي الاصطدام مع المحتجين والتأسيس لأعراف جديدة في التعامل مع متزعمي الاحتجاجات، حيث إنهم يتظاهرون بكل حرية، بعكس ما كان يتم سابقا (المضايقات، السجون،..)…
ثالثا، عدم تمدد الاحتجاجات في منطقة الريف بكاملها وفق المفهومين الجغرافي والثقافي ليشمل مدينة الناظور يؤشر على أن هناك وعيا متناميا لدى الساكنة ينتصر لمقومات العيش المشترك تحت سقف الوطن بدل الميل إلى النزعة العرقية الضيقة التي يحاول البعض توظيفها لتأجيج الوضع.
وأخيرا، إن تنامي الفعل الاحتجاجي بصفة عامة بالمغرب وفق الطريقة والاشكال الجديدة يمكن اعتباره بمثابة جرس إندار موجه إلى كل الفاعلين، الدولة والمنتخبين؛ فهي تؤشر على محدودية وعدم قدرة المقاربات والسياسات الحالية على تقديم إجابات ملموسة لانتظارات واحتياجات المواطنين، الأمر الذي يستدعي القيام بقراءة موضوعية لهذه الظاهرة المتنامية بغية استشراف كافة التحديات والرهانات.