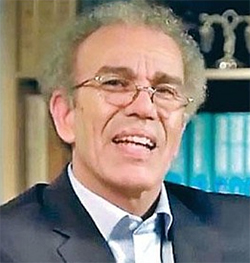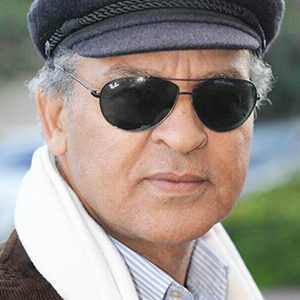الحماية والولاء.. الجامعة والمجتمع في المغرب

أحاول في هذه المساهمة فحص الحقل الجامعي وفق بعض المفاهيم والأدوات المرتبطة بالجامعة والمجتمع، فحص كيفية اشتغال الفاعل الجامعيبأداتين أساسيتين هما الحماية، كتقليد مجتمعي متجذر في تاريخ المجتمع المغربي، ومفاهيم القيم الحداثية، استقلالية الجامعة خاصة.تمرين ابستمولوجي ومنهجي صعب أن تحاول فهم سيرورات أنت جزء منها.
آراء أخرى
تتلخص قناعتي المنهجية في رصد وملاحظة كيفية اشتغال الأفعال الاجتماعية وأثرها على التفاعل من جهة، ثم ملاحظة التفاعل نفسه بتتبع آليات اشتغاله. ثم سرد ماذا نفعل كباحثين بكل هذا،وكذلك بحث الاجتماعيكسيرورة منفعلة وفاعلة بالسياقات المختلفة والمتغيرة، والتي يؤثر فيها فهم الباحث نفسه.من هذا المنطلق لا تهمني الجامعة كمؤسسة تنظمها قوانين وتابعة لسلم هيمنة إدارية فحسب، وإنما كفعل اجتماعي تؤثر فيه أفعال واعية وأخرى غير واعية.
في معنى الحماية والولاء:
في مجتمع يتلكأ في الانتقال إلى قيم الحداثة والمسؤولية الفردية والحرية والعقلانية، حيث تتناضد قيم تقليدية رثة مع أخرى تطمح لأن تكون حداثية، وفي تنظيم غير معياري كفاية، وفي غياب وسائل التفكير المسبق العقلاني والملائم، وغياب مراقبة السيرورات والتقويم العادل، في كل هذا نكون ضمن جماعات أو أفراد يتزاحمون من أجل الخلاص كما كانت تتزاحم القبائل حول عيون الماء والمراعي، ويكون الغالب بعدد الفرسان. الأمر أشد افتراسا في الجامعة لأن الأعراف غائبة والموجود منها جد مهلهل. وكما في القبيلة يحمي القوي الضعيف الذي يبدي ولاءه بالانكسار. كذلك العلاقات هنا، والمرتبطة بالصراع حول المنافع المادية والمالية والرمزية بشكل أخص. حيث تتكون شبكات من الولاء والحماية لا ندري متى تبدأ ولا متى تنتهي إلا عند الأحداث الكبرى.
الحماية مؤسسة تقليدية مبنية على المسؤولية الجماعية وواقعية الغلبة، فلا حدود بين القبائل سوى ما يمكن أن تطاله القوة وعدد الفرسان وجودتهم في القتال، مع بعض الحاجة إلى التحكيم حتى لا تستمر المعارك إلى ما لانهاية، وهي بذلك ليست فعلا طبيعيا فجا بل سياسة لها مقوماتها القيمية والمعيارية تنظمها الأعراف والطقوس والتسليم بعدالة جزاء سماوي ينفذ القصاص ما لم ينفذ في الأرض. الحماية بنية اجتماعية ومنطق ذهني يرتبان الفوضى ويجعلانها مستساغة، لكن وفق واقعية وبراجماتية الغلبة. في القبيلة يرسم لك ما ينبغي أن تفعله منذ الميلاد حتى الممات، مع تلوينات طفيفة، أحيانا كبيرة وعنيفة تتبع الفعل المنفلت.
تعني الجامعة تلك المؤسسة التي يتلقى فيها الطلبة معارف عالية ومقعدة من طرف أساتذة مؤهلين ينتجون ويؤطرون بالمرافقة من أجل استمرار وتقدم تلك المعارف، غير أن الجامعة ومنذ أمد غير قريب أصبحت مجالا أيضا للصراع الفكري والسياسي وفضاء عموميا لاقتراح الأفكار العامة التي يتراهن حولها لتدبير المجتمع ثقافيا واجتماعيا، وسياسيا خاصة.
مقاربة الجامعة يمكن أن تكون من مداخل عدة، وقد جرت العادة الانتباه للمردودية والتي غالبا ما تصنف إلى داخلية، تهتم بجودة التدريس والتأطير والبحث في نسب النجاح والهدر، كميا بإحصاء نسبة الأساتذة بالنسبة للطلبة، وعدد الأبحاث العلمية والمشاريع المنجزة، وكيفيا بجودة التأطيروالحياة الجامعية للطلبة والأساتذة والإداريين وباقي الفاعلين، دون نسيان المردودية الخارجية المرتبطة بالشغل والشراكات والاشعاع.
ورغم ذلك فأهم ما يجب الانتباه إليه المعارف نفسها، جودتها وطرق تقديمها وتقويمها، ثم علاقة الجامعة بقيم المجتمع وثقافته الهويايتية. ثم السؤال المركزي الذي أقترحه هنا: ما هي نقط تماس الجامعة بالمجتمع؟
دون الدخول في دلالات القيم ووظائفها، وعلاقاتها المتشعبة والكثيرة مع مناحي الحياة الاجتماعية الأخرى الثقافية؛ والأخلاقية؛ والدينية؛ والاجتماعية؛ والوجدانية؛ والسياسية، والمعايير التي يضعها المجتمع لتثمينها وحمايتها والمحافظة عليها، أو نبذ ما لا يستحسنه منها، فالقيم التي تهم الجامعة وإن فيها العام الخفي والمعلن، هي القيم السياسية التي تضبط إيقاع تدبير الحياة الاجتماعية معياريا، وبالأخص عبر القانون والأعراف والمساطر، لأنه، ولاحقا في هذا المقال، سنرى أثر ذلك الحاسم على الجامعة في المغرب.سؤال القيم هنا يمكن تكثيفه في مدى استقلالية الجامعة وتوجهها نحو العقلانية والديمقراطية والحرية والعدالة. وهي مرتبطة بحرية الرأي والتعبير والانتظام، وكيف يفعل الفاعل الجامعي بقصدية نحو الأشياء والأشخاص والأفكار. وكيف يمارس التفاعل الجماعي عبر التواصل واتخاذ القرار، وما أثر كل ذلك على النجاح أو الإخفاق أو المراوحة في المكان. وتبقى القيمة الرئيسية بالنسبة للجامعة هي الاستقلالية وعدم التبعية لا للدولة ولا للمشاريع السياسية والحزبية الضيقة، ولا حتى للإدارة والقوانين الضيقة الدوغمائية. هذا المطلب حتى وإن بدا طوباويا حد أدنى منه ضروري للسير الذي يمكن من قيادة المجتمع نحو الأفضل.
فحص أعراف الجامعة من الأهمية بمكان حيث يستشف منها اليومي الممارس فعلا وليس ما يسطر من قوانين ومساطر ومذكرات. ومن هنا يأتي فحص الممارسة اليومية للحياة الجامعية ووصفها أمرا لا يمكن فهم الجامعة بدونه، وهو الوجه الآخر عبر القناعات القيمية والأخلاقية والسياسية، وحتى سلوك الأفراد وتلونهم في التعبئة والتجييش الذي يصل حد العنف الرمزي والجسدي أحيانا.
أخيرا وليس آخرا يعتبر الآن مستوى البحث العلمي في أي بلد رهانا حقيقيا، إذ أصبحت الحياة نفسها علمية وذكية حيث لم تعد كفايات التربية الأسرية والتنشئة تستطيع التأهيل للحياة في القرن الحالي، لاعتمادها، أي الحياة، على مدى مستوى الوعي العلمي سواء على مستوى تدبير الدولة والمؤسسات أم على مستوى الحياة اليومية.
المساهمة نوع من الانعكاسية التي تريد خلق المسافة المتأنية من أجل الفهم والتحليل بالصف الهادئ الذي لا يستعجل التفسير.
بعض النمذجة لسلوك الفاعل الجامعي:
يختلف سلوك الفاعلين الجامعيين الآن وفق نماذج مستوحاة من مفهوم الأنوميا لدى روبرت كينج ميرتون نقررها كالتالي:
1 الممتثل:
سلوك الممتثل جد واقعي، يعرف هدفه الصغير في أن يتبوأ مكانة ما، أو حتى شبهها، أو حتى إمكانية خدمة صاحب المكانة، ونظرا لصغر الهدف وتواضع الطموح يستنفر الممتثل وسائل جد بسيطة تقترب كثيرا من الانحراف، وسائل مثل اطراء صاحب المكانة والتقرب منه وحتى إخباره، وإظهار حفظ أسراره. الممتثل رجل في الظل لكن أصحاب المكانة والوهمية في غالب الأحيان يعتمدون عليه، وغالبا ما يبدي امتثاله للجميع، كما يمكن أن تجده في مواقع المعارضة مثل المكاتب النقابية أو حتى في التظاهرات الممانعة، هو من أخطر ما يخرب الجامعة من الداخل كدودة التفاح.سلوك الممتثل متنوع ومتعدد، أحيانا بمقابل وآخر بالمجان. يستهويه أن يوجد بجنب صاحب المكانة في المناسبات، يحمل له الملفات ويسانده في الخفاء، في التجييش والدسيسة وصناعة الموالين. هو حلقة وصل بين صاحب الكرسي والآخرين، خاصة في التكتل والانتخاب والمجالس، كما أنه صاحب العلاقات مع الخارج من المصالح الأخرى والشخصيات غير الجامعية، والحزبية خاصة. الممتثل يمكن أن ينتمي لأكثر من حزب وأكثر من نقابة، يركب سفينة صاحب المكانة ويتنصت على الجميع ولا أصدقاء له، بل ولا وفاء له. يجمع زلات الأخرين ويقدمها لصاحب المكانة من أجل الابتزاز. الممتثل حربائي ومكافيلي وينصر من انتصر، ويمكن بذلك السلوك المنحرف أن يؤذي أي واحد، بل ويمكن أن يؤذي نفسه ويسقط في أن يلفظ لحين أو حتى نهائيا ككبش فداء.
الفعل الجامعي الحالي الفاقد للعقلانية يحتاج إلى خدمات الممتثل ولا يستغني عنها.
2 المتمرد الذي يرفض كل شيء:
غالبا ما يكون مزاجيا، وبتربية تبدو حسنة ويبحث عن الحقيقة، لكنه يرفض الانتظام في أي تنظيم عقلاني، يمكن أن يصلح أو يغير جزءا من اللعبة، ويتخذ سلوكه بدعوى فساد كل شيء مادام المنطلق فاسدا. غالبا ما يفشل المتمرد حتى وإن كانت نواياه صادقة وأهدافه نبيلة، يفشل فقط لأنه جد مغيب للرهانات والتحالفات ولعب القوة، ومن ثمة ينزوي ويستقل في آخر المطاف. وليس المتمرد بريئا دوما بل يمكن أن يخفي حماية مصالح شخصية وغالبا نفسية ضيقة يمكن أن تصل إلى حدود زعامة دونكيشوطية على لا أحد رغم التوهم بالبطولة عبر التلويح بالهجوم والفضح و”التبوريد”.
3 الهادئ المشتغل في الظل:
الذي يحاول أن يشتغل لصالح الطلبة والمعرفة والمجتمع، له رأي يدافع عنه ويتخذ قرارات داخل تنظيم أو خارجه، يحاول الإصلاح دوما، خاصة في الشعب والمجموعات العلمية، يشارك في الندوات ويكتب مقالات رصينة علمية وإشعاعية، ويساهم في الحوار العمومي. وقد يدخل في معارك إذا فرضت عليه وينتظر النجاح أو الفشل كقوانين التفاعل. الهادئ. إنه هو من يضمن استمرار القيم النبيلة والرسالة الانسانية للعلم والمعرفة، وغالبا ما يحارب أو يهمش في أحسن الأحيان.
4 المناور باستمرار:
يشبه النموذج الأول، يضع رجلا هنا وأخرى هناك، لكن بأهداف أعلى وأكثر وضوحا ويختار الذهاب نحو منصب العميد أو الرئيس.المناور إن كان بطموح كبير غالبا ما ينتمي لحزب ويحضر الاجتماعات والمؤتمرات، ويحرص على أن يكون في القيادة بربط شبكة من المصالح والتفاعل الميكيافيللي، كما تجده ينتظم أيضا في الجمعيات الموالية لحزبه ويحاول أن يهتم به الإعلام حتى لا يبقى في الظل، وهو يملك طاقة تفاعلية كبرى بخيال خصب وذاكرة انتقائية مذهلة، ينسى غير المفيد ويتشبث بما ينفعه في المعارك. كما أنه لا يملك صداقة حقيقية ومستدامة، وينتقل من قناعات ايديويولوجية إلى أخرى بشكل بهلواني تجمع ما لا يجمع. فقط ما ينساه أو يتناساه المناور هو أنه غالبا جزء في لعبة لا يدري من أين تأتيها القرارات الكبرى والحاسمة.
ثم هناك صغار الفاعلين، من الذين يعيشون في الظل؛ وغير المكترثين؛ والمشتغلين بأمور لا علاقة لها بالجامعة مثل الرياضة؛ أو التجارة؛ أو حتى بقتل النفس بالحضور المبالغ فيه فيما يشبه الأعمال الأكاديمية والبحثية ومشاريع التنمية؛ أو حتى الحضور المكثف للاجتماعات من أجل توظيف المعلومة في صراعات وهمية لا تنتهي، أو حتى البحث عن خلاص ما في طريقة عقائدية ما. كما هناك زمرة من الذين يتلاعب بهم يجيشون وتقضى بهم الحوائج ولو ببعض الظن ببعض الأهمية.
للنماذج تلوينات وتنويعات كما في أي فعل اجتماعي وكما في أي تنظيم، حيث الأفعال مرتبطة بردود الأفعال، وحيث المشاريع لها مقاومات، بعضه يصل ولو مشوها وجله يسقط في الطريق.
ويجب استحضار أن لدينامية المجموعات منطق يفضح الأقنعة، دون نسيان تواجد الفلتان الذي قد يؤثر في أي منطق، وقد يلوح بأي شيء، وهنا تظهر الحوادث الكبرى من اختلالات وفضائح أصبح الرقمي يزكيها ويفعل فيها ويساهم حتى في حدوثها.
الهيمنة السياسية الكبيرة والصغيرة، العلنية والمتخفية والمشرع لها والعرفية، المجملة والمتصرفة، هي لب المعضلة بالنسبة للتعليم العالي في المغرب.
أما الذين في مراكز القرار فيفضلون السياسة على العلم والبيداغوجيا، ويشتغلون غالبا بفرق تسد وركوب الموجة الناجحة والبحث عن شبكة الحماية كحلقة لها ما فوقها وما تحتها. وحتى تتم الحماية وحتى يتم الولاء لابد من القرابين وبعض الكرم، ومن ثمة الاشتغال بالأعمال والتجارة، لتعود الجامعة مشرعة على المجتمع ومصالحه الدنيوية والفجة كأي حقل من الحقول الانتفاعية.
كل النماذج تسبح في بنية عنكبوتية لا تترك كثيرا من هامش المناورة تجعل الجميع يقدمون الولاء لمن يستطيع الحماية أو يؤدي إليها. كما أنها توجد في كل المستويات مثل الدمى الروسية، ما أن تفتح متنفذا حتى تجد آخر، وما أن تفتح منفذا حتى تجد أخر.
أين يقع التفاعل وماهي مواقع الحقل الجامعي؟
التعيينات الأولى هي ملتقى الإرادات السياسوية والايديولوجية، وأحيانا بالمعنى الحزبي الضيق، أو حتى بالمغامرات الفردية، وفي تاريخ التعليم أحداث كثيرة، خاصة الصراع بين الفرنكوفونيين والعروبيين، تارة تطغى هذه الإرادة وتارة تطغى إرادة أخرى حسب مزاج العلاقات الدولية، أو حتى الأفراد في كواليس المديريات. واستمر الحال حتى ظهر ما يسمى بالجامعة غير العمومية التي انتصرت للفرنسية في البداية وهي تميل الآن نحو الانجليزية، لتترك الجامعة العمومية للغة العربية التي لن تنتج نخبا تزاحم القوة والقرار المركزي.
القرارات الكبرى في الحقل الأكاديمي المغربي ليست استراتيجية ولا تتبع مشروعا واضح المعالم، بل هي كسياسة البلد جد عملية وغير معيارية، الأمر الذي يضرها ويضر المجتمع، هي باللغة السوسيولوجية أنوميا وفوضى تطبع هذا الحقل ليس كسلوك فردي او حتى جماعي فحسب، وإنما كصناعة ترسخت وأصبحت استراتيجية القرارات المفاجئة التي لا تخضع لا لقيم التقليد ولا لقيم الحداثة، لا للعدالة ولا للتحكم المعلن والصريح. بل واستفحل الأمر ليصل إلى حدود توزيع الغنائم الحزبية كجزاء في الانتظام والخضوع لمنطق الحملات الانتخابية.
الأمر لا يتجلى في التعيينات فقط بل وفي تنزيل النصوص المنظمة التي تبدو عقلانية وحداثية وبالمشاركة، لكن على مستوى النصوص فقط. وما أن نعلم كيف تشتغل الأمور في هذه المجالس سواء بالنسبة للمنتمين بقوة القانون أو بالتعيين أو بالانتخاب، وحضور التدخل القبلي والبعدي للإدارة، حتى نفهم الرهانات الحقيقية غير المعلنة في بناء المشاريع والسياسات، والتدبير الإداري والمالي للمؤسسات، خاصة أن مهام هذه المجالس جد واسعة وجد حيوية تكاد تطال كل مناحي الحياة الجامعية برمتها.
داخل مؤسسة جامعية:
لا يكفي أن تطلع على الهيكل التنظيمي للمؤسسات الجامعية، ولا الاطلاع على القوانين والمساطر والمذكرات وتحليل مضامينها. الأمر الذي يوضح لك كيف تشتغل المؤسسة هو ملاحظة ووصف ومحادثة الفاعلين كلهم، الأساتذة والطلبة والإداريين وحراس الأمن ورجال ونساء النظافة، لأنه وكما في أي تفاعل اجتماعي لا يعلن عن المهم والفعلي عادة، إنما الأمر يعطى لك بالبحث عنه والاقتراب منه. حياة الجامعة معقدة ومتداخلة الأفعال، فيها التدريس والتأطير والاشتغال في مسلك أو مجموعة بحث أو مختبر.
يمكن اعتبار مجلس المؤسسة برلمانها الذي يسهر على سير الأعمال البيداغوجية والإدارية والتدبيرية، وبذلك يمثل فيه كل من ينتمي إلى المؤسسة، وتتكون منه لجان تسهر على السير الأفضل لحياتها. كما يسهر المجلس على المراقبة والتقويم، وحتى والتأديب والزجر، ومن هنا الخطورة الحيوية لمخرجات وقرارات اجتماعات هذا المجلس. لكن هذا في المسطر في القانون نظريا فحسب، لأن ضحالة مياه البركة تجعل المنافسة في التأثير في المجريات جد حادة وخاضعة لاعتبارات غالبا ما تكون غير علمية وغير بيداغوجية، وحتى غير تنظيمية، وقد تطور الأمر من الصراع الايديولوجي إلى الصراعات التي تأتي خارج المؤسسة لفرض سياسات ومنافع مادية ورمزية يمكن أن تصل الى حدود تهدد الأهداف النبيلة للمؤسسات الجامعية.
ويمكن هنا للتتبع الاثنوغرافي اليومي أن يساعد علىفهم وتحليل السلوك الذي يوصل إلى القرار، خاصة وأن نسبة التواجد في المؤسسة الكمي والكيفي ليس متكافئا بين الهيئات فبحكم طبيعة التدريس لدى الأساتذة وكذلك عادة عدم الحضور إلا لإلقاء الدروس عكس العميد كمؤسسة والذي يتواجد باستمرار ويتتبع بطرق مختلفة كل خبايا المؤسسة، وبحكم هو من يدعو إلى الاجتماعات ويضع جداول الأعمال، بحكم كل ذلك وغيره من التسيير شبه السياسي بفرق تسد وبضرب البعض بالبعض واستغلال النعرات واحتكار المعلومة، تشتغل المؤسسة كلها وفق مبادئ غير عقلانية، الأمر الذي يفسر الحوادث الجانحة للفعل الجامعي في المغرب.
دون نسيان تدهور هذه المؤسسة التي أصبحت تابعة لمؤسسة الرئاسة أدبيا وماليا ومن ثمة سياسيا.
ورغم كل ذلك تبقى هناك مواقف بعض الرجال المشرفة التي تجعل أمر الجامعة مازال ينزل فيها المطر بلغة الشعب.
فحص كيف يشتغل الفاعل الجامعي المركزي أستاذا وموظفا إداريا وطالبا، ثم الفاعل الهامشي مثل حارس الأمن والمسؤول عن مفاتيح القاعات والمنظف والبستاني. فحص كيف تشتغل الخلايا واللجن؟ وكيف تمر الانتخابات لرئاسة الشعب؟ واللجن الأخرى؟ وكيف تتكون مجموعات البحث والمختبرات والمراكز؟
كيف تسير وكيف تمول؟ بل وقبل ذلك ماهي الفئات الاجتماعية التي يأتي منها الأساتذة والطلاب؟ وكيف يتم التجييش خاصة؟
هي أسئلة كثيرة تحث على الوصف الأمين للحياة الجامعية المخترقة سياسيا واجتماعيا سواء في التعيينات وفي سير الهيئات، أو حتى في الحياة البيداغوجية والديداكتيكية التي تتجلى في مستويات منها الهندسة البيداغوجية؛ وبناء الملفات الوصفية، من الأهداف حتى التقويم، مرورا بالمضامين والبحث عن المتدخلين، حتى ليبدو ماهو بيداغوجي محض لعبة رهانات، ولسوء الحظ أحيانا حقيقية وأخرى مفتعلة ومسيرة عن بعد. وأخرى وهمية، أو حتى لعبة نرجسيات ليست شخصية فحسب، وإنما تصنعها أيضا ثقافة اجتماعية وجامعية مترسختين في مجال سبق وأن قلنا بأنه جد ضيق يحسب الذي ولجه أنه قطع الوادي واطمأن إلى أنه من الصفوة. هذا البعد النفسي يشغل أوهاما كثيرة ومتنوعة ترتبط بالإنتاج العلمي وبالتدريس وبالتأثير وبالمناورة.
الحماية دينامية وسيرورة ليس فقط بين الحامي والمحمي، بل والسياقات المتحكمة فيها والتي تتعقد لأن الحامي نفسه بحاجة إلى حماية، وأحيانا حماية المحمي، لعبة السيد والعبد تشتغل لتفرض التواجد الضروري لكليهما ليس كأشخاص وإنما كأدوار تتلون وتتغير بتغير المصالح والتمظهرات المبنية على الفعل الاجتماعي القصدي لكن في حدود القصدية التي تحدها الرهانات والمصالح والقوى المتنازعة. لا شيء دائم غير البركة الضيقة التي تسبح بها أسماك مؤقتة باستمرار. تبادل التأثير والتأثر يضعنا في حلبة أحيانا حريرية وأخرى عنيفة تتبادل فيها الضربات.
الحماية مسطرة بمعيار متحرك يزيد وينقص حسب السياقات، تارة تصبح بارزة وحتى مفضوحة في الأزمات ولحظات التجييش وإثر التعيينات الكبرى، ثم تخفت لتتخذ الشكل الروتيني لتدبير أي تنظيم يملك مساطر وقواعد اللعبة ولو ظاهريا.
الحماية رسالة وليس فقط أركانها الرئيسية الحامي والمحمي، بل وصيغ الحماية ومضامينها المعلنة والخفية، والتي قد تكون فقط نوعا من الحاجة إلى الآخر والخوف من العزلة وفقد الجماعة. لكنها قد تكون مؤسسة بانتماء إلى حزب أو تيار أو قناعات مشتركة. دون نسيان بياضات المتن التي تحيل أحيانا إلى أمور جد مهمة يراد لها الإخفاء.داخل المؤسسات لا تدري متى يتوقف الفرد ومتى تبدأ الجماعة أو العكس، هي لعبة تغري بالفهم العميق للفعل الاجتماعي الميكروسكوبي دون نسيان تدخل الماكروسكوبي. الفرد والجماعة هنا شيء واحد من زاويتين مختلفتين بتعبير السوسيولوجينوربرت إلياس. يمكن لمحمي كبير وحده أن يكون الجماعة كما يمكن للجماعة أن تنصهر في رغبة زعيم ولو لمجابهة أخرى أو زعيم أخر.المؤسف حقا هو دور الجامعة الخافت وأثرها على المجتمع اشعاعيا عكس تدخل المجتمع فيها، وخاصة السياسي والحكومي في الصغيرة والكبيرة.
بكل ذلك منهجيا مقاربة الجامعة ترفض الحتميات كما ترفض الحرية، هي تمظهر يجب فهمه في لحظته دون نسيان أثر اللحظات السابقة وخاصة الفارقة مثل الاصلاح ووضع الوزارة لقوانين جديدة، أو حتى لحظات بعض المواقف للنقابة محليا وجهويا ووطنيا.
نسق قيم الجامعة المغربية:
تتحكم في الجامعة المغربية قيم فيها التقليدي وفيها الحداثي، فيها التي تحث على المضي إلى الأمام والانفتاح، وفيها الدوغمائية المبنية على ليس هناك أفضل مما هو موجود، وفق عقلية ريعية تستلذ المكتسب الوهمي وتخاف من الاختلاف والنقد والابداع، وعلى العموم فمنها الايجابية ومنها السلبية.
الإيجابية:
– الاجتهاد الفردي ومحاولة إثبات الذات رغم المعيقات والمثبطات وشبكات الولاء والحماية.
– الذهاب تجاه المعرفة وتنميتها بالقراءات وعقد اللقاءات والندوات والنشر في المجلات العلمية وغير العلمية.
– الذهاب تجاه الطالب، الأستاذ في الجامعة المغربية يعتبر الطالب شريكه الأول، ويمكن اعتبار هذا الفعل من القيم الأساسية، وربما نواة الحفاظ على الصيرورة وتقدم المعارف وصناعة النخب المستقبلية.
السلبية:
– المحافظة:
ككل مؤسسة معرفية تتسم الجامعة بالمحافظة، وهو أمر إيجابي في الحدود المعقولة التي تحفظ توازن التنظيم نحو تحقيق الأهداف وتقويم المنجزات، لكن ما أن يتجاوز الأمر عتبة تقفل الاجتهاد وتضع عراقيل أمام النقد والابداع حتى تصبح المحافظة انغلاقا يتهدد بإعادة الإنتاج اللانهائي.
– غياب إتيقا متواضع عليها:
كأي مجال يجب أن تسود فيه العقلانية ووضع الأهداف والمساطر ومعايير متفق عليها يجب على حقل الجامعة أن يعتمد مدونة أخلاق معلنة يخضع لها الجميع وتخلق هيئات مستقلة عن الإدارة من أجل حمايتها والدفاع عنها وتحيينها وتجويدها.
– غياب تقاليد ومعيارية دقيقة:
الجامعة ليست مجال معرفة وعلم وخبرة وأبحاث ودراسات فقط، هي حياة بين التنظيم المغلق والانفتاح المراقب، هي مجال تبادل الأفكار والرؤى والآراء، كما أنها مجال المواقف والتفاعل، هذا الوضع الدقيق للجامعة يجعلها مجالا يجب أن يخضع لتقاليد وعادات وطقوس لكن ليس كتلك التي في المجتمع، الجامعة أنا أعلى يراقب الانفعال والنزوات والتجاوزات الاجتماعية، وحتى يتم ذلك تعتبر المعياريةالصارمة ضرورية للسير العادي اليومي سواء على المستوى العلمي أو البيداغوجي،
– الانفتاح المفرط على السياسة:
من الأمراض المزمنة للجامعة المغربية انفتاحها المفرط على السياسة بمعانيها السلبية التي تعني التجييش واعتماد منطق الدسيسة والمؤامرة والاستعمال عن بعد باستغلال المكانة والمعلومة.
لن تنجح الجامعة إلا إذا استقلت، وليس في الأمر مزايدة إنما العودة إلى طبيعة الأشياء في كون الجامعة رأس المجتمع وليست يديها أو أرجلها. الجامعة هي التي يجب أن تفكر لمشاريع المجتمع، وهي التي يجب أن تقترح، ببساطة لأنها هي التي تملك إمكانية البحث الموضوعي البارد، والتي تشغل الذكاء غير المصلحي والذي بإمكانه أن يفكر ويعيد التفكير ويغير الفرضيات بتتبع السيرورات، على عكس الذكاء السياسي المصلحي واللحظي. وقد وضح السوسيولوجي ماكس فيبر وبعمق الاختلاف الشديد بين العالم والسياسي، وفصل بينهما فصلا تاما.
هي طوبا لكن في المجتمعات التي تستفيد من جامعاتها والتي تبدو منفتحة وشفافة نجدها قد أغلقت الأبواب على السياسيين حتى لا يشوشون على التفكير البارد.
– استقلالية الجامعة ودمقرطتها:
تركز السياسة الرسمية تجاه الجامعة على ربط التكوين بسوق الشغل كلازمة تابعة للتوجه النيوليبرالي، حيث تعتبر إمكانية التشغيل المعيار الأول لأي نجاح، أما بالنسبة للأستاذ الجامعي فالذي يهم عنده هو الثلاثي التقليدي: التدريس الذي يعني جعل الطالب يتمكن من معارف ومهارات تؤهله للإدراك والفهم السليمين ليس للحياة فحسب بل وللمعارف النظرية والعملية، والاستعداد على تطويرها في البحث الأساسي الذي قد يرتبط بالبحوث الأخرى التنموية والتدخلية، أولا يرتبط سوى بصيرورة تقدم العلوم نفسها. وحتى يتم ذلك يرافق الأستاذ الطالب بمعارفه وتجربته وخبرته.
ماذا نريد من الجامعة الآن؟
في الغايات القصوى يجب أن تعمل الجامعة على قيادة المجتمع نحو العقلانية والدمقراطية ومباركة القيم الكونية المتسامحة، وتنمية كل ما هو انساني بيئي وثقافي، وذلك بتثمين كل المجهودات التي تساعد على تقوية الشخصية الثقافية والاجتماعية للمغرب بكل روافدها دون أي انغلاق، مساعدة في الحفاظ أيضا على الشخصيات الاجتماعية لكل شعوب الأرض.
هذه هي الغايات القصوى التي يجب أن تشغل أليات من أجل الوصول إلى أهداف ملحة منها:
– إعادة الثقة في الجامعة وتنمية الجدوى في فعلها؛
– تقوية تدريس اللغات والقدرة على التعبير الدقيق والملائم الحر؛
– تقوية الفكر المنطقي العلمي والقدرة على الاستقلالية عن الخرافة؛
– القدرة على تأمل الذات وفحصها بإدراك نقائصها وتقوية نقط القوة، وتنميتها؛
– القدرة على تجاوز قيم الفروسية الوهمية نحو الإنتاج الملائم والمثمر.
– تثمين المجهودات الشخصية والنقد والابداع.
– تجاوز منطق الهاجس الأمني والخوف.
– المهارات الحياتية تكتسب في الحياة، في المقاولة والحياة الثقافية الثرية والسليمة.
* أستاذ علم الاجتماع جامعة مولاي اسماعيل بمكناس