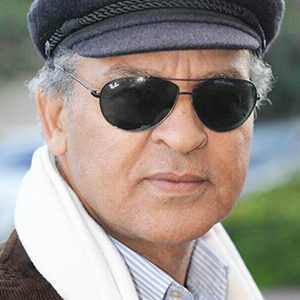قراءة نقدية للنموذج التنموي الجديد 2/2
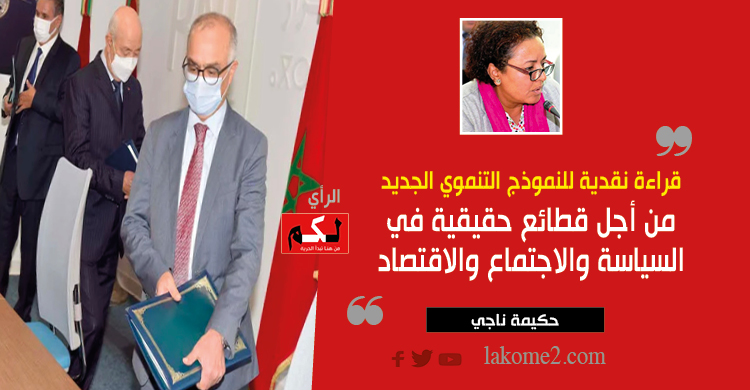
وأما بعد، فهل النموذج المقدم سوف يقلع بنا كدولة وكمجتمع؟
آراء أخرى
يمكن تلخيص مخرجات اللجنة بشكل تخطيطي في تقرير عام وثلاث ملحقات، الأول ويتعلق بمساهمات مؤسسية ومواطنة وجلسات الإنصات التي نظمتها اللجنة، والثاني ويدون المذكرات الموضوعاتية، والثالث عبارة عن رسم لمجمل عمل اللجنة وكل من ساهم في النقاش في إطار عملها من مواطنين وجمعيات ومؤسسات ووثائق تم الاطلاع عليها… علاوة على ملخص تنفيذي لمن يريد الاختصار ولكنه يبقى غير كاف للإحاطة بعمل اللجنة ومقترحاتها، غير أنه يشكل مرآة حقيقية لأوليات التقرير وطموحاته الفعلية لمغرب الغد.
يتركب التقرير العام من ثلاثة أقسام، الأول ويشخص واقع الحال على كل المستويات، ويستشرف المغرب في أفق 2035 ويؤكد على ان التغيير مطلوب وضروري وممكن؛ أما القسم الثاني فهو الخاص بالنموذج التنموي الجديد، أي مغرب الغد، سطر الطموح، المرجعية المعتمدة والمحاور الاستراتيجية للتحول؛ أما القسم الثالث فخصص لرافعات التغيير من أوراش اعتبرها التقرير حاسمة لإطلاق التحولات الضرورية للنموذج، وآليات للتفعيل أرساها على ميثاق وطني من أجل التنمية ولجنة قيادة يرأسها الملك. لماذا هذا التذكير بمكونات التقرير/التصور للمغرب المقلع المأمول؟ إن الغاية من ذلك الوقوف على القطائع التي ابتغاها التقرير والمكانة التي تصورها للنساء وعلاقات النوع ببلادنا.
يمكن القول إن التقرير قد قام بعملية تجميع هائلة لكل ما أنتج علاقة بالتنمية ببلادنا من لدن العديد من المؤسسات الرسمية وغيرها. إلا أن الأمر لا يتعلق في نموذج تنموي بالكلام عن كل شيء، وإنما عما تكلمت مفاصله الأساسية لأنها هي التي تعطي للنموذج هيئته التي يجب أن يتعرف عليها الجميع بوضوح. والحالة هذه، ما هي الإشكاليات التي سكت عنها التقرير أو تكلم عنها بلغة رمادية أو رمى بها في غير مفاصله؟ وما هي الاعتبارات التي حكمت ذلك؟ وبالخصوص علاقة بالقضايا المطروحة في الساحة العمومية. لماذا لم تعتبر إشكاليات النوع من ضمن مفاصل النموذج؟ ولماذا لم يعتبر الإشكال الثقافي على أساس اعتباره بنية فوقية تهدف لاستنهاض المجتمع كمفصل للنموذج يهدف تفكيك الثقافة السائدة المعيقة للتقدم، المبنية على الخرافة وشبه المعرفة الدينية الممزوجة بها النابذة لكل ما هو عقلاني مبني على المعرفة العلمية. … إن الجرأة تقتضي الخطاب الواضح المباشر، أين يكمن العطب الحقيقي في التنمية والتقدم بالمغرب، وعدم الخلط بين السبب والنتائج. لا يمكن للتقرير أن يرتفع عن عدم الخوض في إشكالية التخلف التاريخي لبلدنا الناتج عن سيادة التفكير الخرافي والمعرفة والممارسات الدينية المتخلفة. فما العمل في هذا الباب الذي إن لم نفتحه لتعريته وتفكيك ميكانيزماته لن نتمكن من بناء مناخ الابتكار والتسامح واحترام الاختلاف، بعبارة مقتضبة، بناء المجتمع المتماسك. إن المقصود بمفاصل النموذج تلك المحاور الاستراتيجية التي عليها يقوم ومنها ينبثق. والتي أجملها في القسم الثاني من التقرير العام. فكان من الضروري محورا آخر يحمل عنوان تحديث المجتمع من خلال المساواة بين النساء والرجال والنهضة الثقافية التحديثية.
ما هي الحظوظ المتاحة اليوم لتفعيل ما جاء به التقرير؟ بمعنى ما هي أشكال المقاومات التي لم يعرها التقرير من الأهمية التي تستحقها لأن من شأن ذلك أن يعيق التفعيل. كلها أسئلة في صلب السيرورة التنموية المركبة والتي تقتضي معالجة مركبة تجعل من العوامل التاريخية الثقافية في نفس مقام الاهتمام بالعوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وكل إهمال لها سيعطل السيرورة برمتها.
حقوق النساء ومساواة النوع في النموذج
ضعف انفتاح اللجنة على النساء والحركة النسائية:
منهج المشاركة الانتقائي حرم النساء والنسائيات من المساهمة في أعمال اللجنة. فلا نعرف نسبة المشاركة النسائية في المشاركة التي اعتبرتها اللجنة واسعة جدا. فقد غابت المعطيات حسب الجنس في التقرير حول المشاركة. ولم نعرف هل تمثلت في المساهمات المؤسسية؟ (انظر لائحة الإنصات) ولو كانت المساواة بين الجنسين هما حاضرا لدى اللجنة لضمنتها ضمن التوجيهات في عملية الإنصات … يبدو أن المساواة لم يكن لها صوت معبر يحملها داخل اللجنة كما كان لباقي الإشكالات التي أخذت حيزا واهتماما كبيرين…
قد يقول قائل من اللجنة انه ليس حاملا لقضية، أي ليس بمناضل، فماذا بقي من معنى للنموذج التنموي إذا يكن قضية يحملها فاعلون عضويون يناضلون من أجل تقدم المغرب.
فلا البلاغة ولا اعتماد تقنيات التواصل الممكنة وغير ممكنة سوف تجعلنا نتوه عن الأساسي، وتجعل مما اقترحته اللجنة قادرا على إطلاق المغرب الصاعد الذي نطمح لانبلاجه.
إن المعطيات التي دونت ضمن خلاصات جلسات الإنصات تبين أنها لم تحدد نسبة المشاركة النسائية، إذ لا نعرف عدد المواطنات اللواتي تم التواصل معهن ضمن 8900 شخص بشكل مباشر عبر اللقاءات والمنصات الرقمية، بينما تم تخصيص المعلومات بالنسبة للشباب ومغاربة العالم للأهمية التي أعطاها التقرير لهذه الفئات. بالنسبة للإنصات على المستوى الترابي، فلا نعرف أيضا عدد المواطنين والمواطنات الذي تم التواصل معهم (20 زيارة ميدانية). فلا الأحزاب السياسية ولا المنظمات المهنية ولا الفرقاء الاجتماعيين اعتبروا المساواة من الأولويات كما بينته هذه الخلاصات، بل جاءت في نهاية ما يشغل كل من تم الاستماع لهم.
النساء لسن مجرد فئة اجتماعية للإدماج كما جاء في النموذج، إنهن قوة اجتماعية جديدة محرك للتنمية:
ما أجله النموذج التنموي حتى يحدث بصدده ” نقاش اجتماعي ديني”، من تمييز في الوسطين الخاص والعام، هو بالضبط ما يعيق تحقيق ما اقترحته لتمكين النساء
منذ ما يقارب العقدين، لاحظنا شيوع مقاربة النوع في الخطاب الرسمي لبلادنا نتيجة تداوله دوليا من طرف الدول والمؤسسات الدولية حقوقية كانت أو ثقافية أو مالية أو صحية أو تجارية. غير أن الخطاب في هذه المسألة ببلادنا يغلب عليه الجانب الشكلي الإجرائي في انفصال تام عن الجذر الفلسفي والسياسي للمقاربة. ويرجع ذلك لسببين رئيسين، الأول ويتعلق بعدم القناعة بالمساواة بين النساء والرجال التي تشكل المحور الرئيسي للنوع، وهو ما تنتج عنه شطحات بهلوانية لإفراغه من محتواه، وفي التجربة المغربية من الأمثلة الكثيرة التي يمكن وضعها في مجال المحافظة الدينية أو الليبرالية على حد سواء. والثاني ذي الصلة بالمعرفة النظرية وتداعياتها على التطبيقات في السياسات العمومية. ومداواة هذه الأخيرة لا تكون إلا عبر بحث علمي عضوي داخل الجامعة وخارجها وإدماج فلسفة النوع ضمن المقررات المدرسية والجامعية. وتمر مداواة الأولى بتبني الدولة لمشروع حداثي ديمقراطي غير ملتبس.
إن الممارسة السائدة في مقاربة النوع و التمثلات الغالبة حول النساء يجب أن تشهد تغييرا جذريا، وذلك باعتبارهن فاعلا لا مفعولا فيهن، بل محركا للتنمية الشاملة وتحديث الدولة والمجتمع و دمقرطتهما، وأن المساواة بين الجنسين ليست عملية حسابية فحسب، بل هي أولا عمل تفكيفي لعلاقات السلطة غير المتوازنة بين النساء والرجال وأن المنابع المنتجة والمغذية للامساواة توجد في كل مكان وبالخصوص في المؤسسات الاجتماعية التي لا نعيرها الاهتمام اللازم المتمثلة في المعايير والقوانين التي تشرعن التمييز على أساس الجنس. إن تغيير تمثلاتنا للنساء يشكل محور النهضة الثقافية المنشودة للنموذج التنموي الجديد.
ومن هذا المنظار تصبح النساء ليس مجرد فئة اجتماعية موضوع للإدماج في المجتمع كما جاء في النموذج. ولسن مجرد أرقام حتى تختزل إشكالية التمكين الاقتصادي في بعض المؤشرات الموضوع عن جدواها اليوم العديد من التساؤلات، كرفع نسبة نشاط وعمل النساء وخفض نسبة البطالة لديهن… لأن هذه المؤشرات لا تعني شيئا بالنسبة للنساء إذا كانت سوف لن تقطع مع الممارسات السائدة كالعمل غير المؤدى عنه أو العمل الهش الذين لا يحفظا الكرامة…ألخ. إذا كان سوف لن ينتصر لهن في التعزيز الحقيقي لقدراتهن ولحريتهن في الاختيار دون ضغوط اجتماعية كانت أو ثقافية. فقد كان من الأولى أن تحدد الغاية نسبة تقليص الفوارق في العمل المأجور الكريم وفي المجال المقاولتي والمقاولة الذاتية ورفع نسبتهن في القطاع الخاص ذي القيمة المضافة العالية…ألخ. إن التقارير الدولية الجادة اليوم تضع الفوارق بين النساء والرجال هي الفيصل لتحسين مكانتهن المجتمعية. فالفرق بين المقاربتين شاسع. إن الرفع من نشاط أو عمل النساء والرفع من جودة ذلك لضمان عيش كريم وتيسير تفتق طاقاتهن لا يكون مجديا إلا إذا كان يستهدف القضاء على الفوارق بين الجنسين بدون تحفظ وردم الهوة من حيث السلطة بين الجنسين في الفضاء الخاص والعام.
فإذا كان “تعزيز المساواة بين النساء والرجال حسب النموذج يشكل تحديا تنمويا وحافزا لانبعاث مجتمع منفتح ودامج للجميع لتعبئة القدرات والتمتع بالحقوق كما ينص على ذلك الدستور“ (انتهى كلام التقرير)، وهذا صحيح، فإن هذا الدستور قد خصص 18 فصلا من أحكامه للمساواة واعتبر الاتفاقيات الدولية المصادق عليها ذات أولوية على القوانين الوطنية، ونصت المادة 71 منه بصريح العبارة أن الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور ونظام الأسرة والحالة المدنية من اختصاص القانون. فما الذي عقل قلم اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي في مقترحاتها حول القضايا التي لا تزال تزعج؟ ولماذا رمى التقرير بها في عالم الغيب المظلم منتصرا لضغوط المحافظة ضدا على احترام القانون ومؤسسات الدولة الحديثة؟
ويقول التقرير أيضا إن ” عدم تحقيق التقدم الكافي في مجال إدماج المرأة يشكل عائقا رئيسيا لتسريع وتيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي”، فهل يعتقد التقرير أن اللامساواة في المؤسسات الاجتماعية، كما حددتها تقارير منظمة التعاون من أجل التنمية الاقتصادية OCDE منذ التقرير الأول لمؤشر المؤسسات الاجتماعية والنوع، لا تشكل العائق الرئيسي لاندماجهن؟ إن هذه المؤسسات الاجتماعية تتمثل في القوانين والمعايير والممارسات التمييزية التي تؤثث للتميز، داخل الأسرة إذ لا تزال حصة النساء في هذا الصنف من العمل غير المؤدى عنه كبيرة جدا مقارنة بالرجال، والحد من ولوجهن للموارد المنتجة والمالية، والحد من حرياتهن المدنية والعنف الممارس عليهن. إن كل هذه المؤسسات الاجتماعية التمييزية تعوق وبشكل كبير كل المجهودات التي يمكن القيام بها لتمكينهن اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا. ويؤكد تقرير 2019 أن هذه المؤسسات تشكل معيقات لتحقيق الهدف الخامس لأجندة 2030، بل تعيق الأجندة برمتها. ولقد تربع بلدنا من حيث مؤشر SIGI (Social Institutions and Gender Index) المؤسسات الاجتماعية والنوع ضمن مجموعة الدول حيث التمييز عال أو عالي جدا في هذه المؤسسات من زاوية النوع. فقد بلغ التمييز داخل الأسرة 73% وهي نسبة مرتفعة، و59% في باب الحريات المدنية للنساء، وقد صنفت أيضا مرتفعة، وفي الولوج للموارد الإنتاجية والمالية، 38% (متوسطة)، وبالنسبة للسلامة الجسدية 26% (متوسطة). وقد قدر التقرير الذي خصصته منظمة التعاون لأفريقيا هذه السنة 2021، ثمن التمييز في المؤسسات الاجتماعية ما يعادل 7،5% من الناتج الداخلي الخام لسنة 2019. مؤكدا على استمرار سيادة الأدوار التقليدية داخل البيوت مما ينتج توزيعا غير عادل للأعمال المنزلية غير المؤدى عنها والتي بدورها تساهم بشكل سلبي في مشاركة النساء في سوق العمل. وعلاقة بالتمكين الاقتصادي، فإن التقاليد والعادات التي تعتبر الرجال وحدهم يملكون الحق في ملكية الأراضي تحرم النساء من المصادر العقارية التي تشكل مكونا أساسيا في التمكين الاقتصادي. إن النساء بأفريقيا لا يملكن إلا 12% من الأراضي الفلاحية في حين يشكلن ما يقارب النصف من اليد العاملة الفلاحية. إن القوانين والمعايير الاجتماعية والممارسات التمييزية تنتج فوارق بين النساء والرجال في الحقوق والفرص. وهو ما يستوجب تدخل الحكومات لرفع هذه الكوابح الحقيقة للمساواة بين النساء والرجال.
إن هذه المعيقات لاندماج النساء ومشاركتهن في التنمية تشل كل البرامج والسياسات العمومية، مما يضيع على النساء وعلى المجتمع فرص التنمية الحقيقية ويجعل من تحقيق أهداف التنمية المستدامة حلما جميلا لا نبلغه أبدا. وعليه فما أجله النموذج التنموي للحسم فيه، من تمييز في الوسطين الخاص والعام، حتى يحدث بصدده ” نقاش اجتماعي ديني”، هو بالضبط ما سوف يعيق ما اقترحته لتمكين النساء.
فإذا كان النموذج قد سلك طرقا ملتوية وحاول قدر الإمكان الالتفاف عن قضايا مطروحة منذ ما يقارب عقدا من الزمن على الأجندة الرسمية والساحة العمومية، كالإرث والمساواة الأسرية و الإيقاف الإرادي لحمل غير مرغوب… كما لو كنا لا نزال في تسعينيات القرن الماضي، فإن المحافظة الليبرالية تجلت بوضوح شديد عندما اعلنت بصريح العبارة تمسكها بدور النساء في الاسرة وفق توزيع تقليدي محافظ للأدوار، مقترحة ” خلق شروط مواتية للمشاركة القوية للنساء مع الحفاظ على الدور الذي يقمن به في الاسرة.” وأسوق مثالا آخرا يؤكد التوجه الليبرالي المحافظ للخط التحريري للتقرير، عندما يقترح كتوجهات استراتيجية ” تشجيع الحلول المتعلقة بالمرونة في العمل في الوسط المهني بالنسبة للنساء والتي من شأنها أن تساعدهن في التوفيق بشكل أفضل بين الالتزامات العائلية والمهنية و”بدون تمييز” (رخصة الأمومة والأبوة، العمل بشكل جزئي، مواعيد مرنة، العمل عن بعد…)“. فعلاوة على أن هذه المقترحات سوف تخلق، في ظل تفشي التمييز، شروطا إضافية ملائمة لتكريس التوزيع التقليدي للوظائف بين النساء والرجال، فإنها تقتل كل إمكانية للتفتق المهني والعلمي والذاتي للنساء ولاندماجهن في سيرورة التقدم. إن اقتراح ” المرونة في العمل” بالنسبة للنساء يشكل خطرا أكثر منه فرصة، ولعل هاجسه الأسرة أولا وليس المرأة أولا كفرد له من الحقوق والطموح كما للرجال.
وإذا كان معظم ما يحسب في عداد نشاط النساء إما عمل هش أو عمل غير مؤدى عنه، فماذا يعني والحالة هذه الرفع من نشاط النساء؟ إن تمكين النساء الحقيقي لا يتحقق في ظل هذه الظروف، ولكن إذا نظرنا لهن كقوة اجتماعية جديدة محركة للاقتصاد ليست فقط مساوية للرجال بل لها طاقة للعطاء والابتكار أكبر يعول عليها في هذه مرحلة من بناء بلادنا، وذلك ليس بصفتهن البيولوجية ولكن نتيجة حداثة دخولهن معترك الحياة العامة التي كانت ممنوعة عنهن لقرون. ولا يتأتى هذا الأمر بدون تغيير العقليات الشامل وإحكام القوانين ووضع آليات التتبع والتقويم وطنيا وترابيا. وقد أهمل النموذج العوائق الحقيقية للإمكان الاقتصادي للنساء، أي تلك ذات الصلة بالاجتماعي والثقافي لتحرير طاقاتهن التي بدونها ستتعثر مسيرة التمكين الاقتصادي المبتغاة ويتعثر إقلاع المغرب الاجتماعي.
إن المساواة بين النساء والرجال لا تمر إلا عبر تحديث العلاقة بينهما ودمقرطتها في الأسرة أولا التي تشكل الفرن الذي يصهر التغيير. وهنا يبدو جليا لماذا لم تستعمل قط في التقرير عبارة تحديث المجتمع التي تشكل عماد تحديث الدولة. إن كل ما شخصه التقرير من عوائق تحول دون المساواة ومشاركة النساء في الحياة العامة يظل صحيحا، ولكنه يظل فاقدا للانسجام والشمولية إذا لم يقف على أهمية حدوث نهضة مجتمعية شاملة تنتصر لقيم والمساواة والحرية وفلسفتها.
هل دولة الحق والقانون المأمولة للرجال فحسب؟ تحرير النساء من قيود اللاقانون الاعتباطية
يقال أن الشيطان يتجلى في التفاصيل، والحال أن التفاصيل تقرب من الحقيقة المنفلتة. لنأخذ بعض الأمثلة من التقرير. إن الغايات الخمسة المستهدفة في أفق 2035 لتمكين النساء (رفع نسبة النشيطات، رفع نسبة النساء في المناصب العليا، المساواة في الأجور، التعليم الإجباري، الحق في الطفولة، محاربة الأمية) عبارة عن عناوين لا يمكن نكران أهميتها في حد ذاتها، ولكنها سوف لن تضعنا على سكة المساواة لأن هذه الغايات اختزلت في تدابير كمية. بل منها وفي سياق ” المرونة والعقلانية” المبتذلة، ما يشكل ضربا لمقتضيات دولة الحق والقانون المأمولة، على سبيل المثال ” التقليص من الفوارق في الأجور بين النساء والرجال ب نسبة 10% في أفق 2025، و5% في 2035.
وأما الطموح المراد تحقيقه ” بلوغ مستوى عال من إدماج ومشاركة النساء في الدوائر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وذلك بمحاربة جميع أنواع الإقصاء والتمييز، وتعزيز تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين وبتسريع تغيير العقليات…”، يصبح مجرد شعار للتداول وإعلان للمبادئ في غياب انسجام المقاربة ووحدتها للمؤسسات الاجتماعية السالفة الذكر ومكانة المرأة المساوية من حيث الاعتبار الرمزي فيها وهو ما هادن فيه التقرير أو سكت عنه تماما.
وفي الوقت الذي يؤكد رئيس اللجنة في بعض الجولات التواصلية حول النموذج على أنه تصميم لنموذج وليس خارطة طريق، نجده أحيانا يتأرجح بين الاقتضاب وعدم رفع سقف التحليل، وأحيانا أخرى يغرق في التفاصيل المضرة بانسجام الرؤية. علاوة على أن هناك مجموعة من المقترحات لتسهيل ولوج النساء للفضاء العام لا تحتاج إلا للصرامة في التفعيل كمسألة المساواة في الأجور. ومنها ما يحتاج لمشاركة الجماعات المحلية اعتبارا للأدوار المنوطة بها، كتدبير الحضانات والعنف الممارس ضد النساء في إطار ما تتيحه شركات التنمية المحلية من إمكانيات.
وعلاقة بمقترح ” ملاءمة الترسانة القانونية مع المبادئ الدستورية الرامية إلى المساواة في الحقوق وذلك بالعمل على أربع رافعات أساسية: 1. تمتيع هيئة المناصفة ومناهضة والتمييز APALD بالشخصية المعنوية وحق المتابعة ضد اي شكل من أشكال التمييز، 2. تحديد سلطة القضاء علاقة بزواج القاصرات، 3. منح الولاية القانونية لكلا الأبوين، 4. تفعيل قانون العاملات القاصرات.” يضاف إلى ذلك مقترح ” تشجيع فضاءات النقاش الاجتماعي الديني من أجل تعزيز التفكير حول قضايا وثيقة بحقوق النساء…”؛ تبدو حدود النموذج وخطوطه الحمراء جلية وتظهر الازدواجية في مقاربة النوع بين المقتضيات الوضعية والضوابط الدينية التي فضلت اللجنة وضع النساء فيها خلافا لمقتضيات دولة الحق والقانون التي من أسسها مساواة الجميع أمام القانون بدون تمييز. إن المرأة ليست كائنا دينيا، بمعنى أنها لا تستمد حقوقها مثلها مثل الرجل إلا من القانون الوضعي كما تؤكد على ذلك المواثيق الدولية التي تحاشى التقرير ذكرها خلافا للدستور. ويعتبر هذا خرقا للقانون من قبل اللجنة الخاصة مرة أخرى لأن المغرب دولة عصرية تستمد سياساتها من القوانين.
إن التوجه الاستراتيجي ذي الصلة بحقوق النساء علاقة بالمسألة الدينية وضع اللجنة في حرج كبير فقدت معه الانسجام في النموذج المقترح. إذ غاب ذلك الوضوح والحماس والجرأة التي تم التعاطي بها مع القضايا الاقتصادية. ماذا لو رهنا الحسم في اختيارات اقتصادية لحوار اقتصادي ديني؟ إن الحال الاقتصادي سوف لن يكون مثله مثل الحال النسائي.
وكم من حاجة قضاها النموذج علاقة بالمساواة وحقوق النساء بتركها. سكت عن حق النساء في قرار الأمومة وتوقيتها، وسكت عن مسألة الإرث جملة وتفصيلا بما في ذلك التعصيب الذي يمكن القول إن أمره محسوم اجتماعيا، وتكلم متلعثما في مسألة تزويج القاصرات مكتفيا بإجراء الحد من صلاحيات القاضي وليس المنع كقاعدة مع التحديد الحصري لحالات الاستثناء.
نموذج اجتماعي يكرس التقاطبية المجتمعية ولم يقطع مع التصورات السابقة لا في الاجتماع ولا في الاقتصاد:
نموذج اقتصادي ظل حبيس ضغوطات النيو ليبرالية في ظل شروط التأخر التي يعيش فيها المغرب :
إن الجامعات والمفكرين والسياسيين والتكنوقراط منشغلون اليوم في إعادة التفكير في الاختيارات الاقتصادية وما يستتبعها من اختيارات اجتماعية مواكبة لها نظرا للأزمات المتتالية التي أصبح يعرفها العالم وبالخصوص مع غطرسة النموذج النيو ليبرالي للرأسمالية المعمم في أهم بقاع العالم.
بينما ظل النموذج حبيس ما تفرضه الاختيارات النيو ليبرالية من تقديس للانفتاح والتنافسية وما يفرض ذلك من تخفيض للضرائب على المقاولات دون العمال لتشجيع الاستثمارات، ومرونة في التشغيل وضعف الحد الأدنى للأجور وما إلى ذلك من المقتضيات المغلفة باختيارات اجتماعية، تبقى تقاطبية في النموذج.
إن الاشتغال بنقد هذا النموذج المعولم ليس وليد أزمة كوفيد بل هو سابق عليها وعلى الأزمة العالمية 2008. إن عتاة النيو ليبرالية يتساءلون اليوم عن نجاعة و فعالية وجدوى التوجه النيو ليبرالي، وهم في بحث ونقاش مستمرين لإصلاح الرأسمالية وإيجاد حلول جديدة لمطباتها، من قبيل نظرية رأسمالية الأطراف المعنية(The stakeholders capitalism/ le capitalisme des parties prenantes). مقابل رأسمالية المساهمين (the shareholders capitalism/ le capitalisme des actionnaires).
وإن كان من نافل القول إن خلف كل ممارسة اقتصادية نظرية تؤسسها وتعبد أمامها الطريق، فإن لليبيرالية عدة نظرية مركبة قوية توهم أن لا حل لمشاكل الناس إلا هذا الاختيار، وأن أي اختيار آخر لن يؤدي إلا إلى خراب البلاد والعباد. فتجند كل المؤسسات الدولية لهذه الحرب الاقتصادية تارة بالترغيب من خلال التنبيهات والتحذيرات عبر تقارير موضوعاتية خاصة بهذا البلد أو ذاك، وتارة أخرى بالترهيب عبر تقارير تنقيط الدول وتصنيفها بغية إبعاد أي إمكانية لجلب الاستثمارات الخارجية أو إمكانية الاستفادة من قروض خارجية وما يترتب عن ذلك من نتائج سلبية حتى على المستثمر الداخلي.
وإذا كان عموم الشعب يعيشون النتائج المدمرة للكرامة الإنسانية، وهو أقل ما يمكن قوله لتلخيص آثار الاختيارات النيو ليبرالية، مع ضعف العدة النظرية المناهضة لها ومحاصرتها حتى لا تجد مسلكا لها في مؤسسات إنتاج المعرفة، فقد بات اليوم معروفا أن من أصبحوا ينتقدون الاقتصاد النيو ليبرالي هم عادة من اشتغلوا قبل غيرهم في المؤسسات المالية الدولية أو لبعض الدول المتقدمة عرابة هذه العقيدة الاقتصادية النيو ليبرالية، من أمثال جوزيف استكليتز ومكايل هودسون وغيرهم.
يبدو أن جدارا اسمنتيا يفصل النخبة المغربية النافذة أوغير النافذة عن هذا النقاش العالمي؛ وأن اقتصاديينا لا يتحلون بكثير من الجرأة والابتكار وأن الجامعة لا تتوفر على آليات قادرة على كسر طوق البراديغمات السائدة في العلوم الاقتصادية عن طريق البحث العلمي حتى يتسنى تكوين جيل جديد من الاقتصاديين قادرا على تنوير السياسيات الاقتصادية ببلادنا. إننا نحتاج لنحرر اقتصادنا من هيمنة النظرية النيو ليبرالية، إلى جامعة مستقلة وحرة موجهة نحو الجنوب. إننا فعلا في حاجة إلى الارتقاء بطموحاتنا الفكرية أيضا. لقد فوتت اللجنة الخاصة علينا فرصة ولو على سبيل تجديد النقاش العمومي للانعتاق من شرنقة النيو ليبرالية المستحوذة على العقول. بالخصوص أن النقاش على المستوى الدولي غني جدا.
إن الاعتماد على مؤشرات للتنمية كالناتج الداخلي الخام PIB أو الناتج الداخلي الخام للساكن PIB par habitant، مختزلة للفوارق والهشاشة والفقر أضحت مجحفة وغير عادلة تغطي على الفوارق الصارخة. كما هو الشأن بالنسبة لمؤشر البطالة والنشاط اللذين لا علاقة لهما بالواقع وبالخصوص في واقع حال بلادنا. وحتى معدل النمو لم يعد صالحا كمؤشر للدولة الاجتماعية التي نطمح إليها. فالأمر ليس سيان بين أن نحقق نموا يشارك فيه الجميع و أن نحقق نموا لا يحتاج إلا إلى القليل من الناس كما هو الأمر عليه في الاختيار المعتمد في الطاقات المتجددة الذي نحا نحو شركات كبرى لا تشغل إلا القليل من العقول واليد العاملة مفوتا مسلكا ثان يشغل أكثر، من شركات متوسطة وصغيرة.
عدم قطع النموذج مع تقاطبية كل من التعليم والصحة ينقض اختياراته الاجتماعية
يزعم النموذج أنه يبتغي القطع مع كل المقاربات التي لا تركز على القدرة التي يتمتع بها المواطنين في المشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وعلى ولوجهم المتكافئ للفرص، وهو ما يغذي توسع الفوارق وتقاطب المجتمع. هذا الكلام نظريا صائب بل وعين الصواب. ولكن كيف يمكننا تفسير عدم مساءلته لخوصصة حقين أساسيين غير قابلين للتفويت، التعليم والصحة، وبالمقابل ترك الخدمة العمومية فيهما تتدهور بطريقة كارثية لما يتم من استنزاف للموارد البشرية العمومية من لدن الاستثمار الخاص. إن الإبقاء على القطاع الخاص في كل من التعليم والصحة يعتبر المصدر الأول والأساسي للفوارق الاجتماعية وتقاطبية المجتمع، بل يعد مؤامرة ضد العدالة والتماسك والسلم الاجتماعي.
إن الدولة الاجتماعية المنشودة في القرن الواحد والعشرين الذي يتميز بوفرة في التواصل والمعلومة قل نظيرها، للقاصي والداني، وسعت من وعي الناس ومطالبهم وانتظاراتهم. مع هذا الأمر، أصبحت مساءلة كل العدة المفهومية لكل النظم اقتصادية كانت أو اجتماعية أو السياسية ضرورة لا مندوحة لنا عنها. ولهذا، فأي معنى للدولة الاجتماعية اليوم؟ هل هي تلك التي تدبر الفقر والهشاشة بأنصاف الحلول كما هو الحال بالنسبة لما اقترحه النموذج، أم هي تلك التي تعمل على تجفيف منابعهما كما تنهجه بعض البلدان الاشتراكية الديمقراطية (La socialdémocratie)؟ إن الدولة الاجتماعية ببلادنا يجب أن تكون أكثر وضوح وجرأة وتجيب بشكل قوي على الانتظارات المواطنة بمدرسة عمومية واحدة ووحيدة، وتوفر شروط تعبئة الذكاء الجماعي لهندسة إعادة إدماج القطاع الخاص في القطاع العام دون الإضرار بالرأسمال الخاص المستثمر. أي توفر شروط تأميم عادلة وتشاركية. فعندما تستعيد الدولة هذين القطاعية وغيرهما مما يوفر الخدمات الأساسية للناس، آنذاك يمكن القول باختيار الدولة الاجتماعية. وحتى نقطع مع حالة الانشطار هذه التي تعاني منها منظومة التعليم، والصحة ايضا بدرجة ثانية، يجب حذف الاستثمار الخاص من خريطة هذين القطاعين، وكذلك منع أشكال التعليم التي تديرها البعثات الأجنبية واقتصار هذه الأخيرة على الأنشطة الثقافية. إن هذه المقاربة سوف تعالج مجموعة من الأمراض التي نتجت عن حالة التسيب هذه، من جمعيات ذات مرجعيات متطرفة ممولة بأموال مجهولة المصادر، ومؤسسات تقوم بالدعم بأثمنة خيالية… وهو ما سوف يضمن انسجاما في المنظومة بكاملها ويحقق هدف تقليص الفوارق وخلق شروط لتكافؤ الفرص. إن خوصصة التعليم تشكل المنبع الرئيسي للفوارق ولكنها وحدها ليست كافية لأن ولو توحدت المدرسة، فإن هناك عوامل أخرى تبقى منتصبة كتلك التي يحملها المتمدرس من الأسرة أو من المجال الذي يعيش فيه، إنه الرأسمال الثقافي والاجتماعي الذي يتمتع به البعض دون الأغلبية، وهو ما يستوجب تدخل الدولة الاجتماعية بالنسبة للذين لم يكونوا من المحظوظين لامتلاكه. فعلى الدولة تكبح الآثار الضارة لأوضاع الفقر والهشاشة والمجالات المعزولة وتعمل على كسر سلسلة الفقر والهشاشة وعلى عدم توريثهما.
وحتى لا تصبح الدولة المقرر الوحيد في مسار ومصير المدرسة، فلا بد من ابتكار أشكال جديدة ومتجددة لمشاركة المجتمع الدائمة على المستوى المحلي وعلى مستوى المؤسسة. وفي هذا ما لا يحتاج إلا للتفعيل، فالعديد من المؤسسات معمول بها وإن كانت شكلية في معظمها. فالبلدان الإسكندنافية حيث التعليم يحرز المصاف الأولى في الترتيب الدولي، تعتبر المواطنة النشيطة ومشاركة المرتفقين والاستجابة بالتكيف مع حاجياتهم من الأهداف المركزية للدولة بالنسبة لهذه الخدمات العمومية.
إن التعليم الخصوصي نشا تحت ضغط النيو ليبرالية حتى في هذه البلدان التي تبنت الاشتراكية الديمقراطية ولكن الدولة اعتمدت استراتيجيات لعدم رفع اليد على هذا الصنف ولم تلجأ له كحل لحل أزمة المدرسة العمومية كما هو الشأن ببلادنا عندما أصبحت عاجزة عن استيعاب الطفرة الديمغرافية.
إن الحق في التعليم الذي هو حق أساسي لكل إنسان سوف يرمى به في الميركنتيلية التي أصبحت تتحكم فيها قواعد السوق النيوليبرالي. فيصبح التعليم سوق يخضع لمعايير التنافسية على قدم المساواة مع أية سلعة أو خدمة قابلة للبيع والشراء.
إن بيع حقوق أساسية مؤشر قوي على فشل الدولة يستوجب معه مراجعة شاملة وفعلية لأدوارها وقطائع مع السياسات المنتهجة وبدون مواربة، وتحرير هذه الحقوق من سلطة العقليات التي تستحوذ عليها سلطة السوق.
واما علاقة بخيار الطريق الثالث المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فهو يؤكد مرة أخرى على سيادة روح اللبررة libéralisation التاوية في تفاصيل المقاربة المعتمدة. نقف على هذا الأمر في خلط النموذج بين ما هو من اختصاص الدولة غير قابل للتفويت لأي قطاع آخر خاص أو شبه خاص أو بما يعرف بالشراكة بين القطاع العام والخاص أو بالاقتصاد الاجتماعي. فاعتماد النموذج لهذا الخيار الثالث في قطاعات التعليم والصحة وبعض الخدمات الأساسية المتعلقة ببناء البشر وتلبية حاجاته الأولية، لا يمكن تفسيره إلا بمحاولة لي ذراع الدولة الاجتماعية المنشودة بتغليف نزوعات الخوصصة بأغشية الاقتصاد الاجتماعي. إن هذا الخيار الثالث مطلوب وبقوة نظرا لطابعه الاجتماعي فيما عدا الخدمات ذات الصلة بالحقوق الأساسية للشعب، مع القيام بإصلاحات قانونية ومالية صارمة حتى لا يتحول إلى قطاع خاص مغلف كما هو معروف في بعض الحالات التي أصبحت معروفة. إن تفويض الخدمات العمومية للاقتصاد الاجتماعي يشكل خوصصة مغلفة متنكرة وخطيرة بالنسبة للرابط الاجتماعي.
وأما ما اقترحه النموذج في باب تكافؤ الفرص وتقليص الفوارق ووو… يبقى في عداد إعلان المبادئ الذي سوف لن يتحقق في الأفق الذي حدده في 2035 وهو ما لا نتمناه لبلادنا لأنها تستحق نهضة حقيقية من لدن والمواطن والمواطنة ولأجلهما.
عوض نهضة ثقافية، رسم النموذج سياسة ثقافية: في الحاجة إلى استقلالية البحث العلمي ببلادنا
بالنسبة للثقافة، لم تتخط اللجنة الخاصة الحدود التقنية لسياسة ثقافية عامة هي من مهام الحكومة. وهكذا فالنموذج الذي يتغيى إنجاز القطائع القمينة بالانتقال بالدولة والمجتمع إلى مصاف البلدان المتقدمة ثقافيا لم يستحضر هذا البعد النهضوي للثقافة الذي من دونه سوف لن يكتب التقدم في كل مناحي الحياة الأخرى بما فيها الاقتصاد الذي يسود الاعتقاد باستقلاليته. أسوق مثالين لقطاعين اقتصاديين هامين، من حيث نسبتهما في الناتج الداخلي الخام وفي سوق الشغل، يتأثران بالتنمية الثقافية بشكل كبير. إنهما قطاعي السياحة والفلاحة، علاوة على الاقتصاد غير المهيكل. فإذا كانت السياحة تعتمد على العديد من الإمكانات الطبيعية والتاريخية ومن البنيات التحتية الضرورية والنقل والأمن والسلامة، فإنها وبالأساس تتغذى وتنتعش بالثقافة بشكل عام والثقافة الاجتماعية المبنية على القيم الإنسانية والحرية المسؤولة المحترمة لتعدد مشارب الناس المحترمة لاختلافاتهم، الحاملة لثقافة إنسانية متحضرة… كل هذا لا يتأتى هكذا بإعلانه، بل لا يتأتى إلا بمشروع ثقافي يجعل نصب أعينه نبذ التخلف والفكر الخرافي اللذين يشكلان أكبر معيق للتقدم، ولا يتأتى هذا إلا بالوضوح المرجعي الذي يقطع مع كل معرفة لا تنبني على العقل والعلم، وكذلك يعمل على إصلاح ديني قوي يطهر كل هذه اللخبطة الدينية من التفاسير الخرافية ويعيدها إلى الطريق الذي بناه فقهاء فلاسفة في التاريخ الإسلامي وبالخصوص ببلاد الإسلام الغربي. إن هذا المشروع الثقافي لا يمكنه إلا أن يكون حداثيا ديمقراطيا. فالسائح أو السائحة يتجولون وسط بحر من الناس، في الشارع، في المقهى والمطعم، في الشاطئ، في الجبل… في كل هذا وزيادة. فعندما ترى احوال الناس في الشارع إما أن تنفرك أو تحببك لهذا البلد أو ذاك. فأحوال الناس ببلادنا لا تسر، وعمران بشع في معظم البلاد يقف بشراسة أمام من يزورنا لينبئ بتخلفنا، وأزبال منتشرة في كل مكان بما فيها البادية التي كانت أنظف من المدينة إلى ماض قريب… البشر هو بشر النصف الأول من القرن الماضي وإن اختلفت المظاهر أحيانا. فالسياحة تحتاج بشدة للبحث في كل مجالات العلوم الإنسانية، من تاريخ وميثولوجيا وأنثروبولوجيا وفنون بكل تلاوينها…
وما قلته عن السياحة هو نفسه عن الفلاحة، فالفلاح الذي لا يزال يؤمن بأن صلاة الاستسقاء قد تقربه من الله ليمن عليه بالأمطار وبمبادرة من الدولة، التي في هذه الحالة لا يمكن إلا أن نقول عنها أنها دولة متخلفة، فلا تنتظر منه أن يحترم إجراءات سياسة عمومية مستدامة للفلاحة من قبيل نسب المبيدات وعدم استعمال المياه العادمة في السقي ووو… إن الفلاح لكي يتسلح بمعرفة علمية لابد له من أن يتشرب بثقافة جديدة عمادها العقل. إن احترام الحق والقانون ثقافة في المبتدأ والخبر.
فالقطيعة مع تخلفنا التاريخي يجب أن تشكل الغاية والهدف، لأنها هي البوابة التي سوف ينبني عليها إقلاع أمتنا. وحتى نتملك حقيقة مصيرنا لابد من القيام بتقييم شامل لما تنتجه الجامعة المغربية في هذا الباب، ونطرح السؤال: هل ما تنتجه مفيد للقيام بهذه الثورة الثقافية أم أنها مجرد تمارين مدرسية غير مجدية إلا لمن يريد نياشين الدبلومات الفارغة العديمة الجدوى، ولمموليها الأجانب. من حسن حظ المغرب أنه يتوفر على نخبة من المفكرين والمفكرات، نحتاج لجرأة فكرية عالية لمعانقة البعد المجتمعي لمشاريعها الفكرية.
إن أول الخطو في الثقافة هو العمل على بناء مشروع بحثي كبير وضمان استقلالية الجامعة عن توجيهات التمويلات الأجنبية مع تحديد حاجياتنا البحثية الحقيقية في أفق 2035. وتتبع وتحليل القنوات الجديدة التي عبرها تتشكل وتمر الثقافة باعتبارها بنية فوقية غير قابلة للتحكم ولو من طرف الدول الأشد مراقبة لأنها تتخطى المؤسسات والأفراد وتطبع من حيث لا نحتسب وإن تسلحنا بأعتى الأسلحة للانغلاق على النفس ومواجهة أي تحول. إن الثقافي كائن حي دينامي لا يتوقف عن التغيير، إنه بالطبيعة متغير ومتحول. بل لا توجد حدود مادية أو لامادية يمكنها أن توقف انتشار الثقافة اليوم. إن عملية التثاقف اليوم تعرف سرعة كبيرة في الانتشار لما توفره الرقمنة والعالم الافتراضي من سهولة وسيولة وسرعة في التواصل تتخطى عوائق الأمية ومراقبة الدول. إننا ندخل وبسرعة كبيرة في سيرورة المجتمع المعولم ذي الثقافة المركبة والمتشربة بالثقافات القوية من كل أنحاء العالم من موسيقى ولباس وأكل وسينما وتعمير وأثاث…). فما العمل أمام هذا الدق الثقافي الهائل، هذه العولمة الثقافية الجامحة؟ هل نريد تحنيط الثقافة أم نبتغي المساهمة في هذا المساهمة بشكل فعال في هذا التمازج؟ وما أية سياسة ثقافية في مستوى هذا الوضع الشديد التركيب حيث الفرد يصبح أكثر حرية في اختياراته في فضاء ثقافي معولم حيث تصبح كل وصاية من لدن السلطات العمومية عملية غير مجدية. وهذه الاختيارات ليست دوما بناءة. ففي غياب مشروع كبير لتملك المعرفة بإنتاجها وفي غياب بمدرسة تحث على الفكر النقدي العقلاني المبني على المعرفة العلمية ومع تفشي الأمية وسط جمهور واسع، فإن مجتمعنا سوف يضحى فريسة سائغة أمام ثقافات الانغلاق والتطرف.
فإما أن ندخلها متسلحين لها بالعدة الفكرية الثقافية، متملكين لمخزوننا التاريخي الثقافي الدينامي، أي ندخله كأمة متحضرة أو ستدخلنا كأمة بدائية للفرجة غصبا عنا وتسلبنا من أرصدتنا الثقافية. إن بلادنا دولة ومجتمعا في الحاجة إلى نهضة ثقافية تحديثية تؤهله للتقدم والانخراط في المجتمع المعولم الذي أطلقته الثورة الصناعية الرابعة. ولهذا المشروع الثقافي الجديد التحديثي نحتاج فعلا للجنة خاصة تتألف من مفكرين مغاربة نزهاء ينكبون على إعداده بطريقة تشاركية واسعة.