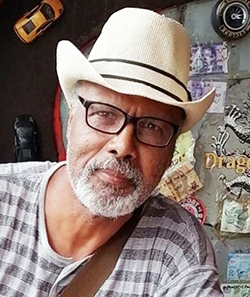الصحبة والجماعة
مدخل
آراء أخرى
عرفت المواقع الاجتماعية الرقمية نقاشات عديدة ولا تزال، حول موضوع الصحبة والجماعة، بعد صدور كتاب الاستاذ محمد العربي أبي حزم. ذلك، لطبيعة الطرح النظري الذي اعتبِر مخالفا للفهم العام داخل جماعة العدل والإحسان. انبرى للرد ثلة من الباحثين منهم الأكادميون ومنهم غير الاكاديميين. منهم من انتصر لهذا ومنهم لذاك كان مؤيدا. منهم من تسرع في الرد وأصدر أحكام قيمة، ومنهم من حاول الحفاظ على توازنه ومنهم المتملق. وبدا الأمر في عمومه حربَ فرقٍ كلامية تكاد لا تفرق بن شقه المذهبي وبين شقه المصلحي.
الكتاب حري به أن يشكل موائد مستديرة متعددة للنقاش الهادئ بالنسبة للنخبة العالمة داخل الجماعة لأنه أعطى للصحبة تأويلا يخالف التأويلات التي تبنتها الجماعة بعد رحيل مرشدها. ونقصد بذلك أن هذا التأويل الجديد أخرج مفهوم الصحبة من دلالتها القطعية، من عالم البديهيات، إلى دلالتها الظنية، إلى عالم التأويل. فرض بشكل ضمني، على متبني الفكر الياسيني ضرورة النقاش في هدوء.
لكن المتأمل بعمق في طبيعة الردود والردود على الردود، من حيث قساوتها أو انطباعاتها أو راديكالياتها، لا شك يراوده سؤال البنيات الذهنية داخل جماعة العدل والإحسان، كيف تشكل نمط التفكير الذي الذي لم يستطع أن يستوعب رأيا مخالفا؟ كيف أنتج نمط التفكير هذا سلوكا يتنافى ومطلب الحكمة والتؤدة؟ يتنافى وأفق البحث عن المشترك، يتنافى وسعة صدر التي تحتضن عمر وزيد من الأعضاء بله عامة الشعب؟ ومعنى ذلك، أن الباحث في بواعث السلوك الانساني، من خلال دراسة ردود الأفعال، يهمه أصل الحركة بواعث الحركة لا الحركة في ذاتها. ظاهرة الشيطنة والإقصاء والتهميش أجدر أن ينظر إليها من خلال البواعث لا النتائج.
كلمتي حول الموضوع تصدر عن رجل من الذين عاشوا التجربة الروحية، وسلكوا مسلكا تربويا ياسينيا لما يزيد عن ثلاثين سنة، لكنني أريدها أن تتخذ صبغة أكاديمية. لا أزعم لنفسي الفهم المطلق ولا عمق المعرفة ولا دقة التحليل، إنما القصد مساهمة تجمع بين البعدين معا؛ الكتابة الاكاديمية الهادئة، لما لها من خصائص ومناهج وآليات من شأنها أن تبسط الإشكال بهدوء، والتجربة الميدانية التي من دونها يستعصي على الباحث، خاصة في علم الأنثروبولوجيا، أن يكون له عمق على مستوى رصد الظاهرة وتفكيكها.
وختاما لهذا المدخل أود تسجيل ملاحظتين لما لهما من أهمية نرجع إليهما في خاتمة الموضوع الذي نرى أن نقسمه لمجموعة من المقالات نظرا لخصوصية المقال الإلكتروني.
الملاحظة الأولى : ما يجمع بين الفريقين كثير؛ وحدة المرجعية الفكرية، وحدة الجهاز المفهومي، وحدة التقدير والاحترام لمرشد الجماعة، وحدة السلوك الروحي والاخلاقي، وحدة الحرص على الصف.
الملاحظة الثانية : مجموع النقاشات والمناظرات، “الفيسبوكية”منها وكذا “الواتسابية”، أبرزت على السطح طاقات تسعفهم اللغة ويطاوعهم القلم. وهذا أحسبه من مزايا وعجائب فتح باب المناظرات والمطارحات ووضع الافهام على محك أفهام الاقران.
I. السلوك الانساني بين البنيات الذهنية والبنيات النفسية
لا أحب لهذه الكلمة في الموضوع أن تنحو منحى الانتصار لجهة دون جهة، فليس ذاك قصدي. ولا أبغي بها جدلا عقيما. يبدو لي أن سبب الاختلاف دقيق لدرجة لم تطرق بابَه أقلامُ من انبرى للرد أو التزكية. لا أقصد بذلك بواعث أو إرادات الفريقين تجاه مسألة الصحبة، وإنما القصد زاوية النظر المختلفة التي كانت، بادئ ذي بدء، أساس الاختلاف ومانعة التواصل. أما عن نتيجة الاختلاف وما أسفر عنه من توترات، فالرأي عندي أن ننطلق من السؤال عن العضو داخل جماعة العدل والإحسان؛ من هو؟ ما هو؟ كيف هو؟ كيف تشكلت ذهنيته؟ كيف تهذبت نفسيته؟ كيف استقامت جوارحه؟ كيف تبلورت شخصيته؟
لإن استعنت على ذلك بآليات ومناهج الأكاديميين بحكم مرجعي الأكاديمية، فلا يعني ذلك أن أتجرد من آليات الفكر المنهاجي، فتلك مرجعيتي الأيديولوجية. قد يغيب عن الكثير أن مرشد جماعة العدل والإحسان في جل كتبه وفي كل الحقول المعرفية التي تطرق إليها وخاض أغوارها، كان يحترم المناهج والآليات الاكاديمية فيما هو مشترك ويتجاوزها فيما غيب من آليات عن قصد. حينما يتحدث المرشد عن الذهنيات على المستوى الفكري أو الأنانيات على المستوى النفسي أو العادات على مستوى السلوك، فبغيته من وراء ذلك، في نظري، لفت الأنظار للبعد الثلاثي في الإنسان؛ نفسيته وعقليته وسلوكه، تفاعلات هذا الثالوث ثم تمظهراته على مستوى الممارسة. حينما يوظف الثنائيات المفاهيمية انما يسلك مسلك البناء النظري التنظيري لعرض التصور وتحليل الظاهرة. فلن أشد إذا ولن أجانب الصواب منهجيا، كما أظن، إن نسجت على المنوال.
الآلة المنهاجية أجعلها حاضرة في تحليل الخطاب، ومقاربة الرؤية لرصد الأولوية بين هذه وذاك. منظومة القيم المنهاجية المؤطرة أجعلها المنظومة المعتمدة لمقاربة الاشكالية بموازاة مع ما يقتضيه العمل الاكاديمي من قيود محمودة. لأجل ذلك سأضع جانبا، في هذه الفقرة، أمرين اثنين:
- النصوص المعتمدة من هذا وذاك، فلكل نصوصه. استشهد الكاتب بما يزيد عن مائة وسبعين نصا من نصوص المرشد. ويستشهد الطرف الثاني بنفس النصوص أو غيرها وتختلف الفئتان في التأويل. لذا لن أناقش في هذه الفقرة دلالة النصوص.
- الموقف من التصوف وقضايا التجديد. ما الذي تجدد؟ وما الذي لم يتجدد؟ ونقصد اعتبار الجماعة البحث عن “وارث السر” من الطقوس الصوفية المتجاوزة في الفكر المنهاجي. ومنه فلا وارث هناك بل “صحبة أفقية” عامة. أما الصحبة العمودية فقد جعلتها الجماعة في روح المرشد التي ظلت حاضرة إن هي رحلت بشريته. في حين يعتبر الأستاذ محمد العربي أن الصحبة يجب أن تستمر بوجود مرشد حي، ويتساءل كيف يعقل أن يتجاوز المرشد أمرا جللا عمل على بلورته طيلة حياته؟ ويتفق مع الجماعة أن المرشد صاحب المشروع لن يخلف. يفرق الرجل إذن بين المرشد صاحب المشروع “الكوني” وبين المرشد صاحب “الدلالة على الله”.
سأتجاوز إذن هاتين النقطتين إلى أن أعود اليهما بتفصيل في فقرات تعنى بالمسألة. لنخصص الحديث عن مسألة زاوية النظر.
- زاوية النظر
من يدعو للصحبة في الجماعة، بدلالتها الصحبة داخل الجماعة ، انطلق من زاوية قوامها تقدير المرشد واحترامه وعدم امكانية وجود بديل عنه. بهذا الفهم نالت الجماعة مصداقيتها ومشروعيتها، نظرا لمكانة المرشد في قلوب الأعضاء. قد ساعد هذا الفهم أيضا أو هذا الموقف على تماسك التنظيم هيكليا، وهو أمر مشكورة عليه الجماعة من طرف جل الاعضاء. لكن ماذا عن تماسكها روحيا يتساءل الطرف الثاني؟
من يدعو للصحبة في الجماعة، بدلالتها الصحبة تفعل في الجماعة لا داخلها، انطلق من زاوية قوامها العضو وليس المصحوب. وهنا تكمل خطورة الطرح، وإشكاله، وتوافقه والطرح المناقض بالنسبة للمحلل الميداني. (رب مستغرب لفكرة التكامل في التناقض! يناقش هذا الطرح لاحقا).
خلاصة أولى:
في الوقت الذي عظمت الجماعة المصحوب وجعلت أمر خلافته مستحيلا، واكتفت بصحبة أفقية، عظم محمد العربي حيرة العضو وتيهه في عالم العجز الروحي بين بسط هذا وقبض ذاك من المصحوبين. مطلب “الانجماع على الله” لا يسمح بتردد السالك بين اختيارات المربين. لذا نراه يطالب بوجود المصحوب حيا تنظر اليه الأجيال القادمة وتطمئن إليه وتحنو اليه وتستأنس بوجوده ، يكون لها أبا واحدا أوحدا لا شركاء فيه وإن اكتنفهم الانسجام.
كان هذا إذا أصل الاختلاف بين التوجهين إذا نظرنا إليه من زاوية نظر كل فريق، دون أن نغفل بالطبع مسألة النظر في دلالات النصوص وفهم النقد الياسيني للإرث الصوفي وتهذيبه في إطار الفهم الشمولي العام للمنهاج النبوي.
- البنيات الذهنية والبنيات النفسية
نقصد بالبنيات الذهنية تشكل العقليات أو تشكل الأفهام أو لنقل تشكل نمط التفكير داخل جماعة العدل والاحسان. تحدث الاستاذ عبد السلام ياسين عن العقبة التي تعترض العقل ووصفها بالذهنيات الرعوية. وأظنه يقصد بنعت الرعوية ذهنية القطيع التابع الذي لا يسأل ولا يسائل ولا يحلل ولا يطرح كل الفرضيات الممكنة، “ذهنية النفوس القاعدة التي تنتظر أن يفعل بها ولا تفعل، وأن يدبر غيرها لها وهي لا تقدر أن تدبر”. فإذا اعتبرنا هاته الأطروحة في الفكر المنهاجي واضحة من حيت المبدأ. فماذا عن تفعيلها من حيث الآليات والبرامج المرصودة على مستوى الواقع؟ هل تجاوزت الجماعة الدونية القطيعية التي رصدها المرشد؟ هل يقبل الاختلاف داخل الجماعة باعتباره النواة الأولى لبناء الشخصية التي لا تنتظر أن يفعل بها بل تفعل، ولا تكتفي أن يدبر غيرها لها بل تشارك في التدبير؟
أما البنيات النفسية فنقصد بها ذاك التداخل بين عالم العاطفة الفطرية وعالم السمو الروحي وبين هذا وتلك عالم الأنانية المستعلية. نطرح السؤال كيف تشكلت البنيات النفسية داخل الجماعة؟ كيف استطاعت أن تتدرج بالعاطفة الفطرية وفق برنامجها التربوي لليقظة الروحية ومطلب الإحسان كما هو مسطر في المنهاج النبوي الذي يمثل صلب تصور الجماعة؟ بالمفهوم العكسيِّ، هل استطاعت الجماعة كبح جماح الأنانية المستعلية التي تكدر صوف العاطفة الفطرية فتعبر بها إلى عالم الصفاء الروحي، أقصد طرق أبواب الإحسان عند الجماعة؟ يقول المرشد عن الأنانية المستعلية : ” يعوق أصحابَها عن اقتحام العقبة امتلاءٌ مما هم فيه وطلب المزيد مما هم فيه، قوم ظلموا أنفسهم وظلموا الناس”.
أطرح هنا السؤال على الجيل الأول بالخصوص، جيل التأسيس، وأقصد جيل 82 إلى 88 بالذات للاعتبارات الآتية:
- الاختلاف الحاصل هو اختلاف بين أعضاء هذا الجيل.
- خصوصية الميزان العمري تجاه هذا الجيل: “المرء وسابقة، المرء وغناؤه، المرء وحظه من الله.”
- انتماء كاتب هذه الأسطر لنفس المرحلة. والذي سنتخذ شهادته وثيقة يوظفها الباحث الأنثروبولوجي للبحث في البنيات. هبها إن شئت انثروبولوجيا على الذات.
- البنيات النفسية
سننظر في هذه الفقرة إلى سؤال التطور الحاصل في البنيات النفسية بالنسبة لأعضاء جماعة العدل والإحسان. كيف تم التطور التدريجي بالعاطفة الفطرية ليحدث الانتقال إلى المطلب الإحساني الذي يعتبر أعز ما يطلب في أدبيات الجماعة على المستوى الفردي. وهل فعلا حصل التطور؟
وبما أن البحث ذو طابع أكاديمي انثروبولوجي ميداني، وبما أنني ابن الجماعة أولا ومن جيل التأسيس ثانيا، سأسمح لنفسي، ملتزما بمبدأ الموضوعية ما استطعت، أن أتكلم بصيغة الشاهد على المرحلة، أعني بالقول، أن العمل أشبه ما يكون بقسط من السيرة الذاتية. فلا يفاجئ القارئ إذا انتقلت من الحديث على الأستاذ عبد السلام ياسين، إلى الحديث عن الإمام الأعظم قدس الله سره سيدي عبد السلام ياسين. أنا هنا عضو شاهد أدلي بشهادتي حول جماعة كانت لي بمتابة الأم الحاضنة وحول رجل هم لي بمثابة الأب، هو سبب الولادة الروحية. وأنا هناك رجل أكادمي لا تربطه بالجماعة والمرشد إلا النظر في النصوص والأداء في الميدان.
أقول جوابا عن سؤال: كيف عرفتم أن مرشدكم من أولياء الله فاتبعتموه لدرجة التقديس؟
الرأي عندي سيدي، أن العديد من الأفراد داخل الصف لم تكن لهم سابقة “علاقة مع الله” و”حيرة السالكين” و”معانات المضطر” و”شوق اللقاء”، لم تثقل كاهلهم أسئلة الدلالة على الله. ما طُرِح لديهم سؤال كيف المسير؟ وما المصير؟ كما كان شأن سيدنا سلمان الفارسي، رضي الله عنه، والعديد ممن سلك طريق “البكاء على الله” قبل أن تتداركه يد “المصحوب الدال على الله” فيسلك طريق “القوم”.
العديد من أفراد الجماعة لم يكن لهم سابقة تأمل في الآفاق وفي الأنفس كمثل سيدنا حمزة رضي الله عنه، كما تروي عنه السيرة مخاطبا الرسول، صلى الله عليه وسلم : “يا ابن أخي يا محمد، عندما أجوب الصحراء بليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربعة جدران”.
ما القصد من هذه المقدمة ونحن نتحدث عن التشكل النفسي؟
رويدك
القصد عندي، أننا في البدايات الأولى للثمانينات لم نكن على بينة من أمرنا، أخذنا الدين عن وُعَّاظ ليس لهم من الزاد المعرفي والفهم سوى آيات من كتاب الله وأحاديث نبوية. غياب شبه مطلق بطبيعة السير التربوي والأخلاقي والتعليمي والسياسي المتكامل. كانت الوهابيةُ وهابياتٍ، عدد توجهاتها بعدد منابرها. الوعاظ ينط بعضهم فوق بعض، والسب أحيانا كثيرة بينهم عملة رائجة، لم يأبهوا بحرمة المساجد فاتخذت المنابر لذاك الجهل سبلا. من هذا الواقع المتردي خلقا، المتدينِ شكلا، وجب الحديث عن النشأة للبنيات النفسية، إن كنا نروم عمق الفهم وفقه التحول الحاصل، هذا التحول الذي انبهرت به العديد من المؤسسات على لسان منابرها الإعلامية.
وسط هذا التيه، سيقرع آذاننا صدع الإمام رحمة الله عليه بكلمة انتقادية توجيهية “قاسية” لخطاب الملك الحسن الثاني رحم الله الجميع. زعزعت الكلمة العالم السياسي، وحوكم الرجل وسجن. في تلك المرحلة الأولى من التزامي لازلت أذكر تلك اللحظات حينما كنت أرافق أخا يوزع مجلتي الصبح والخطاب خفية. بالموازات مع الموقف السياسي، نادى المرشد بصوت هادئ بالرجوع إلى الله، وكان نداؤه هذا غريبا بقدر ما كان فطريا. لم نكن نسمع في المساجد إلى زمهرير جهنم وتصنيف الناس بين كافر ومسلم. نداء الاحسان كان لنا صدمة نفسية لم ندرك أبعاده إلا بعد سنوات.
صدع الرجل بكلمة النقد الواضحة فزعزع الكيان السياسي، وصدع بنداء عاطفي زعزع كيان بنيان “النفوس”، فلفت أنظار العدو والصديق على حد سواء. فاستجاب له العديد من الشباب. لم نعلم حينها، ونحن حوله ومعه وهو فينا (أقصد بفينا فعل الاختراق لا المعية لنفهم البعد النفسي)، أننا أمام “ولي الزمان”، كما يقول أهل التصوف، الدال على الله و”المجدد الأعظم”. ولعل منا من كان يشفق عليه ويقول أنى لهذا المسكين مما يتحدث عنه ومن آمال أسطورية “الإسلام غدا”.
تتالت الأيام والشهور ولربما السنون وأصبحنا نلمس معالم الابوة والعاطفة والرحمة في سلوك الرجل. انقلبت العلاقة من كونها تعاقدا على الجهاد لإعلاء كلمة الله إلى علاقة ملؤها الأبوة والرحمة ونداؤها الجهاد.
هذا تطور جوهري يفهمه جيدا من يبحث في تشكل البنيات وأثر هاته البنيات العاطفية النفسية على السلوك الفردي.
لم نكن نعلم كثيرا عن قوة الرجل الفكرية والروحية. لم نكتشف انه كان نموذجا للعديد من العاملين في حقل الدعوة الا بعد سنوات وبعد تأكيد ذلك عبر شهاداتهم أنفسهم.
شعر الجيل الأول من أبناء العدل والإحسان بدفء الأبوة وحنان المربي وقوة المجاهد، لكن ليس الدال على الله، وأنى لهم بذاك الفهم، ومن منا كانت له مع الله قضية؟ ومن منا فهم يوما أن الله مقصود بالحب. كان معظمنا سلفيا قحا رقيبا على الناس، مصنفا هؤلاء لجهنم وهؤلاء “للحور”. بعبارة أدق كنا لعنة على العباد.
ثم انتقلت مع الأيام الأبوة والحنان إلى علاقة روحية وهبها إن شئت سيدي “صحبة”. دخل الإخوة جلهم تجربة روحية قوية، تُوحِّدُنا غربتنا في المجتمع وهواننا على الناس “خوانجيا”، عكفنا على الذكر الكثير، كنا نجلس الساعات الطوال مستقبلين القبلة نبكي على الله، كان قيام الليل من البديهيات، وصيام الاثنين والخميس مسألة لا جدال حولها، لدرجة نصدم إذا رأينا أخا مفطرا. هذا الإقبال على الأوراد سيحدث انقلابا خطيرا في نفسيات أغلب الإخوان. تواترت الرؤى وتخللها الحضور النبوي. وكنا نكتم كثيرا مما نرى من مشاهدات غيبا وحضورا، ولا نحدث بذلك إلا المرشد نظرا لخطورة المشاهدة، ونظرا لمحور السلفية الذي مثله سيدي محمد البشيري رحمه الله. كنت حينها ممن يكثر زيارة المرشد، بمعدل زيارتين في الشهر، أو زيارة واحدة. كانرحمه الله يسألني عن الجزئيات الدقيقة، كانت له قدرة خارقة على كسر العقبات وتفجير الطاقات من غير وعي المعني بالامر ……
انتقلنا مع الإمام بالتدرج إلى حيث أصبح بالنسبة لنا “شيخا” مربيا أبا روحيا، وهنا يعجز اللسان عن التعبير لتنتقل الصحبة من الحقل النظري الفكري إلى حقل التجربة الذوقية. عاش جيلنا جلال الرجل فكانت الصحبة نتيجة لا سببا.
هذه تجربتي وهذه شهادتي وهنا ستنتهي الرواية لأنتقل من الشاهد إلى الدارس، وإن كانت تجربة على الذات، ولست ممن يخشى عليهم الخلط بين الناقد المتفحص وبين المخندَق سياسيا وإديولوجيا.
كيف نقرأ هذه الشهادة؟ وكيف نربط تفاصيلها وإشكاليةَ الموضوع؟ لم كل هاته التفاصيل؟ وما الغاية؟ وهل يسعفنا الوقت للخوض في كل ذلك؟
أرى أن الذي يبحث في الظاهرة، موضوع النقاش، بمعزل عن علاقتها بالبنيات الذهنية والنفسية، ولا يفهم أبعادها، لن يفهم أبدا السلوك الإنساني على مستوى الواقع. ما السلوك في نظري سوى صورة لما استبطنته النفسيات والعقول. من ليست له القدرة كي يسأل ويسائل نفسه عن البديهيات كيف نشأت ومما نشأت وهل هي فعلا بديهيات أم أوهام؟ وما أخطر البديهيات على السير، من لم يسائل نفسه عن سر اطمئنان قلبه، عن سر قوة موقفه، عن سر راحة باله، لن يفهم أبدا مناجاة الفريق المنادي بالوارث.
إذا تأملنا كلام الشاهد المنبهر بإمامه، واعتقاده في كمال إمامه، وتشكل نفسيته من خلال تدرجها في مسلك إمامه سنفهم العديد من الإشارات التي من شأنها أن تحل لغز تلك الاصطدامات التي أنتجها كتاب محمد العربي.
الذين يتحدثون عن الوارث، في نظري، ينطلقون من نظرة استرجاعية (Retrospective) لاستشراف المستقبل. من يبحث عن الوارث يتساءل عن أجيال لن تحضى بما حضي به الجيل الأول من توجيهات يرى قوتها في الشيخ لا في الزاوية؛ بتعبير آخر، وبالنسبة لجماعة العدل والإحسان تكون المقابلة : في المرشد لا في الجماعة. كانت الجماعة في عهد الجيل الأول ضعيفة كما يقول الشاهد، لكن الأب الروحي استطاع بالتدرج أن ينقلهم إلى درجة العزة بسمو قدره، ومن ذاك السمو اكتسبوا القوة. فهم به صاروا فرسانا لا بالجماعة. ما كانت الجماعة إلا حضنا ومحضنا تتم فيه عملية التغيير. فرق شاسع إذن بين من يعتقد جازما أن عملية التغيير تمت بفعل المَصْنَع وبين من هو في يقين أن الأمر كان بفعل الصانع داخل المصنع.
نفهم من الشهادة إذن أن من يتحدث عن الوارث يبحث عن الصانع عن رجل تعاد به الكرة من جديد لصناعة الاجيال القادمة. رجل تعاد به صياغة الإنسان من جديد.
المطالبون بالوارث، في حاجة هم إلى رجل تهد الجبال هدا ولا يتحرك قلبه. رجل تفزع فيه قلوب الرجال ولا يفزع قلبه. رجل يكون لهم أبا وجامعا ومحتضنا وحاسما ومربيا على غرار النموذج الأول ……
ونتساءل عن مشروعية الطلب. هل هذا المطلب المنادي بالوارث الحي مطلب مشروع نظريا؟
هل هو مطلب عقلاني موضوعي أم عاطفي حالم حائم في أماني معسولة؟
ما انعكاساته على الجماعة إن هي تبنته ودعت إليه؟
ما آلياته ؟
كيف تصريفه؟
هل هنالك تعارض بين الطرفين؟
هل هنالك تكامل ولقاء وجسر للتواصل؟
نترك الجواب إلى حينه.
هذه نظرة موجزة عن منهج التلقي، العاطفي الروحي التربوي، كيف كان بالنسبة للجيل الأول؟ نظرة،إن شئت قل، عن سر الاطمئنان وقوة الموقف وثبات الخطى للجيل الأول.
نجيب عن هذاالكم من الأسئلة بعد إلقاء الضوء عن تشكل البنيات الذهنية، أي كيف تشكل نمط التفكير عند أهل العدل والاحسان؟
أعتبر هذا الجزء حلقة في سلسلة حول موضوع الصحبة والجماعة وارتباطها بالبنيات النفسية والذهنية لجماعة العدل والإحسان. حوارات فكرية هادئة هادفة لتفعيل إعمال العقل في قضايا لا يجب أن تترك حكرا على فئة دون فئة كيفما كانت حيثياتها الروحية أو التنظيمية. دفعا لعقلية القطيع وتحريرا للعقل من طوق الوصاية والتقليد بدعوى السلوك.