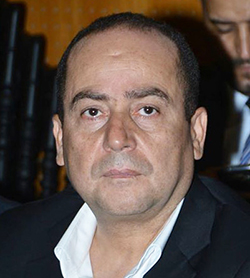بنبركة .. رجل البناء الحزبي

(المهدي بنبركة ومهمة بناء حزب عصري يساري)
آراء أخرى
المهدي بنبركة شخصية متعددة الأبعاد، اجتمع فيه ما نَدُرَ أن يجتمع في شخصية سياسية عادية. والسر في ذلك أن المهدي كان شخصية سياسية استثنائية بامتياز. كان رجل الفكر ورجل التنظيم. كان زعيماً وطنياً كبيراً وقائداً أممياً فذاً. كان يجمع بين رسم المهام الاستراتيجية وتدبير المهام الظرفية. كان يضع قدميه بثبات على أرض الحاضر ويستشرف، بفكره وحركته، أفق المستقبل، يمسك بتلابيب الواقع ولا يتنازل عن حق الحلم. كان يجيد فن صنع المنافذ والمسالك المتعددة لتصريف الفكرة ويصنع، في قلب أكثر المؤسسات محافظة وجموداً، حيزاً للتحفيز على التغيير ولزرع بذور التحديث. كان يرى أن أية حركة سياسية، كالحركة الاتحادية، لا يمكن أن تعفي نفسها من واجب تحديد صيغة الجواب على السؤال التالي : من نحن؟ وماذا نريد؟ ومن هم خصومنا؟ وماذا يريدون؟ كان رجل دولة وكان يحسن مخاطبة عموم الشعب بدون ابتذال أو سطحية أو تملق أو مجاراة للغرائز العمياء. وحين نفته السلطات الاستعمارية، بعيداً عن الرباط، في الجنوب الشرقي، انخرط بهمة ونشاط في تعلم اللغة الأمازيغية لتطوير أدوات تواصله اللغوي مع مختلف فئات الشعب. كان حاد الذكاء، دائب الحركة، فائق الحيوية، ذا غزارة في إنتاج الأفكار ومهارة في صناعة المشاريع وهندسة المبادرات.
المهدي بنبركة هو أحد أبرز رواد بناء التجربة الحزبية العصرية اليسارية في المغرب. هذه التجربة تجسدت، عملياً، من خلال ثلاث مدارس :
– مدرسة التنظيم اليساري المغربي المتفرع عن الحركة الشيوعية العالمية، وامتازت بالوضوح والصفاء الفكري وشجاعة طرح أفكار ثورية لم تُطرح من قبل؛ لكن أحد هواجسها الأساسية كان هو مغربة التشخيص المحلي للتنظيم الشيوعي، وتجنب السقوط في أسر الأطروحات التي لا تلائم الواقع السياسي والاجتماعي في البلاد مثل أطروحة تأجيل طرح قضية الاستقلال الوطني في انتظار انتصار القضية الطبقية لدى البلد المُسْتَعْمِرِ؛
– مدرسة التنظيم اليساري المغربي المتفرع عن الحركة الوطنية، وامتازت بقاعدتها الجماهيرية وكارزمية قادتها وقوة تأثيرها وفعلها؛ لكن أحد هواجسها الأساسية كان هو التحرر من بعض تقاليد العمل الوطني التي من شأنها أن تشكل كوابح في وجه تعميق البعد اليساري للحزب؛
– مدرسة التنظيم اليساري المتفرع عن حركة اليسار الجديد، وامتازت بحسها النقدي ونجاحها في تعبئة فئات واسعة من الشبيبة التعليمية وبملاحم التضحيات البطولية التي خاضتها؛ لكن أحد هواجسها الأساسية كان هو ضمان القدرة على التجاوز الفعلي، وليس النظري، لأخطاء المدرستين السابقتين.
انبثاق تنظيم الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، بقيادة المهدي بنبركة، جرى، في البداية، تحت شعارات متعددة منها شعار حمل قدراً من الغموض، وهو شعار “لا حزبية بعد اليوم”، مما يدعو إلى طرح سؤال مشروع حول ما إذا كانت وظيفة التنظيم الوليد هي بناء حزب يساري عصري يتجاوز ثقافة المحافظة التي تسكن جزءاً من النخبة الاستقلالية أم هي تأسيس تحالف وطني واسع يروم الإشراف على وضع قواعد البناء الجماعي لدولة الاستقلال. لقد كان واضحاً، إذن، أن المكونات الثلاثة، على الأقل، التي سيتألف منها الاتحاد، وهي المقاومون والنقابيون والأطر السياسية، كان يجمعها الحرص على ألا يؤول تدبير الدولة إلى أيدي الجهات التي تمثل امتداداً للاستعمار والرجعية والإقطاع.
كان بناء حزب عصري، في نظر بنبركة، يعني القطع مع ثقافة الزوايا وآثارها في الحقل السياسي، واعتماد الوضوح في تحديد الوظائف، وضمان حقوق الأعضاء كاملة، ورفض تقديس القادة أو عبادة الشخصية، وممارسة النقد الذاتي، وعدم اختزال الحزب في منشطين يتولون قراءة “النشرة” على القاعدة “الشعبية” التي تحضر اجتماعات الخلايا وتكتفي بتلقي التعليمات وتنفيذها؛ والعمل، بدلاً من ذلك، على أن تُماِرس هذه القاعدة، نفسها، حق التقرير ومراقبة عمل الأجهزة الحزبية وأن يتم التخلي عن الطابع المركزي في التسيير المفروض عبر نظام صارم للمفتشين. لقد شكل ميلاد الاتحاد ثورة على هذا النظام الوصائي إلى درجة أن آثار هذه الثورة قادت، أحياناً، في ما بعد، إلى نوع من اللامركزية المفرطة وتشتيت الجهود وتعدد المبادرات الفردية المتضاربة الأهداف وإلى قيام ازدواجيات تنظيمية.
وكان بناء حزب عصري، يعني، أيضاً، أن يتمتع الأعضاء بكامل حقوق العضوية فيه، فلا يكون هناك تفوق غير مبرر لجيل على جيل، أو لوجهاء على عامة الشعب، أو للماضي على الحاضر والمستقبل، أو لرجال الفكر على فئات أمية وفئات متواضعة التعليم، أو لزعماء مقررين على ما يشبه “اليد العاملة” الحزبية.
ولعل المتتبع الموضوعي يمكنه أن يتساءل عن سر انخراط بنبركة في حركة الانفصال عن حزب الاستقلال، وهو الرجل الذي كان يبدو، بحق، بمثابة “دينامو” بالنسبة إلى الحزب والماسك بناصية آلته التنظيمية الضخمة. ولعلنا نجد الجواب، ربما، في كون تدبير الانتقال إلى نمط حزبي جديد، من داخل الحزب الأم، كان يتطلب كلفة باهظة على مستوى الزمن، والزمن لا يرحم، والمعركة السياسية التي ستمكن الشعب من تقرير مصيره لا تسمح بالانتظار وإضاعة المزيد من الوقت؛ هذا، فضلاً عن كون الانشقاق كان يُنْظَرُ إليه على أنه عملية عمودية وليست أفقية، وأنها ستجعل الزعماء المحافظين، في النهاية، بلا قاعدة، تقريباً، لأن مصلحة وطموح هذه الأخيرة سيجعلانها تختار الانظواء تحت لواء الكيان الحزبي الجديد.
ولقد كان بناء حزب يساري، في نظر بنبركة، يعني استيفاء مجمل المواصفات التنظيمية للحزب اليساري، أو حزب الجماهير، كما حددها موريس دوفيرجي، والتي نجدها واردة ومحددة المضمون من خلال وثيقة “الاختيار الثوري” وأعمال أخرى للشهيد وهذه المواصفات هي :
• تبني الاختيار الاشتراكي : لقد أكد المهدي استحالة إنجاز تنمية حقيقية في إطار الاقتصاد الليبرالي، فمشكلة التنمية، هي، أولاً وقبل كل شيء، مشكلة سياسية، ولا يمكن ضمان الوصول إليها بدون استثمار أمثل للموارد الوطنية وتثمين قيمة العمل. ونَبَّهَ بنبركة إلى أن هناك أنظمة ترفع شعارات اشتراكية ولكنها في العمق مجرد أنظمة شبه فاشية أو إقطاعية أو عميلة للاستعمار؛ لذلك يجب ألا ننخدع بالشعارات، ويجب إدراك ضرورة بلورة التوجه الاشتراكي في برامج مرحلية مُمَهِّدَةٍ للاشتراكية؛
• اعتماد المركزية الديمقراطية في البناء التنظيمي : فهذا البناء يجب أن يضمن التوفيق بين المركزية والديمقراطية، في آن واحد، وأن ينظم الأعضاء في خلايا القاعدة وفق معيار السكن، في الأحياء والقرى، أو معيار العمل، في المؤسسات الصناعية والفلاحية.
وبما أن جوهر التنظيم الحزبي هو التناسل، فإن المهدي كان يولي أهمية خاصة لتنظيم الشباب، ويحرص على اجتذاب الأطر والكفاءات الفتية للعمل الحزبي، فكم من الرموز الأساسية للنضال اليساري المغربي، كان بنبركة، شخصياً، هو أول من فاتحها في أمر الانخراط في الحياة الحزبية؛
• التمييز، في وضع البرامج، بين الأهداف البعيدة والأهداف القريبة : يعتبر المهدي بأن المرحلة، التي تعقب الاستقلال السياسي، تقتضي من أية حركة ثورية أن تضع برنامج حد أدنى يجمعها مع مختلف القوى السياسية ويروم تحقيق الديمقراطية وحل مشكل الحكم وذلك للانتقال، لاحقاً، إلى مرحلة تحقيق الأهداف الثورية؛
• تحديد دور الحزب في علاقته بالنقابات والمنظمات الجماهيرية : يجب، حسب المهدي، أن يتولى الحزب حمل “بوصلة” النضال السياسي الشامل والإشراف على صهر مختلف النضالات النقابية وأنشطة المنظمات الجماهيرية وحركات الشباب في بوتقة دينامية شاملة، وتنظيم العمال، سياسياً، في الحزب ومحاربة دعوات إبعادهم عن السياسة وشل المناورات الهادفة إلى فصل النضال النقابي عن أفقه السياسي؛
• التثقيف الإديولوجي وتكوين الأطر : ما يجمع مناضلي الحزب اليساري ليس هو مهام ظرفية ومواقف وانفعالات عاطفية، بل ما يجمعهم هو تربية وتثقيف إديولوجي يجعلهم يدركون القوانين العلمية لتطور المجتمع والأهداف الاستراتيجية لحزبهم وارتباطها بالأهداف الكبرى للثورات الاشتراكية والتحررية عبر العالم ويستفيدون، في ذلك، مما تزخر به ثقافتهم المحلية، العربية الإسلامية مثلاً، من قيم تقدمية؛
• إنجاز المبادرات على الأرض والارتباط بالجماهير : الحزب اليساري ليس مجرد آلة انتخابية تنشط موسمياً، إنه يمثل طليعة نضال فئات واسعة من الجماهير، يقود حركتها وينظم صفوفها ويحركها في اتجاه تأمين مستقبلها وتحرير طاقاتها ويعيش قريباً منها وينشغل، دوماً، بتتبع أوضاعها، في مختلف المواقع والحلبات، ويرعى مسار فعلها ويدبر طرق إسماع صوتها والدفاع عن مصالحها.
كان رجل دولة وكان يحسن مخاطبة عموم الشعب بدون ابتذال أو سطحية أو تملق أو مجاراة للغرائز العمياء. وحين نفته السلطات الاستعمارية، بعيداً عن الرباط، في الجنوب الشرقي، انخرط بهمة ونشاط في تعلم اللغة الأمازيغية لتطوير أدوات تواصله اللغوي مع مختلف فئات الشعب
إذا كانت سنة 1959 قد شهدت انبلاج مسلسل بناء الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ككيان حاول، تدريجياً، ترجمة الفكرة الحزبية العصرية اليسارية، التي شكلت مركز انشغال المهدي، إلى أرض الواقع، فإن عام 1965 سيشهد اكتمال الملامح التنظيمية للحزب، مسطرياً، من خلال المذكرة التنظيمية التي وضعت قواعد النظام الداخلي لحزب ينتظره صراع طويل مع الاستبداد. وفي الذكرى العاشرة لاختطاف المهدي، كان رفاق دربه قد عقدوا، بنجاح، مؤتمرهم الاستثنائي الذي قَدَّمَ العناصر الضرورية لتأمين وضوح الاختيار الإيديولوجي، ورَسَمَ استراتيجية النضال الديمقراطي، وحسم أمر الوحدة التنظيمية بحيث لم يعد حَمَلَةُ المشروع الحزبي، الذي بَشَّرَ به المهدي، مجرد “جناح” ضمن حركة تتعدد داخلها الولاءات والتكتلات والمبادرات.
واليوم، بعد محطتي 1959 و 1975، وفي الذكرى الخمسين لاختطاف أحد بناة اليسار المغربي، تبدو الحاجة ملحة ، ربما، إلى تدشين مرحلة ثالثة، بهدف إخراج اليسار المغربي من الهوة السحيقة التي وقع فيها، ولن يتأتى ذلك، في نظرنا، إلا من خلال عملية شاملة لإعادة البناء تزود الشعب المغربي بيسار مجدد ومبدئي وأخلاقي وتعددي ومستقل في قراره، حتى لا يظل جزء أساسي من القاعدة الحزبية المفترضة لليسار، مكتفياً، فقط، بالتعبير عن الرأي السياسي من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، أو مكتفياً، فقط، بالاندماج في المبادرات ذات البعد السياسي التي يطلقها المجتمع المدني أحيانا.
وكرأي شخصي، يحتمل الخطأ أو الصواب، نقول إن عملية إعادة بناء اليسار تتطلب، ربما، النهوض بسلسلة من الالتزامات، منها على وجه الخصوص :
أولاً – تقديم عرض سياسي جديد : إن مشكلة اليسار ليست، فقط، مشكلة بلقنة، حتى يمكن التغلب عليها بتكتيل أو تجميع الهياكل القائمة بأسمائها ومسمياتها، وليست مشكلة تواصل أو ضعف في تسويق المشروع أو خصاص في الوضوح الإيديولوجي. إنها مشكلة نخب وتعهدات لم يتم الوفاء بها، واستسلام لحالات من الضعف الإنساني. ولذلك يتعين البدء بإنجاز توافق على أرضية نضالية تعيد الاعتبار للسياسة كتعاقد وكخدمة نبيلة، وتضع حداً لسنوات من الغرق في مستنقع البراغماتية المطلقة وخدمة الاستراتيجيات الفردية والتسامح حيال طبيعة الوسائل المستعملة وانتظار الإشارات؛
ثانيا – الاعتراف الجماعي بالأخطاء : علينا الإقرار بأننا أضعنا سلسلة من الفرص التاريخية ودخلنا تسويات قَوَّتِ السلطوية عوض أن تضعفها وسمحت لها بفتح أقواس وإغلاقها، وتنازلنا عن مطالب ديمقراطية أساسية. المسؤولية عن الأخطاء قد تكون متفاوتة ولكنها، في كل الأحوال، جماعية، ولا مجال للتشفي أو السقوط في ردود فعل حاقدة وانتقامية. جزء من اليسار فشل في تحويل “التناوب التوافقي” إلى انتقال ديمقراطي وانتهى به المطاف، في ما بعد، إلى قبول المشاركة في الحكومة من أجل المشاركة، فقط، وفي خضوع شبه تام لبرامج الآخرين. وجزء آخر من اليسار فشل في خلق البديل ولم يتجاوز، كثيراً، حدود نقد تجربة الجزء الأول؛
ثالثا – الثقة في الشباب وفي المستقبل : أبان حراك السنين الأخيرة أن مجتمعنا يزخر بطاقات شابة مبدعة في السياسة وذات اقتدار وإقدام وحصافة. والمفروض أن حكمة الرموز التي قادت المراحل السابقة، بنجاحاتها وإخفاقاتها، ستدفعها إلى جعل مساهمتها، في عملية إعادة البناء، قائمة، أساساً، على التبريك والدعم والتحفيز، وإفساح المجال أمام الأجيال الجديدة لتتولى هذه الأجيال، نفسها، قيادة مسلسل الانطلاقة اليسارية الجديدة؛
رابعاً – التمسك بالتواضع : وهذا يعني أن أي إطار تنظيمي من الإطارات القائمة لا يمكن له أن يدعي بأنه هو من سيتولى الإشراف على عملية إعادة بناء اليسار وبأن “الوحدة” المرتقبة ستتم داخله. هناك حاجة، ربما، إلى تجميع البُنَاةِ المتطوعين مع عُدَّةِ وعتاد البناء في عنوان جديد يصبح قبلة لاحتشاد النشطاء المدنيين والفعاليات التقدمية الحية والمناضلين المسكونين بهاجس صيانة نقاء الفعل السياسي والملتزمين بالمثال اليساري وبالقواعد المتعارف عليها، عالمياً، لتنظيم المنافسة الديمقراطية وتغليب المصلحة العامة؛
خامساً- الدفاع عن الاختيار الثالث أو الطريق الثالث : أي ارتضاء التعبير عن الفئات من الشعب المغربي، وما أكثرها، التي لا تجد نفسها :
– في مشروع اليمين الأصولي المحافظ الذي يرفع شعار الإصلاح، وقد ينجح في اتخاذ إجراءات إصلاحية محدودة ولكنه، في العمق، يكرس الجمود الفكري والديني ويمنح السلطوية كل ما تريد من أدوات قانونية ومؤسسية لخنق الأنفاس وقمع الحريات، مقابل منافع ذاتية لحزبه، ويُبْقِي على استعمال الوصفات القديمة في معالجة مشاكل المغرب الكبرى رغم فشلها في الماضي، ويتعمد الامتناع عن بذل أي جهد يضمن تقدم المجتمع، طمعاً في أصوات انتخابية زائدة، ويستمر في طرح تعارض مفتعل بين الهوية الوطنية والدينية، من جهة، والقيم الإنسانية، من جهة ثانية، ويمارس الاستعلاء وبيع الأوهام والجمع بين المتناقضات.
– ولا في مشروع تجديد السلطوية والتحكم، الذي يرفع شعار الحداثة، وقد يظهر بمظهر المدافع عن بعض مظاهرها المحدودة، ولكنه، في العمق، يتجاهل جوهرها السياسي ومتطلباتها المؤسسية والأخلاقية ويتصرف على وجه مخالف لها ويحولها إلى مجرد سلاح تاكتيكي لمحاربة الإسلاميين فقط، ويمارس معارضة لامسؤولة ومتحاملة، ويمنح نفسه، أو يقبل بأن يُمنح، امتيازات مخلة بمبدأ التكافؤ في الفرص بين الفرقاء السياسيين؛
سادسا- النضال من أجل إرساء نظام الملكية البرلمانية، الآن، ورفض أي مشروع لتأجيل أو تعليق أو تقسيط الديمقراطية أو لاعتبار الاستقرار الهش بديلاً عنها؛
سابعا- محاولة تشخيص روح حركة 20 فبراير، كما تجلت في مبادرات نواتها الأصلية، عبر العمل على رفع الوصاية عن الشباب، والاستمرار في هدم جدار الخوف وجدار الصمت، واحترام ذكاء المواطنين، ورفع وتيرة النضال ضد الفساد والاستبداد وضد استعمال السلطة في خدمة الثروة، والاستفادة من تجربة الحركة وفتح المسالك القادرة على ضمان امتداد روح الحركة إلى أكثر ما يمكن من الحقول والميادين والمؤسسات؛
ثامنا- ضمان نظافة الوسائل في السياسة : وذلك من خلال الحرص على تجنب استعمال الوسائل المخالفة للمبادئ الأخلاقية ولمنطق السياسة كخدمة عمومية وآلية تعاقدية. ولهذا، يتعين رفض جلب أعيان الانتخابات المنحدرين من أحزاب إدارية، ورفض خطط الحصول، بأي ثمن، على أكثر ما يمكن من المقاعد، ورفض احتياز امتيازات غير مستحقة أو المس بحقوق الآخرين أو القيام بتحالفات هجينة أو التطبيع مع الأحزاب الإدارية قبل حصول مؤشرات ملموسة على طي صفحة ماضي هذه الأحزاب من خلال مسلسل للحقيقة والاعتذار وجبر الأضرار وتقديم ضمانات على عدم تكرار الانتهاكات التي تورطت فيها الأحزاب المعنية واستبعاد مشاريع التحكم من أعلى في الأحزاب وسياسة إرشاء النخب؛
تاسعاً : احترام المعايير المتعارف عليها، في المجتمعات الديمقراطية لشغل موقع المعارضة أو موقع المشاركة، وذلك بربط هذه الأخيرة بضرورة توفر أغلبية منسجمة ومتفقة، مسبقاً، على برنامج مشترك، معلن عنه قبل الانتخابات، ودستور يمنح الحكومة وسائل تطبيق برنامجها ويضع القرار بين أيدي المنتخبين حتى يُضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى أساس أن يشخص البرنامج المطبق على الأرض التوجه التقدمي اليساري وألا يتم، في الممارسة، تجاهل الشعارات السابقة وأن يتم القطع مع تسييد “برنامج الدولة القار”.
قرار المشاركة أو المعارضة يحسم فيه الناخب ويُستخلص من المنطق الموضوعي لخريطة النتائج. وإذا فرض الناخب على اليسار أن يبقى في المعارضة، فيتعين أن يمارسها بحس أخلاقي وبروح المسؤولية، متجنباً سلوك التحامل ومتتبعا لكل حقول اتخاذ القرارات التدبيرية ورافضاً تحويل المعارضة إلى أداة في خدمة مراكز النفوذ؛
عاشراً- بناء حزب من طراز تنظيمي جديد : حزب يعترف بالتيارات ويقبل بتعايش الرأي والرأي المخالف، داخله، ويمنح أعضاءه ضمانات بأن اللوجستيك الحزبي لن يُوضع في خدمة طرف دون طرف، ويقبل بنوع من الرقابة الخارجية على تدبير مساطر مؤتمراته وسلامة سير التباري الداخلي.