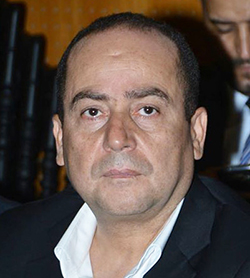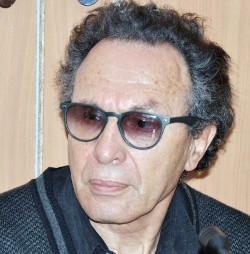
مسئولية اليسار الديمقراطي الراديكالي في ظرفية الانتخابات البرلمانية القادمة..
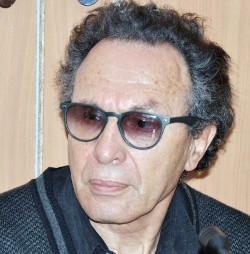
مكونات اليسار بمختلف تياراتها و المناضلات و المناضلين اليساريين لهم غالبا موقفا سلبيا من واقع الانتخابات في المغرب بالنظر لتجاربهم المريرة و لكون الانتخابات في لمغرب لا تشكل بالنسبة للشعب المغربي لحظة سياسية متميزة و لحظة وعي عالي و مكثف بمصيره الإنساني و بمصالحه الديمقراطية الاجتماعية والسياسية و الاقتصادية والثقافية.. فالانتخابات بالفعل لا تشكل لحظة نوعية يرتفع فيها مستوى الوعي و النقاش السياسي إلى تقييم و تحليل أسباب الإعاقات الثقافية و الاجتماعية و السياسية التي تعيق تقدم الوعي الديمقراطي السياسي و الاجتماعي.. و هذا الواقع يعيق اكتساب وعي و ممارسة حقوق المواطنة كاملة لدى غالبية المواطنين والمواطنات.. وواقع الوعي الديمقراطي ووعي المواطنة في البادية والأحياء الشعبية/أحزمة الفقر في المدن لا زال متدنيا. فالانتخابات في المغرب تشبه الواقع السياسي المتخلف السائد كما تشبه الوعي و الثقافة الاجتماعيين السائدين في المجتمع.
آراء أخرى
وهذا ما يجعل “جرة النخب المُنـْـتَـخَـبـَة و أحزابها تَسْلـَمُ في كل مرة” و يتناسى المواطنون و المواطنات الناخبين وعود جل الأحزاب و نخبها المحلية والبرلمانية و خطابها الانتخابي المدافع عن مصالحهم و تتبوأ مرة أخرى نفس الأحزاب و نفس النخب تقريبا مراتب متقدمة في الانتخابات.
وفي المقابل يلجأ المواطنون و المواطنات، الذين حصلت لديهم قناعة بعدم أهمية الانتخابات و نخبها في حياتهم و حياة الشعب في تغيير الواقع نحو الأفضل ديمقراطيا و إنسانيا و في العلاقات الأجتماعية، إلى مقاطعة الانتخابات أو اللامبالاة بالنظر لتدني مصداقيها و و استمرار مظاهر تخلفها. و هذا ما جرى خلال انتخابات 2007 البرلمانية (نسبة المشاركة لم تتجاوز37 %) و الانتخابات المحلية و لا تتجاوز المشاركة فيها أقل من نصف أو نصف المسجلين و المسجلات في اللاوائح الانتخابية.. و إلقانظر سريعة على واقع مشاركة المزاطن/المواطنة في الانتخابات توضح ذلك.. سنة 2002 الانتخابات البرلمانية نسبة المشاركة (52 %)، انتخابات 2007 البرلمانية كانت النسبة 37 % ، انخابات 2009 المحلية 52.4 %.. أما 2011 في 25 نوفمبر التي جاْت بعد انتفاضة حركة 20 فبراير دامت شهور و صوت حسب أرقام وزارة الداخلية للدستور الجديد فلم تحقق نسبة المشاركة في الانتخابات كانت 45 %.
مع العلم أن أكثر من 40 % ممن لهم 18 سنة و ما فوق غير مسجلين في الانتخابات حسب الإحصائيات. و هي إشكالية مرتبطة بالنسق السياسي و الثقافي وبتدني الوعي السياسي لدى أغلب الناخبات و الناخبين و سيطرة الثقافة المحافظة و المتخلفة والعصبية القبلية.. إضافة إلى أن الانتخابات تجري في واقع يتسم بسيادة خطاب و ممارسة شعبويين و بممارسات انتهازية/ من جهة من طرف فئات شعبوية غير واعية بالرهانات الإنسانية و السياسية و الديمقراطية للانتخابات و تعتبرها فرصة لربح بعض المال.. و من جهة أخرى تستغل نخب سياسية و اجتماعية الوضع المتخلف لطبقات و لفئات شعبية لاستلاب أصواتها.
عدة عوامل أساسية (facteurs fondamentaux) تترك هذا الواقع الانتخابي و مظاهر تخلفه في المغرب مستمرا و لا يحدث تظور نوعي ينتقل بالدولة و المجتمع و الـْمُوَاطـَـنَة إلى دولة و مجتمع و مُوَاطـَـنـَة الديمقراطية.
* العامل الأول:
تحكم إدارة و أجهزة و مؤسسات الدولة المخزنية و أداتها التنفيذية وزارة الداخلية سياسيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا في الانتخابات و في أغلب نخبها، لأن الدولة المخزنية و أجهزتها لا زالت تعتبر الانتخابات أسلوبا لإدماج النخب السياسية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية في النسق السياسي المخزني و خصوصا النخب المُعَارِضَة المُطـَالِبَة بديمقراطية حقيقية تتحقق فيها المصالح الديمقراطية للشعب.. هذا التحكم في الانتخابات يهدف بطبيعة الحال لاستمرار تحكم النسق السياسي للمؤسسة المخزنية و مصالحها و مصالح تحالفها الطبقي الكمبرادوري في الوضع السياسي و المصالح الاقتصادية و في المجتمع لفرض سيطرته.
* العامل الثاني:
ضعف و تدني الوعي السياسي الديمقراطي المرتبط بالمصالح الاقتصادية و الاجتماعية لذى أغلب الأوساط الشعبية، خصوصا في البادية و أحياء الفقر والهشاشة في المدن..
و مع ذلك لا بد من الإقرار بأن التنمية الاقتصادية هي، جدليا، عامل أساسي للتنمية الاجتماعية.. و تشكل التنمية الاقتصادية للفئات الاجتماعية التي تعاني الفقر والهشاشة الشرط الأول الأساسي لتنمية وعيها و سلوكها و واقعها الاجتماعي.
ونعي جيدا أن تخلف الوعي ليس مرادفا للفقر، كما أن الفقر لا يعني تخلف الوعي الاجتماعي. إذ نجد بلدانا بترولية غنية (عربية و إفريقية و أمريكالاتينية..)، وهذا لا يعني أنها متقدمة اقتصاديا، لكن مجتمعاتها، كالبلدان المتخلفة و الفقيرة اقتصاديا، تعاني نسبيا تخلف الوعي السياسي و الاجتماعي حيث نجد نسب كبيرة من الأمية و سوء التغذية و البطالة و هشاشة الشغل و سيطرة اقتصاد الريع و تشغيل الاطفال و تزويج الطفلات القاصرات و احتقار المرأة و النزاعات الاجتماعية حول مشاكل تافهة أمام المحاكم و تدني الوعي المدني و اللا مبالاة..
في مثل هذا الواقع تعيش أغلب الفئات اجتماعية مغربية التي لم تتحرر بعد من الثقافة الشعبوية و سلوك و ثقافة “هَادْ الشـِّي اللـِّي عْطَى الله” و ثقافة العجز الفعل الملموس لتغيير هذا الواقع المتخلف و الانتقال إلى واقع متقدم أفضل وعيا و سلوكا. و بالتالي تحمل هذه الفئات الاجتماعية نفسها مسئولية تخلف وعيهم و ممارستهم.
* العامل الثالث
النخب السياسية و الاجتماعية الديمقراطية و اليسارية لم تستفد، منذ عقود، من أخطاء ممارستها السياسية و ممارستها التنظيمية.. و المتمثلة أساسا في أن لا أهمية للأجهزة و للتنظيمات و للإطارات السياسية و النقابية و المدنية التي تشكلها و تشتغل سياسيا بها إذا استمرت ممارستها لا تتجاوز اجتماعات المكاتب والأجهزة المغلقة و صياغة البيانات و توزيعها.. و إذا لم تتخلص من انتهازية نخبها التي لا تحسن سوى أساليب الارتقاء السياسي و الاجتماعي بعيدا عن هموم و معاناة عامة الشعب المغربي و عن الواقع الملموس لمعيشه اليومي. إذ لا زالت منهجية عملها تعتمد على طبقة البرجوازية المتوسطة المتعلمة أو العالية التعليم.
أكثر من 40 % ممن لهم 18 سنة و ما فوق غير مسجلين في الانتخابات حسب الإحصائيات. و هي إشكالية مرتبطة بالنسق السياسي و الثقافي وبتدني الوعي السياسي لدى أغلب الناخبات و الناخبين و سيطرة الثقافة المحافظة و المتخلفة و العصبية القبلية
فالقوى السياسية اليسارية و الديمقراطية، أي الشرط الذاتي للتغيير الديمقراطي، لم تكن تبلور أسس فكرية و سياسية ديمقراطية موحدة و لم تبلور برنامجا سياسيا ديمقراطيا يتجاوز المصلحة الذاتية و الحزبية الضيقة، رغم عدة محاولات باء أغلبها بالفشل (الكتلة الديمقراطية، تجمع اليسار الديمقراطي، الائتلاف من أجل الديمقراطية على إثر تبلور حركة 20 فبراير..). و بالتالي لم تُـؤَهـِّـل القوى الديمقراطية و اليسارية خطابها و تنظيماتها و ممارستها لربط نضالها السياسي الديمقراطي بالنضالات العمالية و الشعبية و الجماهيرية وتنظيمها وتوجيهها لقيادة التغيير الديمقراطي الجذري.
و بالتالي استمرت أزمة القيادة الديمقراطية واليسارية وأزمة مشروعها و برنامجها الديمقراطي و أزمة ارتباطها بالطبقات الشعبية التي لها مصلحة في التغيير الديمقراطي.. و ترجع في اعتقادنا هذه الأوضاع الذاتية المأزومة إلى ضعف الكفاءة السياسية و التنظيمية و غياب أساليب العمل الناجعة و ارتهانخطها السياسي و نضالها الجماهيري، على قلته، بتحسين وضعها في المؤسسات السياسية للنظام السياسي، غير مبالية ببناء قاعدة الجتماعية شعبية ديمقراطية وتسلسحها بالثقافة المدنية و بالوعي السياسي الديمقراطي و بالممارسة الديمقراطية.
*
هذا الواقع و هذه العوامل وضحا أن التجارب الانتخابية التي مرت في المغرب أن الانتخابات، بالنسبة للنظام السياسي، ليست سوى لحظة سياسية زائلة (éphémère)، تعلن فيها الأحزاب على برامج و تصورات و أرقام اقتصادية.. لا يمكن الالتزام بها في ممارسة مسئوليات الجماعات المحلية و الجهوية و الصلاحيات البرلمانية و الحكومية. فتجارب الجماعات المحلية و التجارب الحكومية و البرلمانية أظهرت أن الأحزاب تفشل في تحويل برامجها السياسية و الانتخابية المعلنة إلى إنجازات ملموسة في الواقع و المجتمع، و تجد هذه الأحزاب نفسها تطبق برنامج المؤسسة الملكية التي لها أوراشها و برامجها و مبادراتها و صناديقها المالية لإنجازها. و غالبا ما نسمع المواطنين و المواطنات يرددون “الملك هو الذي أنجز و حقق كل شيئ..!!” و يرجع ذلك لكون الفصل 49 من دستور 2011 الذي يرأسه الملك المجلس الوزاري (أي لا قرار سياسي و اقتصادي و اجتماعي يمر للتنفيذ دون موافقة الملك) بالنظرلاختصاصات المجلس الوزاري الذي يقرر في قضايا التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة ومشاريع مراجعة الدستور ومشاريع القوانين التنظيمية والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية ومشروع قانون العفو العام ومشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري وإعلان حالة الحصار.. إضافة إلى وجود الأمانة العامة للحكومة يدبرها الامين العام للحكومة معين من طرف الملك و هو ممثله داخلها.. و هذا يعني أن المبادرات و القرارات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية الكبرى تطرحها و تنفذها المؤسسة الملكية حتى من دون الرجوع إلى البرلمان و الحكومة.
ولم يشهد المغرب، منذ حكومة عبد الله إبراهيم التي استمرت سنة ونصف (4 ديسمبر 1958 إلى أن تم إسقاطها 21 ماي 1960)، حكومة لها إرادة لممارسة صلاحياتها كمؤسسة تنفيذية و إرادة استقلال قرارها السياسي عن المؤسسة المخزنية.
وبالتالي تسود في المغرب تسود ديمقراطية شكلية، تصبح معها مؤسسات البرلمان والحكومة والقضاء إدارات تابعة وخاضعة لمركز القرار السياسي الحقيقي الذي هو المؤسسة الملكية، وفق الفصل 49 من الدستور..
كما أن الإدارة السلطوية المخزنية و الإدارة الترابية المتمثـلة في وزارة الداخلية و مؤسسات الولاة و العمال و القياد هي مؤسسات تضمن و تسهر على تنفـيذ قرارات المؤسسة الملكية و البرجوازية الكمبرادورية. و بالتالي فالحكومة و البرلمان هي فقط إدارات تتداول في أحسن السبل و الطرق لتنفيذ البرنامج الاستراتيجي و قرارات المؤسسة الملكية و المؤسسة السياسية المخزنية. إذ تصبح الحكومة إدارة من إدارات المخزن. و هذا يعني أن السلطة الحقيقية التي تحكم المغرب هي سلطة المخزن.
والغريب أن أغلب النخب السياسية لا تتوقف عن ترويج “أن المجتمع المغربي بدون سلطوية المخزن سيدخل في حرب أهلية متعددة الأبعاد الدينية و الإثنية والسياسية”. و هذه إيديولوجية مرتبطة بطبيعة النسق السياسي و اشتغاله مع النخب السياسية و فق سياسة “الخدمة .. الخضوع.. الهبة”.. و هي إيديولوجية أصبحت تخترق حتى النخب المثقفة و المتعلمة بعد أن استلبت أغلب الطبقات الشعبية.
والرد بسيط على هذه التراهات التي تروجها المؤسسة المخزنية و نخبها و إيديولوجيتها، فأي شعب لن يتعلم و يمارس الديمقراطية إلا بممارسة الديمقراطية والمواطنة و حقوق الانسان و بسياسة تلبي مصالحه الديمقراطية تجسد و تحترم فعلا، و يوميا، حريته و كرامته و تحقق له العدالة الاجتماعية و المساواة. فليس هناك شعب أصبح شعبا ديمقراطيا و هو يرزج تحت ثقافة التخلف و الاستبداد و تحت سلطوية نظام سياسي اجتماعي.
*
تعامل سلطة النظام السياسي و أغلب النخب السياسية يجعل المرحلة السياسية المقبلة لن تختلف عن سابقتها، مع بعض التعديلات السياسية في الاصطفافات والائتلافات و التحالفات الانتخابية. و قد تحدث معادلة جديدة تلخبط حسابات الأحزاب السياسية بالنظر لما عاشته الفئات المتوسطة من ضرب لمصالحها.
لكن لا عقلانية الحقل السياسي تنتج تحالفات و ائتلافات غير مؤسسة إديولوجيا و سياسيا و طبقيا.
ورغم انتقاد عدد من الأحزاب فرض ما يسمى “قطبية ثنائية” أنتجها النظام السياسي المخزني و واقع مخدوم للانتخابات، قطب أول تتزعمه “العدالة و التنمية” (القطب المحافظة المخزنية) و قطب ثاني يتزعمه “الأصالة و المعاصرة” (قطب “الحداثة” المخزنية)، فإن التقاءات و تقاربات بدأت تـُـؤَثـِّـتُ هذه الثنائية القطبية منذ تشكيل حكومة رئيسها عبدالإله بنكيران..
– الاتحاد الاشتراكي فقد الكثير من نضاليته و تصوره الديمقراطيين و من رصيده التاريخي، و خصوصا فرط في التقرير الإيديولوجي و البيان العام اللذين تبناهما في مؤتمره الاستثنائي في يناير 1975 و لخصهما في شعار “من أجل التحرير والنمو والديمقراطية والبناء الاشتراكي”، و هي الأسس التي تأسس عليها نضاله الديمقراطي، ودخل منذ مؤتمره الثامن سنة 1998 في زوابع النتاقضات الداخلية و الانقسام، بعد أن قبل كاتبه الأول رئاسة الحكومة عام 1998 و بدأت مرة أخرى أخطاء حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية العريق لأن كاتبه الأول عبد الرحمان اليوسفي لم يتخذ احتياطاته و لم يبلور شروطه السياسية لتشكيل حكومة ائتلاف مع قوى ساهمت بصمتها في الاستبداد و الانتهاكات الجسيمة التي تعرضت لها حقوق الانسان. و كان طبيعيا أن تتفجر تناقضات داخل قيادة الحزب و مع الشبيبة الاتحادية و نقابة الكنفدرالية الديمقراطية، و كان طبيعيا ان يؤدي تراكم الخلافات الى احتدام الصراعات حول الخط السياسي بين أعضاء القيادة السابقة للحزب اثناء المؤتمر السادس، و بدأت التصدعات و الانشقاقات.. و رغم اختلاف اليساريين و اليساريات الديمقراطيين مع الاتحاد الاشتراكي اليوم، سياسيا و موقفا، لكنهم لا يرتاحون للواقع المأزوم الذي وصل إليه.
لكن قيادة الاتحاد الاشتراكي الحالية، التي لها موقف معارض لـ”العدالة و التنمية”، تحاول تجاوز أزمة الحزب من خلال لقائها مع قيادة “الأصالة و المعاصرة” حول عدة ملفات و قضايا و إصدار بلاغ مشترك بعد لقاء 23 فبراير 2016، يؤكد على “التشبث بالاختيار الديمقراطي الحداثي للمغرب و حماية هذا الاختيار”.. “ومواجهة كل التيارات المتشددة، الظاهرة والمستترة، التي تروج خطابا رجعيا و الاستمرار في التشاور والحوار في مختلف القضايا التي تهم الشأن العام خاصة تلك التي تتعلق بالاستحقاقات المقبلة”.. و هذا مؤشر دال عن احتمال أن يتحالف الاتحاد الاشتراكي مع الأصالة و المعاصرة بعد انتخابات 7 أكتوبر المقبل كما تأكد هذا التقارب بالحضور الوازن لقيادة الاتحاد الاشتراكي ممثلة بالكاتب الأول ادريس لشكر و برئيس المجلس الوطني الحبيب المالكي لبرنامج “ضيف الأولى” يوم الثلثاء 26 يوليوز الأخير و الذي استضاف إلياس المعري الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة.
– حاول حزب الاستقلال، الذي كان هدفه باستمرار القرب من مركز القرار عبر المشاركة في الحكومات المتعاقبة، معالجة تناقضاته الداخلية الحزب بمساعدة قاداته التاريخية و بلورة مصالحة بين أمينه العام حميد شباط و تيار عبد الواحد الفاسي “بلا هوادة”، لكن لم يتم التغلب على المشاكل التي خلفها النزاع الداخلي بينهما و تجاوزها استعدادا لمستقبل الحزب في الانتخابات التشريعية المقبلة، إضافة إلى اعتبار عدد من القياديين أن شباط يستفرد بالقرار و يدخل في نزاعات أضرت بسمعة الحزب.
يظهر أن حزب الاستقلال تجاوز صراعه مع “العدالة والتنمية” كما لم نلاحظ أي تقارب لحزب الاستقلال مع “الأصالة والمعاصرة”، و لأنه يعي أن مشاركاته في الحكومة تضمن له استمرار حضوره السياسي و استمرار مصالح نخبه، لذلك يستسيغ بقاءة كحزب معارضة،و بالتالي يمكن أن نفهم محاولته رأب الصدع والتناقض الذي عاشه مع “العدلة و التنمية” و الرهان على التحالف معه في تشكيل حكومة ما بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016.
– حزب التقدم و الاشتراكية دخل مسارا جديدا بعد دخوله إلى حكومة يرأسها “العدالة و التنمية”، و لا زال متشيثا بهذه التجربة.و رغم أن قيادته أجرت لقاء مع قيادة الاتحادد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلا أن له موقفا مناهضا لحزب الأصالة و المعاصرة الذي يعتبره حزبا يعمل من أجل التحكم في الوضع السياسي.. وهو الموقف الذي يجعله في موقع متناقض مع حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ينسق مع “الأصالة و المعاصرة”. كما أن احتمال فك ارتباطه بحليفه الحكومي “العدالة و التنمية” احتمال ضعيف.. إضافة إلى أنه كان شريكا أساسيا في الإجراءات السياسية و اجتماعية ضد المصالح الحيوية للطبقات الشعبية وعموم المواطنات و المواطنين و شريكا في ممارسات قمع حرية الصحافة و حريات فردية و عامة.. و في ضرب حق الإضراب.. و العفو عن الفساد و نهب المال العام.
وهذا يبين لا عقلانية العلاقات بين الأحزاب لكونها علاقات تجسد براغماتية نفعية و لا تحتكم إلى و لا ترتبط بمبادئ أساسية واضحة و خط سياسي واضح يجعل كل الاحتمالات واردة بغض النظر عن المبادئ و عن الخط السياسي.
أما حزب الحركة الشعبية، فخلال تاريخه اشتغل مع المخزن و مارس السياسة في علاقته بالأحزاب الأخرى كـ”الجوك”.. يأتلف مع الجميع.. و يتحالف خصوصا مع اليمين المخزني. تتراجع مكانته الانتخابية باستمرار.
*
رغم موقفنا السلبي الذي شرحنا بعض أسبابه من الانتخابات في المغرب، نرى أن مقاطعة الانتخابات في المغرب ليس لها تأثير قوي و حاسم في الصراع الطبقي السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي الذي يخوضه اليسار من أجل ديمقراطية حقيقية، و لن تشكل المقاطعة تقدما في تغيير ميزان القوى لصالح القوى الديمقراطية و اليسارية التقدمية، مع أننا نحترم موقف و ممارسة مقاطعة الانتخابات. و نقر بضرورة احترام حق القوى المقتنعة بقرار المقاطعة في التعبير بجميع الاشكال السلمية و حق هذا القوى السياسية في التواصل مع المواطنين و المواطنات عبر وسائل الإعلام العمومية (خصوصا التلفزة و الراديو..) للدفاع عن موقفها.
ونرى، عكس مقاطعة الانتخابات، أن من مسئولية القوى اليسارية الديمقراطية الراديكالية المناهضة للمخزن السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و المناهضة للتبعية للعولمة الامبريالية و المناضلة من أجل ديمقراطية حقيقية، بهذا القدر أو ذاك، باختلاف توجهاتها و تصوراتها و مواقفها (فدرالية اليسار الديمقراطي والنهج الديمقراطي و المجموعات اليسارية الماركسية بمختلف توجهاتها و المتواجدة خصوصا داخل الحركة الطلابية و حركة المعطلين و الإطارات اليسارية والديمقراطية للمجتمع المدني المناضل و مجموعات من شباب حركة 20 فبراير و اليساريين و اليساريات في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد المغربي للشغل) نرى اليوم أن مسئولية هذه القوى اليسارية و الديمقراطية الراديكالية هي فتح حوار عاجل و ديمقراطي في ما بينها من أجل تنظيم، في أقرب وقت، لقاءات للحوار من أجل تشكيل قطب يساري مناهض للمخزن و للقوى اليمينية المخزنية و لحركات الإسلام السياسي.. لأننا نعتبر أن التناقض بين المخزن والإسلام السياسي تناقض ثانوي، و يشكل المخزن و قوى اليمين و حركات الإسلام السياسي طرف التناقض الرئيسي في حين تشكل القوى السياسية و النقابية والثقافية و المدنية اليسارية و الديمقراطية فعلا و حقيقة الطرف الثاني لهذا التناقض الرئيسي.
فقد أفرزت نضالات حركة 20 فبراير و جماهيرها المطالبة بالديمقراطية و الحرية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و إسقاط النسق السياسي المخزني، في جل مناطق المغرب.. أفرزت اصطفافات واضحة.. و شكلت حركة 20 فبراير منعطفا سياسيا تاريخيا لإحداث قطيعة مع المخزن و تجاوزه و صيرورة انتقال فعلي إلى نظام سياسي ديمقراطي. فاتخذت “جماعة العدالة و التنمية”، و كذلك بعض القوى المحسوبة على اليسار (الاتحاد الاشتراكي و التقدم و الاشتراكية) موقف مقاطعة حركة 20 فبراير أو سياسة “قلبي مع حركة 20 فبراير و يساستي مع ما بلورته المؤسسة الملكية” و مارست سياسة متوافقة مع المخزن.
لقد انكشف وعي “جماعة العدالة و التنمية” الذي يعتبر أن المخزن يمثل الإسلام الرسمي، و حركات الإسلام السياسي (جماعة العدالة و التنمية، و السلفية المتصالحة مع المخزن.. أما “جماعة العدل و الإحسان” فإنها رغم خطابها و ممارستها المناهضة للمخزن فإنها تطرح مشروع “نظام الخلافة الإسلامية” و تعتبر الديمقراطية طريقا فقط لاقتحام المجتمع و الدولة لتطبيق مشروعها.
إن إسلام النظام السياسي و إسلام الحركات الإسلامية ليس سوى تأويلا سياسيا للإسلام و لا تتناقض هذه التأويلات جوهريا مع الإسلام الرسمي، بل تتكامل معه.. فليس بينها صراع الوجود السياسي و السيطرة السياسية بل صراع الاختلاف في تأويل تطبيق الإسلام، و بينهم كذلك و فقط تنافس فيما يخص تمثيل الإسلام وتعريفه و تأويله و طرق نشره و سيطرته على المجتمع. كما أن المخزن و إسلامه الرسمي و حركات الإسلام السياسي ترفض العنف مرحليا، و تناهض التيارات و الحركات المتشددة التي تعتنق إسلام التطرف التكفيري و ترفع شعار “التكفير و التفجير” كما تناهض فصل الدين عن الدولة و حرية الاعتقاد. لكن كلما تطور الصراع الطبقي من أجل الديمقراطية لا شك أن النظام السياسي و حركات الإسلام السياسي ستغير موقفها من العنف و تمارس العنف ضد من يعتبرونهم أعداء سياسيين و لفرض تصورها.. و يعيش الواقع السياسي و الإيديولوجي مؤشرات و ممارسات عديدة و خطابات محافظة مغالية و خطابات تكفيرية.
أما تجارب جماعة السلفيين المتصالحة مرحليا مع المخزن فقد اختار بعضهم الاندماج في حزب النهضة والفضيلة سنة 2013، و في ماي اندمج عبد الكريم الشادلي و مجموعة من السلفيين في حزب عرشان الحركة الديمقراطية الاجتماعية. لكن يظهر أن هؤلاء السلفيين لم يتوافقوا مع حزب عرشان و فتحوا قناة وتواصلا مع حزب “الديمقراطيون الجدد” الذي يتزعمه محمد ضريف الذي أوضح سابقا في تصريح لفبراير كوم انه تلقى مؤخرا اتصالات من سلفيين مفرج عنهم، عبروا بشكل فردي عن التحاقهم بالحزب، واخرون تكلموا باسم مجموعات.
*
وبالتالي نرى أن المرحلة تفرض على اليسار الراديكالي الدخول في عاجلا في حوار سياسي و لقاءات مسئولة لبلورة تصور سياسي مشترك و برنامج و خطة سياسية و نضالية في هذه المرحلة و في القلب منها فترة الانتخابات لمواجهة توسع قوى الإسلام السياسي و القوى المخزن السياسي التي تدافع عن مشروعها الذاتي عبر استلاب وعي جماهير الطبقات الشعبية المغربية.
ولا يعني تشكيل هذا القطب اليساري النضالي اندماج أو تحالف، بل هو “تكتيك مرحلي” لانجاز مهمتين متلازمتين:
– ممارسة سياسية و إيديولوجية و اجتماعية و ثقافية ديمقراطية متضامنة لمواجهة سيطرة المخزن في الحقل و الواقع السياسي و الاجتماعي و الثقافي وبلورة برنامج نضالي من أجل تجاوزه.
– ممارسة سياسية و إيديولوجية و اجتماعية و ثقافية ديمقراطية لمواجهة حركات الإسلام السياسي و الإيديولوجي في واقعنا السياسي و الاجتماعي والثقافي.