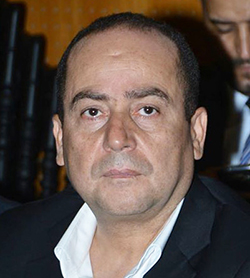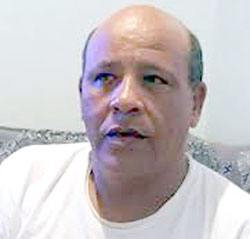
الفساد بين الفهم والمفهوم
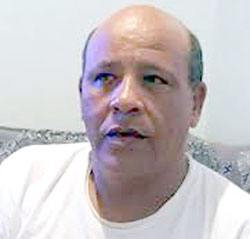
لكي نضع العقل على الطريق الصحيح للبحث عن اليقين. يقول الفيلسوف الفرنسي ديكارت “هذا أشبه بالشخص الذي لديه سلة تفاح، بعضه سليم، وبعضه معطوب فاسد، فلا جدوى من تقليب التفاح داخل السلة لإخراج ما فيها من الفاسد، أفضل طريقة لفرز السليم من الفاسد، هو تفريغ كل ما في السلة من تفاح. ثم تنتقي التفاح السليم وتبعد الفاسد. وتكون بذلك على ثقة أن جميع التفاح الذي أعدته إلى السلة تفاح سليم” .. يبدو من خلال هذه المقولة أن الفساد يصيب ما في الطبيعة .. كما يصيب الإنسان في علاقاته، وتصوراته وأفكاره. وأيضا في عمله، وسلوكه وحياته.. وكما تفسد الثمار.. يفسد الإنسان .. لكن كيف يمكننا أن ننظف سلة المجتمع من الفاسدين؟ وكيف نفرغ السلة .. بل كيف نعرف الفاسد من السليم الصالح؟ يبدو أن الحديث عن الفساد الذي يصيب المجتمعات، لتحديده وسبر أغواره معرفيا من الصعوبة بمكان .. فرغم اتفاق الجميع اليوم، أن ظاهرة الفساد مستشرية .. وأضحت جزءا لا يتجزأ من الحياة العامة .. لكن تتعدد صورها، وتتداخل، مما جعل الفساد يستخدم للإشارة إلى دائرة واسعة من الأنشطة والممارسات. سنحاول تلمس بعضا من خيوطه في هذه المحاولة، آملين أن نوفق ولو بإظهار شيء من ملامح هذا المرض الخبيث، الذي يستشري كالسرطان في جسم الدولة والمجتمع.
آراء أخرى
الفساد ظاهرة، والحقيقة ما من ظاهرة تداخلت فيها العوامل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية مثل ظاهرة الفساد. حيث أن المحللين منهم من يرى، أن الفساد هو ظاهرة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية – ثقافية .. ويرى فريق آخر أنها اجتماعية ذات أبعاد اقتصادية .. بينما يرى فريق ثالث أنه لا يمكن إبعاد أو إغفال البعد السياسي، في تحليل هذه الظاهرة .. وبهذا، فإن الطبيعة المعقدة لظاهرة الفساد، جعلت مهمة تقديم أو إعطاء تعريف دقيق للفساد، مهمة صعبة، وغير يسيرة .. فالفساد للغة يعني حسب تعدد السياقات.. الانحلال، والفسق، والتلف، والعطب ، والضرر، والخراب، وأخذ المال ظلما، وعكس الصلاح، والبطلان.. والفساد مرتبط بالاستبداد كما عرفه الكواكبي.. لكن، لنأخذ تعريف أرسطو، وهو أشهر فلاسفة الإغريق، كيف أنه جعل ثلاثة أنواع رئيسية للإدارة ومن خلالها أوضح مفهوم الفساد.
– إدارة الفرد لشؤونه: تتسم بالفساد إذا ما أطلق الفرد العنان لرغباته وأصبح عبد نزواته. إذ غالبا ما يدفعه هذا إلى التعدي على حقوق الآخرين والتورط في ممارسات لا أخلاقية.
– إدارة رب العائلة لشؤون عائلته: بأن يستغل رب العائلة نفوذه لإشباع احتياجاته الخاصة من دون أن يعبأ بمصالح عائلته ككل ويلبي احتياجاتها.
– إدارة الدولة (الطبقة الحاكمة) لرعاياها: بالمنطق نفسه مع رب الأسرة يصيب الدولة الفساد إذا ما قامت الطبقة الحاكمة باستغلال سلطتها لتحقيق مصالحها الخاصة أو تحقيق مصالح فئة معينة من فئات الشعب على حساب الفئات الأخرى، وبذلك لم تعمل على تحقيق مصالح جميع فئات الشعب.
يلاحظ من خلال مفهوم أرسطو، أن الفساد يوجد عندما يساء استغلال أي سلطة .. سواء كانت سلطة الفرد على نفسه، أو سلطة رب العائلة على أسرته، أو الطبقة الحاكمة، إذا ما أساءت استخدام السلطة السياسية. غير أن هناك تعريفات متعددة، كلها تعطي دورا محوريا للسلطة العامة، في ظاهرة الفساد.. حيث ترى أن بذور الفساد تنبت في مجالات التعامل بين مؤسسات الدولة والإدارات الحكومية والقطاع العام من ناحية. وأفراد المجتمع الطبيعيين والمعنويين من ناحية أخرى. فعلى جانب، مسؤولي الدولة وموظفي الحكومة (الفاسدين). وعلى الجانب الآخر، أفراد المجتمع (المفسدين). من هنا يمكن القول أن الفساد يتمثل في استغلال النفوذ والسلطة (عامة أو خاصة)، لتحقيق منافع خاصة .. علاوة على أن معظم ممارسات الفساد هي ذات طبيعة غير قانونية، ولا أخلاقية. فمن الضروري أن نحدد الكيفية التي يمارس بها الفساد .. فرغم الصور المتداخلة والمتشابكة بعضها بعضا، وفي كثير من الأحيان. لكن يجب التمييز بينها .. وتصنيفها حيث تتمثل في الرشوة والمحسوبية والابتزاز والاختلاس والاحتيال. لنوضح ..
الرشوة ، جوهر ظاهرة الفساد. وتعني تلقي شيء ذي قيمة، في إطار معاملة تتسم بالفساد.. أي الحصول على ما ليس بحق .. أو حق من الحقوق، لا يمكن الحصول عليه بتقديم رشوة. والرشوة هي أكثر الفساد انتشارا.
المحسوبية، تتمثل في المحاباة، أو التحيز لفرد أو جهة معينة، باستغلال السلطة أو النفوذ وتجاوز القوانين والتشريعات .. مثال، أن يمنح بعض من يتمتعون بسلطة معينة مزايا معينة .. أو تسهيلات لفرد أو جهة بسبب وجود قرابة، أو صلة، أو صداقة، أو علاقة خاصة .. وتمثل المحسوبية إحدى أهم أشكال الفساد. ومن مسببات المحسوبية، الإحساس والشعور بالظلم والقهر الاجتماعي.
الابتزاز، هو أن يقوم شخص أو جهة بانتزاع شيء ذي قيمة قسرا، مقابل عدم استخدام السلطة أو النفوذ أو العنف على نحو يضر بالمبتزين أو مصالحهم ..
الاختلاس، هو الاستيلاء على شيء ذي قيمة، من قبل من يتولى إدارة أو المحافظة على هذا الشيء .. ورغم أن الاختلاس يعد أحد أشكال الفساد .. لكن تظهر صعوبة تتبع ومحاربة هذا الشكل، في مؤسسات الدولة .. فمثلا عندما يختلس أحدهم جزءا من المال العام .. فالمال العام لا يمثل ممتلكات فردية .. من تم فإن المواطنين، وأفراد المجتمع لا يملكون الصفة القانونية، التي تعطيهم الحق، في المطالبة باسترداد ما اختلس.
الاحتيال، هو جريمة تتضمن نوعا من الغش، أو الخداع أو التحايل، في إطار ظاهرة الفساد .. ويمكن تعريف الاحتيال بأنه القيام بتشويه أو تزييف الحقائق والمعلومات لتحقيق منافع خاصة .. وبالطبع فإن عمليات الاحتيال التي تتم من قبل مسؤولي السلطة التنفيذية هي الأكثر خطورة. إذ يكون جميع أفراد المجتمع ضحية هذا الاحتيال.
لاشك أن محصلة نطاق الفساد في مجتمع ما .. هي محصلة تفاعل عدد من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإدارية .. فعند دراسة ظاهرة الفساد لا يمكن تجاهل عوامل مثل طبيعة النظام السياسي.. ومدى احترام حقوق الإنسان، والديمقراطية، والقوانين المنظمة والتشريعات، وكفاءة النظم الإدارية ونزاهة النظام القضائي، واللوائح المنظمة لشتى المجالات الاقتصادية، وسنتحدث عن الفساد السياسي، باعتباره عنصرا هاما .. إذ يسمى الفساد الكبير، ويمارس من قبل من هم في قمة هرم السلطة التنفيذية والسياسية .. ويأخذ هذا النوع أشكالا متعددة، أخطرها الشكل السافر الذي يتمثل في قيام القيادات السياسية بسرقة أموال الشعب على نحو مباشر. وذلك من خلال تحويل أرصدة مالية، أو أصول مملوكة للدولة إلى ممتلكات خاصة. وهنا تتلاشى الحدود بين أموال الشعب وأموال الفئة الحاكمة .. يضاف كذلك لهذه الخانة من الفساد، استغلال المسؤولين السياسيين سلطتهم للاستيلاء على ممتلكات الشعب. أو تلقي رشاوى أو عمولات ضخمة، من الشركات (وطنية أو أجنبية)، مقابل إرساء بعض التعاقدات، أو منح استثمارات أو احتكارات. ومن خطورته أنه يكون بصورة سرية، بعيدة عن الحياة اليومية لأفراد المجتمع .. ويتفشى في الأنظمة غير الديمقراطية .. ومخلفاته مدمرة للأجيال الحالية والقادمة.
لاشك أن محصلة نطاق الفساد في مجتمع ما ..هي محصلة تفاعل عدد من العوامل السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والإدارية.. فعند دراسة ظاهرة الفساد لا يمكن تجاهل عوامل مثل طبيعة النظام السياسي.. ومدى احترام حقوق الإنسان، والديمقراطية، والقوانين المنظمة والتشريعات، وكفاءة النظم الإدارية ونزاهة النظام القضائي،
الفساد الإداري، أو الفساد الصغير، وهو ذلك الفساد الذي يتم على مستوى الإدارات والمؤسسات الحكومية من قبل صغار الموظفين. وهذا النوع من الفساد، هو ما يواجهه المواطنون بشكل يومي، عند التعامل مع الإدارة .. ويسمى الفساد الصغير، لأنه يكون غالبا في حدود مالية صغيرة نسبيا .. وقد يلاحظ أن الفساد الإداري والسياسي قد يتلازمان في كثير من الأحيان، ويسيران جنبا إلى جنب، ويدعم كل منهما الآخر. وذلك في إطار توزيع الأدوار بين القمة والقاعدة .. وبهذا تنتشر عدوى الفساد في جسد المجتمع .. فما سلكه كبار الموظفين، يسلكه صغارهم. وعندئذ يكون الفساد السياسي، هو الراعي الرسمي للفساد الإداري على نحو كبير. حتى ليخيل لك أن الفساد أضحى من المسلمات، وتشريعا معمول به. ويشيع الانطباع بأنه الأصل في التعامل .. ويصبح سلوكا مستقرا متعارف عليه ..فالفساد كالوباء ينتشر بين الإدارات، والهيئات الحكومية، ويصبح نظام حياة.
وهنا تكمن خطورته، فيتمتع بآليات الانتشار، ويخلف آثارا متتابعة، تؤثر بصورة واضحة في المنظومة الاقتصادية، والاجتماعية، والنسيج السياسي والثقافي للمجتمع. فبدلا من محاربته، سيعمل الضمير العام على حمايته ومجاراته.. وهنا نطرح السؤال، ما هي العوامل المحددة لاتساع دائرة الفساد؟ للإجابة، يمكن إجمال هذه العوامل في ما يلي:
– انخفاض مستوى المعيشة وتردي الأوضاع الاقتصادية.
– التدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي.
– انخفاض مستويات الأجور والمرتبات في القطاع الحكومي.
– غياب البيئة التنافسية.
– غياب سيادة مبادئ الديمقراطية.
– نزاهة القيادات السياسية.
– كفاءة الجهاز الإداري الحكومي.
– تعقد القوانين والتشريعات.
– مدى توفر آليات الرقابة والمساءلة.
– سيادة قيم العمل الفردي مقابل العمل الجماعي.
– الميل الحدي للفساد لدى الأطراف الفاعلة في المجتمع.
محور معظم الدراسات الخاصة بظاهرة الفساد، تناول الفساد العام، الذي يتورط فيه مسؤولي الدولة أو موظفي الحكومة ومن يدور في فلكهم .. بل يرى البعض أنه حتى يكون الفساد فسادا، يجب أن يرتبط بهده الفئة ويسمى الفساد العام .. بينما الفساد الخاص، فيتم تصنيفه من خلال ممارسات تتم بين طرفين، ليس منهما موظف عام. ويأخذ هدا الفساد صورا عديدة وينشط في الهامش .. مما يجعله يخلق بيئة اجتماعية – ثقافية تساعد على انتشار الفساد العام، وتعززه. وهنا يبرز البعد الثقافي، لظاهرة الفساد.. ولا يجب التهوين من هذا الخاص، وأثاره السلبية ففي ظله تظهر الولاءات، والاحتيال، والرشوة بصيغة الهدايا والمكروميات. وتتراجع قيمة العمل والأخلاق، وتتقوى الانتهازية والمحسوبية والزبونية والوصولية .. الأمر الذي يؤدي إلى الإحباط الاجتماعي، وانعدام الأخلاق والقيم .. ويعتقد جل الباحثين والدارسين لظاهرة الفساد، أن الفساد العام هو الأخطر. وأن محاصرته شرط ضروري لمحاصرة الفساد الخاص. إن العنصر الثقافي لا يمكن طمسه إزاء هذه الظاهر .. بل هو ذلك التماثل الذي يحتضن الظاهرة ويمدها بالشرعية .. وتقبل بالميل الحدي لها .. لذا مثلما تفسد الأشياء .. تفسد الأفكار.. وهذا ما كان يرمي إليه ديكارت من خلال سلة التفاح .. وأيضا تفسد السلوكات والقيم.
الخلاصة، هل يمكن محاربة الفساد؟ وتنظيف سلة المجتمع منه؟ الأمم المتحدة في اتفاقية مكافحة الفساد .. تعبر في الديباجة عن قلقها إزاء خطورة هذه الظاهرة .. وما يطرحه الفساد من مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها .. في الفقرة الأولى من المادة الخامسة للاتفاقية تنص على ما يلي:
(تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الشؤون والممتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية والمساءلة)، من خلال منطوق هذه الفقرة، يتضح أن الأمر يتعلق بالإرادة الحقيقية لمحاربة ومكافحة الفساد.. وهذا أول الشروط .. نضيف، أنه لإعلان حرب حقيقية لمواجهة ومكافحة الفساد .. هذا السرطان القاتل .. يجب الذي يجب .. ومما يجب ما يلي:
الإصلاح السياسي من خلال إرساء الديمقراطية بداية .. الإصلاح الاقتصادي من خلال التنمية وتحسين مستويات المعيشية .. وإرساء مبادئ تكافؤ الفرص والكفاءة .. وإصلاح تشريعي قضائي يتمثل في تبسيط التشريعات والقوانين .. ومسطرة التقاضي .. واستقلالية القضاء .. وإصلاح إداري يستهدف رفع الكفاءات الإدارية .. وتفعيل آلية الرقابة والمحاسبة والشفافية .. وإنشاء كيان مستقل لمكافحة الفساد.. تتوفر له كل الإمكانيات بما فيها السلطة الكافية لمواجهة المفسدين والفاسدين أيا كان موقعهم .. ونعود وعلى وجه الدقة أولا وقبلا .. إيمان وجدية القيادة السياسية في مكافحة الفساد بإرادة حقيقية.