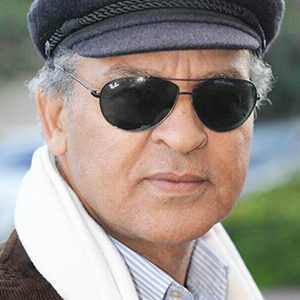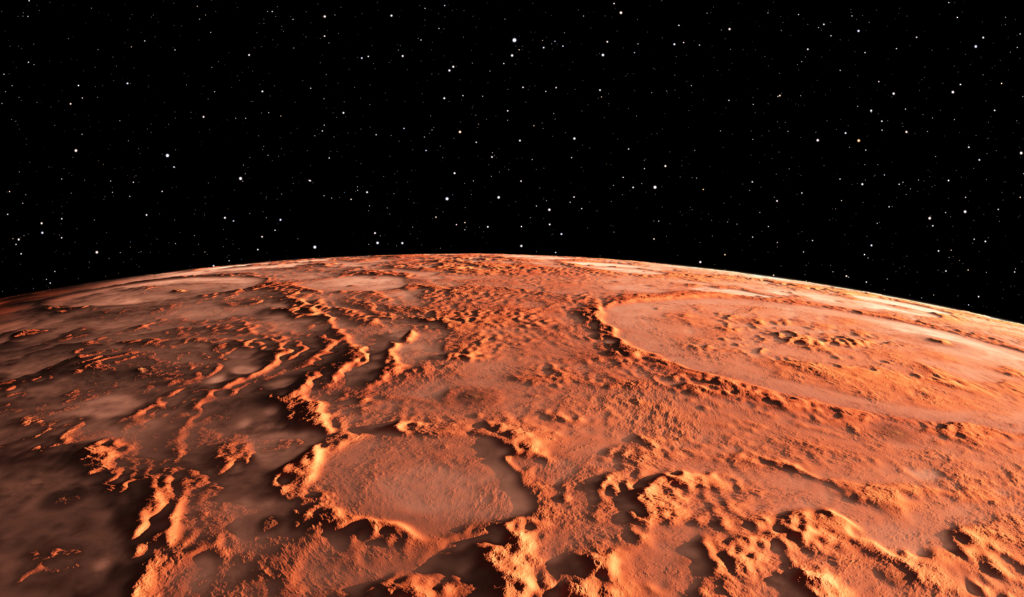الاقتصاد المُهْمَل: الضّرائب تَتَزَايَد، والخَدمات العُمومية تتناقص

توجد في الاقتصاد أنشطة تتباهى بها الدولة، وتنشغل بها وسائل الإعلام. وتوجد في الاقتصاد أيضا أشياء تبقى خفية، أو مهملة، رغم أهمية تأثيرها السلبي على المجتمع.
آراء أخرى
1- أداء ”الضريبة على السيارات“ عبر الأبناك غير قانوني
اعتاد مَالِكُو السيارات، في شهر يناير من كل عام، على الذهاب إلى إحدى إدارات ”مديرية الضرائب“ لكي يؤدّوا ”الضريبة السنوية على السيارات“ (vignette). وتبتدئ قيمة هذه الضريبة من 350 درهم بالنسبة لأصغر سيارة (6 حِصَان)، وترتفع إلى عدّة آلاف من الدراهم بالنسبة للسيارات القوية أو الفخمة.
وبدلا من أن يكون أداء الضريبة على السيارة ممكنا خلال شُهور السنة كلها (مثلما في حالة التأمين على السيارات)، فرضت إدارة الضرائب أن تُؤَدَّى هذه الضريبة فقط في شهر يناير. وكانت إدارة الضرائب تجد صعوبة في توفير العدد الكافي من الموظفين لتحصيل الضريبة السنوية على السيارات خلال شهر يناير (وحده). وفي الأصل، كانت إدارة الضرائب هي التي تتحمّل كُلْفَة عملية تحصيل هذه الضريبة على السيارات. لكن الغريب هو أنه، منذ سنة 2016، لجأت إدارة الضرائب إلى حل بسيط للتخلّص من كُلْفَة أعباء عملية تحصيل هذه الضريبة على السيارات. والواجب يفرض أن نقول صراحةً عن هذا الحل أنه غير قانوني، أو غير عادل، أو غير دستوري. ولم ينتبه له بعدُ الحقوقيون، والبرلمانيون، والجمعيات المدافعة عن المستهلك. أما الشعب، فهو في معظمه غافل كالعادة.
حيث قرّرت إدارة الضرائب التخلّص من عناء تحصيل هذه الضريبة، فَـكلّفت الأبناك بالقيام بهذه المهمة. ووجدت الأبناك (المُهيمنة أصلا على المجتمع) فرصة من ذهب في هذا التكليف (sous-traitance) لكي تربح الملايين من الدراهم. حيث تفرض الأبناك أداء 28 درهم على كل شخص يريد أداء الضريبة على السيارة (سواء كانت سيارته صغيرة أم فاخرة، ولا تُبَالِي الأبناك بهذا التفاوت فيما بين السيارات). وبما أن عدد السيارات في المغرب يبلغ قرابة 4 مليون سيارة في سنة 2018، فإن الأبناك ستتقاسم فيما بينها رِبْحًا يُقدّر بِـ: 28 درهم مضروبة في 4 ملايين سيارة، يُساوي قرابة 110 مليون درهم (أو ما يقرب من مليار سنتيم). وحتى إذا أدَّى المواطن الضريبة على السيارة عبر ”الشُبَّاك البنكي الآلي“ (الذي يَفْرِض القانون بأن يكون بالمجان)، يقتطع له البنك 6،40 درهم، ولا يعطيه ”وصل إثبات“ (reçu) على ذلك الأداء. وإذا أراد المواطن ”وصل إثبات“، يلزمه أن يؤدّي 28 درهما في البنك. والمواطنون المستعملون للسيارات هم طبعًا الذين يؤدون، مُكرهين، كل هذه الزيادات في نفقة ”الضريبة على السيارات“. وشعب المغرب يخضع، ولو كان مُجبرًا، أو مظلومًا.
وفي الواقع، ومن وجهة نظر أصحاب السيارات، فإن هذه الطريقة الجديدة المفروضة في مجال أداء ”الضريبة على السيارات“ هي بمثابة زيادة خفيّة، وغير قانونية، وغير دستورية، في كُلْفَة ”الضريبة على السيارات“. ونسبتها هي: 28 درهم على 350 درهم، يُساوِي: +8 في المائة (بالنسبة للسيارات الصغيرة).
ومن وجهة نظر قانونية، فإن إدارة الضرائب هي التي نَاوَلَتْ (sous-traité) خِدْمَة تحصيل الضريبة على السيارات إلى الأبناك. وبالتالي، فإن إدارة الضرائب هي التي كان يجب عليها أن تؤدّي كُلْفَة هذه المُنَاوَلَة (sous-traitance)، أي كُلْفَة الأداء عبر البنك (أي 28 درهما)، وليس أصحاب السيارات. حيث أن أصحاب السيارات الصغيرة كانوا يؤدون 350 درهم، ويلزم أن لا يؤدوا إلاّ 350 درهم، لا أكثر. وإدارة الضرائب هي التي احتاجت إلى إعطاء مُنَاوَلَة (sous-traitance) إلى الأبناك، وليس مالكو السيارات هم الذين احتاجوا إلى الذهاب إلى الأبناك لأداء هذه الضريبة. والعدل يقتضي أن تُرجع إدارة الضرائب 28 درهم إلى كل مالك سيارة أدَّى الضريبة على سيارته عبر البنك (أو أن تنقص هذا المبلغ من الضريبة على السيارة في السنة المقبلة).
ولتوضيح هذه الفكرة أكثر، نُذكّر أن الأبناك، حينما تقدّم خدمة أداء فَوَاتِير الكهرباء أو الماء أو الهاتف لِزَبُون مُعَيَّن، عبر بَوَّابَة إلكترونية، فإن هذه الخدمة تكون بالمجان. حيث أن البنك يَـقْتَطِع فقط مبلغ الفاتورة (من حساب الزّبون)، دون أيّة زيادة أو عُمُولَة، والشركة المُستفيدة من هذا الأداء هي التي تؤدي للبنك تَكْلُفَة عملية الأداء.
وهذا المشكل هو في الحقيقة مظهر مُصغّر من مشكل كبير خفيّ في المغرب. وهو أن الدولة تظنّ أن كل مالكي السيارات هم كلهم أثرياء. فحوّلت الدولة أصحاب السيارات إلى ”بَقَرَة حَلُوب“. وتنتزع الدولة من أصحاب السيارات أموالا ضخمة ومتـنامية. حيث أن أصحاب السيارات يؤدون عددا متزايدا من ”الواجبات“ و”الضرائب“، منها الدوري، والمحلّي، والعام، والمباشر، وغير المباشر. ومنها: أداء ”تأمين“ سنوي لا يُـؤَمِّن شيئًا (يفوق بالضرورة 2500 درهم)، وأداء ”فحص تقني“ سنوي وَشَكْلِي للسيارات (يفوق 450 درهم)، والضريبة السنوية على السيارات (تفوق 350 درهم)، وضرائب مُهولة على وقود السيارات (تخفيها الدولة حجمها كأنها أسرار أمنية)، وضرائب عن استعمال الطّرق السّيارة، وتجديد ”جواز السياقة“، وتجديد ”البطاقة الرّمادية“، إلى آخره.
وإذا استمرّت إدارة الضرائب في نهج مُنَاوَلَة (sous-traiter) بعض مهامها إلى الأبناك (مثل جمع ”الضريبة على السيارات“)، فسيصبح من الأَفْيَد في هذه الحالة حذف إدارة الضرائب، والاكتفاء بتمرير الضرائب المجموعة مباشرةً من الأبناك إلى الصناديق المالية للحكومة. وستقبل الأبناك ذلك بابتهاج كبير.
2- ”الفحص التقني للسّيارات“ يتحوّل إلى ريع اقتصادي
وعلى خلاف الخطاب الرّسمي، أصبح ”الفحص التقني للسيارات“ إجباريًّا. وهو في جوهره توزيع ”اقتصاد الريع“ إلى بعض أنصار النظام السياسي القائم. لأن ”الفحص التقني“ ينتزع بقوّة القانون ”ريعًا“ من كل مالك لسيارة. وأداءه يتطلب اليوم أكثر من 450 درهم في كل سنة. بينما في سنوات 1990، كان هذا ”الفحص التقني“ في البداية يُنجز في كل 5 سنوات، وكان ثمنه هو 40 درهم. ثم صعد إلى 80 درهم. ثم ارتفع إلى 120 درهم. ثم إلى 180 درهم. والآن فاق 450 درهم. بل أصبح إجباريا في كل سنة (بدلا من كلّ 5 سنوات). وقال الخطاب الرّسمي: «الفحص التقني سَيُمَكِّن من تقليص حوادث السّير». وبعد أكثر من 10 سنوات من العمل بهذا ”الفحص التقني“ الباهض الكُلفة، استمرّت حوادث السّير كما كانت من قبل، ودون حدوث أي نقص مهم! ولماذا لا تزيد الدولة في كُلْفَة ”الفحص التقني“، ما دام مالكو السيارات هم ”البقرة الحَلُوب“ التي لا تنضبٍ!؟ ولماذا لا، ما دام الشعب صابرا، وخاضعا!؟ (أنظر في هذا المجال كتاب ”نقد الشعب“، للكاتب رحمان النوضة).
وهذه ”الواجبات“ المختلفة التي يؤدِّيها مالكو السيارات تدخل كلها في إطار ”اقتصاد الريع“. وهي نفقات تُـثـقل كاهل المواطن المالك لسيارة، ولا تنتج شيئا مفيدا للمجتمع.
3- ”حُرَّاس السيارات“ عاطلون مُسْتَتِرُون
يجد المواطنون (المالكون لسيارات) أنفسَهم مجبرين على النّيابة عن الدولة في تقديم ”مساعدات“ مالية إلى جيش متنام من العاطلين، المُسْـتَـتِـرِين في لباس ”حَارِس السيارات“. وتحسب الدولة في إحصاءاتها الرسمية ”حُرّاس السيارات“ كَـ ”عاملين“، وليس كعاطلين. وهذا الحساب يشكّل مُغالطة في الإحصائيات الرسمية للبلاد. ولا يدري أحد ماذا يَحْرُس ”حُرَّاس السّيارات“.
وبدلا من أن تكون ”حِرَاسة السيارة“ خدمة اختيارية بالتراضي (بين مالك السيارة وحارس السيارات)، يعتبرها بعض ”حرّاس السيارات“ إجبارية، فيلجؤون إلى مهاجمة مالكي السيارات لانتزاع أداء مُتَعَسَّف، أو يعتدون عليهم، ويسلبون منهم بالقوة ما يتراوح بين 3 و 10 دراهم.
وبعدما يكتشف ”حُرَّاس السيارات“ إمكانية تحصيل مدخول شهري يتراوح بين 1500 و 3000 درهم، فإنهم يرفضون رفضًا بَاتًّا التخلِّي عن هذه «المهنة» السّهلة والمُريحة.
ومعظم ”حُرَّاس السيارات“ هم في الأصل فلاحون فقراء. والبؤس القاس هو الذي أجبرهم على الهجرة من القرى إلى المدن. وهم من بين السكان الذي يضطرّون إلى استعمال ”السّكن العشوائي“. والاحتمال الأكبر هو أن هجرة ملايين الفلاحين الفقراء من القرى إلى المدن ستستمر خلال العقود المقبلة. والحكومة لا تأخذ هذه الهجرة بعين الاعتبار. حيث لا تُهَيِّئُ بما فيه الكفاية البنيات التحتية التي سيحتاج إليها هذا التدفّق الهائل من المواطنين (منها مثلا: السكن الاقتصادي، والشّغل، والتعليم، والصحة، والنقل الجماعي، إلى آخره).
وفي الحقيقة، كان ينبغي أن تكون الدولة هي التي تتكلّف بتوفير شغل منتج لهؤلاء العاطلين المُستـترين في أَلْبِسَة ”حُرّاس السيارات“، أو أن تؤدي لهم ”مساعدة“ مالية، أو ”مدخول اجتماعي للتَّعْوِيض عن البطالة“. لكن ما دام الشعب جاهلا، لماذا لا تُحَمِّل الدولة كُلْفَةَ مُساعدة هؤلاء ”العاطلين المُسْتَتِرِين“ إلى مالكي السيارات!؟
4- ”التقويم الضريبي“ على العقار إجحاف غير عادل
كمثال آخر على استبداد إدارة الضرائب، في مجال العقار، إذا باع مواطن منزلا مثلا بِـ 500 ألف درهم، لا تكتفي إدارة الضرائب بأن يؤدّي هذا الموطن ضرائب تقليدية ضخمة على 500 الف درهم (أو على الرّبح العقاري المُفترض)، بل يمكن أن تـقرّر إدارة الضرائب أن الثمن الذي كان ينبغي أن يُباع به هذا المنزل (حسب مُعَدَّلَات نظرية لأثمان سوق العقار) هو مثلا 950 ألف درهم. فتفرض عليه إدارة الضرائب أداء «تقويم ضريبي» (redressement fiscal) يمكن أن يضاعف حجم الضرائب العادية.
وقد نشرت إدارة الضرائب ”تطبيقًا“ (application) على الهاتف المنـقول يوضّح «مراجع أسعار العقار» التي تستعملها إدارة الضرائب عند حساب الضريبة على الأرباح العقارية. وتفرض إدارة الضرائب أداء ضرائب إضافية هائلة (وربما زيادات، وكذلك عقوبات إضافية) على أساس الثمن المُفْتَرَض (وهو في مثالنا 950 ألف درهم)، وليس على أساس الثمن الحقيقي، والمُصرّح به، الذي بَاع به ذلك المواطن منزله (وهو في مثالنا 500 ألف درهم). ولو أن المواطن لم يستطع، في الواقع المُعَاش، أن يجد ولو مشتريا واحدا يعطيه أكثر من 500 درهم، فإن إدارة الضرائب تفرض مرجعية 950 ألف درهم كأساس لحساب الضرائب، ولو أن هذه المرجعية (أي 950 ألف درهم) هي مجرد افتراض نظري (من وضع إدارة الضرائب)، وغير موجود في الواقع الحي.
ولا يقدر المواطن على الدفاع عن نفسه، لأنه يستحيل على المواطن أن يُثْبِتَ أنه لم يـبع ذلك المنزل بأكثر من 500 ألف درهم (أي بثمن أكبر «من تحت الطاولة» [dessous de table]). كما يستحيل على إدارة الضرائب أن تُـثْبِتَ أن هذا المنزل بِيعَ خَفْيَةً (au noir) بأكثر من 500 الف درهم.
صحيح أن بعض المواطنين، وخاصة بعض ”المنعّشين العقاريين“، يغشّون. حيث لا يُصرِّحون إلاّ بجزء من الثمن الحقيقي الذي باعوا به عقارهم، وذلك لتخفيف عبء الضرائب المفروضة عليهم. لكن وجود هذا التحايل لا يبرر فرض ”تقويم ضريبي“ آلي وإضافي على كل مواطن لم يستطع بيع عقاره بأكبر الأثمان الملاحظة في سوق العقار. ومن زاوية العدل، والقانون، إذا كانت إدارة الضرائب لا تتوفر على حجج ملموسة، وقابلة للتأكّد، فلا يحق لها أن تفرض ”تقويما ضريبيا“ آليًّا على كل مواطن باع عقاره بثمن يقلّ عن الثمن الأعلى (للمتر المربّع) الملاحظ في سوق العقار في منطقة معنية. وإلاّ سيكون هذا ”التقويم الضريبي“ الأتوماتيكي سلوكا استبداديا، وغير عادل، حيث أنه يَـنْبَنِي على أساس اتِّهَام غير مثبوت.
وتفرض إدارة الضرائب ما تُريد من ضرائب. لأن إدارة الضرائب هي في نفس الوقت ”طَرَفٌ“ معني، و ”حَكَمٌ“ في النّزاع. وإذا لجأ المواطن إلى المحكمة، ستهزمه لا محالة إدارة الضرائب. لأن الدولة وضعت قانونا خِصِّيصًا لبلوغ هذا الهدف. وتستعمل إدارة الضرائب منطق ”الحُجَّة المُسْتَبٍدَّة“ (حيث تقول لك: «حُجَّتُك خاطئة وغير قانونية، وحجّـتي هي الحجّة الصّحيحة والقانونية، لأن سُلْطَة اتخاذ القرار تُوجد بين يَدَيّ»). وقد يحدث هكذا بعض الإساءة في استعمال السّلطة (abus de pouvoir). لكن هذا لا يهم، ما دام الشعب شَارِدًا، وخاضعًا.
5- هل يغرق المغرب بالتدريج في ”إفلاس اقتصادي“؟
السّر الذي يُـفسّر هذه الكمّية المتزايدة من ”الوجبات“ و”الضرائب“ الدّورية التي يؤدّيها مالكو السيارات وغيرهم من المواطنين، يأتي من ظاهرة عامة، وهي أن الدولة تدخل شيئًا فشيئًا في نوع من ”الإفلاس الاقتصادي“ الشّمولي، حيث لا تجد الدولة من حلّ سوى الزيّادة المتواصلة في ”الضّغط الجِبَائِي“ على المواطنين. والدليل على وجود هذا ”الإفلاس الاقتصادي“ هو ظاهرة: التَزَايُد المتواصل في ”الضرائب“ و”الوجبات“، والتَنَاقُص المستمر في ”الخدمات العمومية“ (مثل التعليم، والصحة، والتكوين المهني، والعدل، والنقل الجماعي، والبنيات التحتية، إلى آخره). والعنصران اللذان يجعلان هذا ”الإفلاس الاقتصادي“ غير محسوس بعدُ، هما: أولًا القروض الخارجية التي تلجأ إليها الدولة، والتي بلغ حجمها في سنة 2017 قرابة 82 في المائة من الناتج الداخلي الخام( ). الشيء الذي يؤكّد، ومنذ عقود، أن المغرب يستهلك أكثر ممّا ينتج. وثانيا: العُمُلات الصّعبة التي يدخلها المغاربة العاملون بالخارج. ولولا وجود هذين الموردين، لكان شعب المغرب يعيش في أزمة اقتصادية أكثر إِيلَامًا.
ونجد أن ”الضّغط الضّريبي“ الإجمالي (pression fiscale) في المغرب يقترب من نظيره في أكثر البلدان تـقدّمًا في العالم (قرابة 50 في المائة من دخل المواطن)، أو يفوقه أحيانًا، بينما الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة بالمغرب هي هزيلة، أو رديئة، أو مُنعدمة، بالمقارنة مع مثيلاتها في تلك البلدان. وهذا وضع مقلق. وما هو سببه؟ سببه هو أن جزءا هامّا من الضرائب التي تجمعها الدولة يذهب إلى جيش ضخم من موظفي الدولة و”خُدَّامِهَا“، على شكل أجور سَخِيَّة، وتعويضات، وامتيازات، وعَلَاوات، وَرِيع، وتقاعد، ومعاشات مريحة، رغم أن هذا الجيش من الموظفين يبقى رديئًا، وطُفَيْلِيًّا، ولا ينتج أشياء ذات فائدة لعموم المجتمع. ومن طبيعة جيوش موظفي الدولة أنها تخلق لنفسها أشغالًا شكلية، ومهام عديمة الفائدة. ويمكن أن نحذف 60 أو 70 في المائة من جيوش الموظفين، دون أن يتضرّر الشعب.
وماذا يفعل المواطن عندما يشعر بتزايد غلاء المعيشة ؟ يصبر، ويقول: الحمد للّه، هذا ما أراد الله. ثم يتخلّى الشعب عن شراء عدد من الحاجيات الضرورية التي كان يشتريها، فتنـقص مبيعات متاجر وشركات ومصانع متزايدة. فيدخل الاقتصاد في دورة من الرُّكُود. والرُّكُود يُغَذِّي التخلّف. وتزايد التخلّف يؤدِّي إلى الانحطاط. والانحطاط يُحدث انهيار المجتمع.
يمكن رفض أطروحة ”الإفلاس الاقتصادي“ السّالفة الذّكر. لكن، إذا كانت نسبة المواطنين المنتِجين تـتناقص، أو تبقى راكدة، وإذا كانت نسبة المواطنين الذي لا ينتجون شيئا تـتزايد، فإن مستقبل المُجتمع سيكون بالضرورة خطيرًا.
6- مجلس مدينة الدار البيضاء يحول حديقة عمومية إلى مِرْآب
أخذت أعداد السيارات الجديدة تتزايد في المغرب بشكل مهول منذ قرابة سنة 2015. وذلك بسبب المنافسة فيما بين الشركات العالمية المنتجة للسيارات، وبسبب انخفاض أثمنة السيارات، وبسبب إقدام الأبناك على انتهاز هذه الفرصة لتقديم قروض رخيصة لشراء السيارات. بالإضافة إلى سبب احتياج بعض المواطنين (الحاملين لعقدة الدُّونِية)، إلى التَّفَاخُر فيما بينهم، عبر التّباهي بامتلاك أشياء باهظة الثمن، ولو لم يكونوا أثرياء، مثل التفاخر بامتلاك هاتف منقول ذكي، أو بالسيارة رباعية الدّفع، أو بالسكن من الدرجة الفخمة، إلى آخره. وذلك إلى درجة أن مدنا كبيرة مثل الدار البيضاء أصبحت مكتظَّة بكثرة السيارات.
وأصبح قَطْع مجرد مسافة 6 أو 8 كيلومترات بالسيارة داخل مدينة كبيرة مثل الدار البيضاء يتطلب قرابة ساعة أو أكثر من السياقة، في ظروف متوتّرة، وفي طرق مزدحمة بالسيارات. وأصبح وقوف السيارات عند ”الضوء الأحمر“، في ملتقيات الشوارع، يتطلب ما يتراوح بين 2 و 5 دقائـق. وازداد توثّـر الأعصاب أثناء سياقة السيارة في المدن. وتكاثرت حوادث السير، والكوارث الناتجة عنها. وتَضَخَّمَ التلـوّث الكيماوي الناتج عن ما تُفرزه السيارات من غازات ومواد كيماوية أخرى، إلى درجة أن نصف أطفال المدن الكبيرة، مثل الدار البيضاء، غَدَوْا يعانون من أمراض في الجهاز التنفسي. والدولة تُخفي حقائق التلوّث الكيماوي على المواطنين. ولا تقوم بواجبها من أجل مواجهته.
ولو أصبح ثمن السيارة رخيصًا نسبيا، لا يُعقل أن تشجّع الأبناك، أو الدولة، سكان المدن على شراء أو امتلاك سيارة شخصية خاصة. فمن غير المعقول، ومن غير الصِحِّي، أن يستعمل كل شخص من سكان المدن سيارة خاصة للتنقل. والحل الأكثر عقلانية، هو تنمية النقل الجماعي، مثلا عبر حافلات صغيرة أو متوسّطة.
والمعضلة هي أنه لم يعد بمستطاع أصحاب السيارات أن يجدوا مكانا لإيقاف سياراتهم في وسط المدينة، أو محيطه. وماذا تفعل الدولة؟ وماذا تفعل ”المجالس المحلية المُنْتَخَبَة“، في هذه الظروف المأساوية؟ إنها غائبة، أو غارقة في رداءتها المعتادة. والشعب هو نفسه لا يبالي بما يحدث له، ولا حتى بما يضرّه.
وفي هذه الظروف، وبهذه المناسبة، تجب الإشارة إلى أن ”مجلس مدينة الدار البيضاء“ (تحت قيادة ”حزب العدالة والتنمية“) أراد أن يُشيِّد مرآبًا (parking) لوقوف السيارات الفخمة في وسط مدينة الدار البيضاء. وبدلا من أن يشتري ”مجلس مدينة الدار البيضاء“ بقعة أرضية خصوصية لكي يبني عليها عمارة تُستعمل كَمِرْآب (مُتعدّد الطبقات)، فضّل المجلس السّطو على جزء من حديقة عمومية، هي ”حديقة الجامعة العربية“، وَحَوَّلَه إلى مِرْآب (Parking) تحت أرضي لوقوف السيارات الفخمة. (وهذا الجزء من الحديقة كان يُسمّى ”ساحة نِيفَادَا“، ويـقع عند تقاطع شَارِعَيْ الراشيدي والحسن الثاني. وقد سبق أن سُوِّيَت أرضه، ثم حوِّل إلى مساحة لألعاب الأطفال، واليوم حوّله ”مجلس المدينة“ إلى مرآب للسيارات). ولماذا؟
طبعًا لِجَمْع المال عبر ”حَلْبِ“ مَالِكِي السيارات! وهو قرار، أقلّ ما يُقال عنه أنه مُتَخَلِّـف، وغير قانوني، وغير شرعي، وغير دستوري. لكن هذا لا يهم في المغرب. وما هو دور ”المجالس المحلية المنتخبة“؟ هل هو الزيادة في المساحات الخضراء داخل المدن الكثيفة، أم هو تقليص مساحة الحدائق العمومية إلى حدّ إزالتها نهائيا؟
المهم، خَلَاصْ، لو لم تستعمر فرنسا المغرب، لما وجدت حدائق عمومية في مدنه. لأن مجمل الحدائق العمومية الموجودة في مدن المغرب هي من إنجاز الاستعمار الفرنسي. ومنذ حصول المغرب على استقلاله، لم تنجز الدولة المغربية حدائق عمومية جديدة ذات أهمّية في المدن. لكن هذا لا يهم، فَمَا دام الشعب نائما، وخاضعًا، يستحق أن تُسْلَبَ منه كل الحدائق العمومية.
قد يقول البعض: «خَلاص، اقتطاع جزء صغير من حديقة عمومية، مَا شِي مُشْكِلْ»! لكن إذا تمعّـنا في تاريخ هذه الحديقة العمومية (حديقة الجامعة العربية)، سنجد أن أطرافًا متعدّدة سبق لها أن استولت على أجزاء من أرض هذه الحديقة العمومية. أبرزها : الدرك الملكي، ونادي لكرة القدم، حصلا على بُـقعتين أرضيّتين على شارع علي ابن أبي طالب، والجيش الملكي حصل على بقعة على شارع الحسن الثاني، ومقاهي خصوصية متعددة استعمرت بقعًا شاسعة على جانبي شارع مولاي يوسف (الذي قسم الحديقة بشكل بشع إلى قسمين)، ومركز للشرطة بدأ يبني فوق بقعة صغيرة على شارع الحسن الثاني، إلى آخره. وداخل الحديقة، تُقطع الأشجار القديمة، ولا تعوّض بأشجار شبيهة، والشبّان يلعبون كرة القدم أينما أرادوا، إلى درجة أن الحديقة تتحوّل شيئا فشيئا إلى مجرّد فضاء فارغ. فمتى ستأتي حكومة شجاعة، وتفرض إفراغ كل هذه البقع الأرضية المغتصبة من هذه الحديقة العمومية؟
7- تـفويت الجماعات المحلية للأداء عن وقوف السيارات يتنافى مع الدستور
مِمَّا زَادَ في تفاقم الأشياء، أن ”الجماعات المحلية المنتخَبة“ أعطت في عدّة مدن، امتيازَ تحصيل أداء ثمن يقابل وقوف السيارة بجانب رصيف شوارع وأزقة هذه المدن، إلى شركات خُصوصية (Horodateurs). فيؤدّي مالكو السيارات 2 درهم للساعة الواحدة من الوقوف. والغريب هو أن هذه ”الجماعات المحلية المُنتخَبَة“ لم تستشر المواطنين النّاخبين، ولم تحصل على موافقتهم، قبل بيع هذا الامتياز (horodateurs) للشركات الخصوصية. كأن ”الجماعات المحلية المنتخبة“ تبيع إلى شركات خصوصية حق ابتزاز (chantage) السكان المالكين لسيارة.
وبعد ذلك، تتصرّف هذه ”الشركات“ كَالْمَافْيَا (mafia)، وتمنح لنفسها حق إصدار الأحكام على المواطنين، ومعاقبتهم، وتكبيل عجلات سياراتهم بِقَبْقَاب من حديد (sabots)، وتفرض عليهم بالقوة غرامات مالية مرتفعة. وهذا السلوك يَـتَّصِفُ باستبداد ”المجالس المحلية“، وبِـ ”استبداد الشركات“ الخصوصية، ويتناقض مع القانون، ومع الدستور، ويؤكّد غياب دولة الحق والقانون. وهو سلوك يدخل ضمن سياسة توزيع ”الريع الاقتصادي“. وهو منهج يوثّر المجتمع، ويخرّب الاقتصاد، ويكثر من الفاعلين الطُّفَيْـلِـيِّين (parasitaire)، ويسحق المواطنين البسطاء. ولكن لماذا لا، ما دام الشعب جاهلا، أو غافلا. والشعب يستحق هذه المعاملة الخشنة، لأنه هو الذي انتخب ممثلّين رديئين، وانتهازيين.
(حُرّر في الدار البيضاء، في 5 يناير 2018).