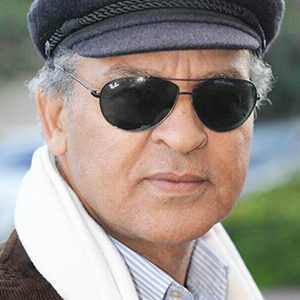المجتمع المدني والبيئة: الإلتباسات النظرية والعوائق السوسيولوجية

التفكير في ارتباطات المجتمع المدني مع قضايا البيئة هو في الواقع انشغال راهني قياسا باستحضار زمن التشكل. يندرج التناول ضمن ما يُسمى ب“سوسيولوجيا التنظيمات“. ولئن كان الاهتمام حديثا، فإن مصفوفات هذا الغلاف قد راكمت محاولات جادة وعميقة تجعلنا نقترب من تداخلات المجتمع المدني مع القضايا الكبرى من جهة، ومن الإحاطة بالمداخل النظرية العامة التي تُفضي إلى تحليل مظاهر التغير الاجتماعي والثقافي في مدارات المجتمعات الانتقالية من جهة ثانية.
آراء أخرى
ماذا يُقصد بهذه المجتمعات؟ القصد بها المجتمعات التي لا تزال تحتضن في أنسجتها استمرارية الأنساق التقليدية في أشكال مدنية حديثة. ومن داخلها تتداخل العناصر الثابتة والمتحولة، المتصلة والمنفصلة. باختصار، الإحالة إلى المزاوجة بين التقليد والتحديث.
وعلى أي، لقد اعتبرت إشكالية النهوض من معضلة التأخر التنموي منذ منتصف القرن الماضي محور جُل تدخلات المجتمع المدني بهدف تذليل فجوة التفاوت، وتجسير التأخر التاريخي، واستكمال شروط وآليات بناء الدولة المدنية الحديثة؛ دولة التنظيمات والمؤسسات والهياكل القانونية. وعلى قدر الأهمية المثلى التي تحظى بها العملية التنموية كانشغال مركزي بالمغرب وخارجه، فإنها لم تعد تخضع اليوم للعشوائية والارتجالية، وإنما أصبحت توظف استراتيجيات تنبني على التخطيط والحكامة بشكل يتيح تحقيق غايات محددة.
من داخل هذا التمهيد يمكن فرز جملة أسئلة، وهي أسئلة تسائل المنجز المدني في علاقته مع الشأن البيئي من قبيل: هل استكمل الفضاء المدني بالمغرب شروط المواطنة؟ وهل استوعبت النخب الجمعوية شروط الترافع عن الساكنة وأولويات المطالب؟ ألا يعيق تصحر النسق السياسي وتكلسه الفكري تشكل الفضاء المدني؟ هل التجربة التاريخية الجمعوية بالمغرب ناجزة للقيام بمداخل أولية للتفكير في أسباب العطب وعسر التحول في سوسيولوجيا التنظيمات؟ هل يمثل الفضاء الجمعوي العمق المجتمعي؟ أم يعكس إخفاقات الانتماء السياسي وفشل المشروع المجتمعي؟ وهل الترافع عن البيئة اليوم يشكل ثرفا أم ضرورة كونية في مجتمع لم يستكمل بعد نضاله الحقوقي؟
وجب الاقرار في البدء بأن علاقة المجتمع المدني والبيئة مركبة، ملتبسة، وعلى قدر كبير من التشبيك، وتحتمل جوانب متعددة للتفسير والتحليل، إذا وضعنا بعين الاعتبار تعدد المداخل. يعسر على الباحث تشخيص الوضع تشيخصا علميا دقيقا. نحن أمام علاقة تحمل نوعا من الإلتباس النظري فيما يتصل بتأصيل نشأة مفهوم المجتمع المدني ضمن حلقات الثرات الفلسفي للفلسفة الليبرالية…يقترح البعض ضرورة العودة إلى أعمال الرواد الأوائل، وخاصة طوماس هوبس وجون لوك، وأعمال الفيلسوف الفرنسي جون جاك روسو وغيرهم…وهي مداخل عامة رصدت تحولات ومخاضات بناء المجتمع الديموقراطي من منطلق تأسيس نظريات التعاقد الاجتماعي، وجعلت للمجتمع المدني سلطة التغيير، وأيضا سلطة الرقابة والتأطير والمواكبة…لكن، علينا أن نتفق على أن هذه الأدوار قد تنتعش كما قد تخفت تبعا لكيفية توزيع السلط داخل الدولة، وتبعا لفاعلية مؤسسات التنشئة الاجتماعية، ونضج الفاعلين السياسيين والاجتماعيين حول شروط ممارسة اللعبة الديموقراطية. أَوَ ليس المفاهيم الكبرى التي نصادفها في حياتنا العامة، في المدرسة والشارع، في الجامعة والإعلام…سليلة “صدمة الغرب/ صدمة الحداثة” جاءت مع حملة نابليون بونابرت على مصر في بداية القرن التاسع عشر، وخلقت بالتالي، نوعا من الاهتزاز الوجداني والحضاري، وزادت منه الانكسارات العكسرية في محطتي اسلي 1844م وتطوان 1859م…استمر هذا الزخم في شكل تحولات عميقة مع تبلور منظومة الحماية الأجنبية على المغرب التي ستهشم مختلف البنيات التقليدية بمغرب المخزن والقبائل والزوايا…وبمغرب التويزة والتضامن العضوي، وستؤسس مغربا جديدا تمت هندسته في دهاليز إدارة هوبير ليوطي، تشريعا وممارسة. منذئذ اتقتحمت الفضاء العام خطابات/ مفاهيم جديدة في مدارات الرجة الاستعمارية.
يتغدى سؤال علاقة المجتمع المدني بالبيئة من لحظة الانعطاف الكبرى التي وسمت خطاب المجتمع السياسي الدولي، من ارتباط قضية البيئة بالانشغالات الكبرى للإنسانية وللوجود، التي أضحت هما مشتركا، وقلقا ماكروحضاريا، يهم جميع المجتمعات، شرقا وغربا، على المستوى الرسمي أو الشعبي، تفسره عدة معطيات، وضع كهذا يطرح تساؤلا جوهريا حول موقعنا كمجتمعات عالمثالتية ضمن هذا النقاش الكوني؟
يلاحظ المتتبع للشأن السوسيولوجي على مستوى استقراء وتأصيل تاريخانية ولادة سوسيولوجيا التنظيمات ارتباطها بعلم الاجتماع الصناعي من خلال أعمال ألتون مايو وهنري فايول وفريدريك تايلور التي اهتمت بدراسة سيكولوجية الطبقات العمالية، واقتربت من أحاسيسهم وسلوكياتهم في المصانع الامريكية ودرجة تأثيرها على مردودية الانتاج الصناعي. ضمن نفس السياق، يمكن تتبع التشكل من خلال أعمال الأنتربولوجي المغربي عبد الله حمودي بالمغرب التي يمكن اعتبارها اطارا مرجعيا لمحاولة تفكيك ومقاربة نشأة التنظيمات الجمعوية بالمغرب من خلال تساؤل مركزي حول ثنائية الاتصال والانفصال التي تميز البناء المدني بالمغرب. يتساءل حمودي حول الفكرة التي اعترضت تبلور رؤية مدنية فاعلة، ومؤثرة، قادرة على بناء مشروع مجتمعي يقود الفرد المغربي نحو الانخراط في مشاريع التنمية ويساهم بشكل مُواطن ومسؤول في قيادة التغيير المنشود.
من زاوية الاسطوغرافيا السوسيولوجية، يلمس قارئ الانتاج السوسيولوجي بالمغرب راهنا تناسل عدة أبحاث ودراسات تهتم بسوسيولوجيا العمل الجمعوي، وترصد مونوغرافياته تحولاته، هوياته، ثقافاته، وانعطافاته…وهي انتاجات تأمل في محاولة الامساك بشروط الممارسة الجمعوية بالمغرب، وتحاول أن تشخص المطبات والاخفاقات، وعسر الاندماج في خلق ثورة مجتمعية قادرة على تحريك المياه الآسنة، مياه الزمن الرثيب، أو ما يسمى بالبنية الممتدة بتعبير مناصري مدرسة الحوليات الفرنسية.
يشكل مفهوم المجتمع المدني هاجسا نظريا لمختلف الأدبيات السوسيولوجية التي تتشوف نحو تتبع صيرورة نشأة المفهوم. والحال، أن مبحث سوسيولوجيا التنظيمات نما وتطور في حضن سوسيولوجيا المقاولة وعلم الاقتصاد الرأسمالي التي كانت وقتها في حاجة إلى فهم ميكروسوسيولوجي لديناميات اشتغال الجماعات، والكشف عن أسباب تعتر وتراجع الانتاج الناتج عن انقسامات العلاقات الاجتماعية من جهة، ولغاية جعل المجتمع المدني يساهم في الاقتصاد المحلي والوطني على غرار الاقتصاد الاجتماعي التعاوني من جهة ثانية.
تفضي المعاينة إلى الاقرار الآتي: فقر نظري وعجز عن إبداع ممارسة مدنية ديموقراطية نقدية جديدة، بأساليب ووسائل تتفاعل مع امال وانتظارات المجتمع. فالتجربة الديموقراطية بالغرب اعتبرت الفكر المدني أس البناء الديموقراطي، فكر مدني يضع مسافة بين الفرد والمؤسسات السياسية، بعيدا عن خطاب التماهي والاندماج من أجل ضمان استدامة النسق، فالعمل الجمعوي يمتح في اشتغاله من نواقص مجتمعية مقلقة، غياب التربية على التفكير، وغياب الحرية، وضيق مجال الممارسة، وبؤس السياسة أمام سطوة التكنوقراط، “فالسياسة طاغية على الكل، والكل سينجر الى الحضيض” كما عبَّر عن ذلك المفكر المغربي عبد الله العروي في خواطره الصباحية، دون أن ننسى فشل مؤسسات التنشئة الاجتماعية في التربية المدنية، من الأسرة إلى المدرسة والجامعة. ثمة فضاء مدني تشغله تكنولوجيا الإعلام، ينتج تشوها اجتماعيا، فباختزال المعرفة في المعلومة يتقوى السمع واللمس والمشاهدة ويضأل التفكير. فهل وجود جمعيات ينهض دليلا للقول بوجود فكر جمعوي؟
السؤال يضع التجربة الجمعوية بالمغرب على المجهر، ثم ألم تعمل الأحزاب السياسية على تعثر نضج هذا الفضاء المدني؟
المجتمع المدني وفق ما يجب أن يكون ممارسة يومية، خيار اجتماعي، رهان سياسي ضد الدولة الشمولية من أجل تقييد سلطتها التنفيذية، وليس مجتمع يعمد إلى تجميل التشوهات وينتج خطابات التآخي والتأييد والمجاملات…عندما يكون القول مفصولا عن عمق الفعل، فإننا قد نتكلم كثيرا ونمارس قليلا كما قال جون زيغلر؛ وحينما نختزل الديموقراطية والفضاءات الجمعوية في بُعد تقني صرف، تصير علاقة الدولة بالمجتمع ملتبسة تشوبها علاقة اليقظة والاحتراس ومحاولة الابتلاع، وممارسة التحكم في كل مداخل الفعل الجمعوي، وإضفاء صبغة السياسة على كل مُنجز مدني…إننا بصدد ممارسة مدنية تروم التزكية لا النقد، التطبيع لا الإبداع، في غياب أرضية مُوحدة للترافع، وانقسامات الفاعلين. مجتمع مدني يعيد انتاج خطابات المجتمع السياسي، وهناك محاولة لتشييد بنية بئيسة على بساط المجتمع المدني. لماذا لم يتجدر فكر الاختلاف في البنية المغربية (سؤال المعيقات) وكيف يمكن تجديره في هكذا واقع (سؤال الممكنات)؟
علينا أن نعيد مراجعة وقراءة معنى المجتمع المدني، وأن نُحدد أهدافه واختياراته الكبرى، هل هو وسيلة للترافع عن قضايا وآلام المقصيين من مركب التنمية أم أنه آلية للارتقاء نحو المناصب والتدرج نحو المجتمع السياسي؟
بالنهاية، المشهد الجمعوي بالمغرب أفرز ثلاث ثقافات التي بدورها يمكن تكثيفها في ثلاثة خطابات: جمعيات سياسية، جمعيات تكنوقراطية، وجمعيات قبلية…وفي غياب أو ضعف المشهد الإعلامي الذي لم يؤسس لجدال عمومي بناء، وغيب مساهم في انتاج فكر مدني يخترق الفضاء العمومي…يظل الغائب الأكبر من مسيرتنا التاريخية هدوء الفكر وعمقه وجرأته، والحاضر، التشويش على المعنى وقلب الحقيقة، ورسم الأوهام…
ومهما ما قد يبدو للبعض الحضور الوازن لتيمة البيئة ضمن أجندة الشأن العام بالمغرب، فإنها تبقى هامشية قياسا بحجم النقاش والتدافع المدني الذي يحقق المصالحة مع الواقع الايكولوجي الهش. لا يمكن أن نفهم هذه الهامشية إلا من مقترب هشاشة الأرضية النظرية لمؤسسات وفاعلي المجتمع المدني…يمثل الترافع حول البيئة وانشغالاتها الحارقة المعبر نحو بناء وتنشئة الإنسان في عالم متغير وسائل أيضا…عالم تحركه المصالح والرهانات الكبرى لمن هم فوق… البيئة كما هو واضح من صاحب النضال البيئي بيير رابحي Pierre Rabhi تندرج ضمن رهانات القوة، وضمن كبرياء العظمة وعلياء الاستقواء.
مع السبعينات، بدأ خطاب البيئة ينتعش تدريجيا في زمن تقاطب الإيديولوجيات، الرأسمالية الأمريكية في مواجهة الاشتراكية السوفياتية، حينما جثمت البشرية أنفاسها مخافة اندلاع مأساة انسانية جديدة، تذكر بطيش الانسان وبلاعقلانيته الجامحة وبربريته السادية، فاتجهت الأنظار نحو اتفاقية سالت Salt النووية لكبح هذا الجموح البشري، واستيقظ العالم على فاجعة تشرنوبيل ليكتشف حجم الدمار الذي أنتجه بنفسه. منذ تلك اللحظة تقاطرت الأسئلة حول المداخل الممكنة لإعادة مصالحة الإنسان مع الأرض، وبدأ النقاش حول التفكير في عقد القمم والمؤتمرات البيئية التي تُوسع من دائرة التفكير، وإشراك الكل في النقاش. لكنها، نقاشات تسير بإيقاعات متفاوتة، تسطع وتضمر، هنا وهنالك، حسب رهانات المصالح وتجاذبات القوى الجيواستراتيجية لعالم أنهكته الحسابات، وأضنته الخلفيات السياسية التي جعلت الفضاءات المشتركة بين الانسانية محور نقاش وجودي، بغض النظر عن الانتماءات العرقية والدينية والمزايدات السياسية والإيديولوجية. لقد غرست الرأسمالية عقلية الفردانية الجشعة في الوجدان البشري، وزكتها قيم اقتصاد السوق…من هنا يمكن أن نفهم الأصوات التي كانت تتحدث عن موت المجتمع المدني في زمن عولمة الاقتصاد، وخاصة تحليلات مدرسة شيكاكو السوسيولوجية الأمريكية…العولمة حوَّلت العالم إلى كازينو غارق في الفوضى، وقد يراها البعض “فوضى خلاقة” باستعارة من كونداليزا رايس، لكنها تظل فوضى مؤسسة لتهلهل السدى الاجتماعي، ومؤدية إلى تحلل الروابط التضامنية، التي جعلت الكل يبتنى القيم البراغماتية المرتبط باقتصاد السوق…عالمنا اليوم أضحى يسأم من المجانية والإحسان، ويقبل على العمل المأجور.
يمكن فهم علاقة الشذوذ بين الانسان والبيئة، بالاشتغال على الذات، ومقارباتها نفسيا، لمحاولة إعادة الإنسان إلى عمقه البيولوجي وأصله الحضاري، ومصالحته مع الأرض/الأم، بإعادة النظام العام للأشياء، بإقامة ثورة كوبرنيكية في الفكر والسلوك الانساني تجاه البيئة، غير ذلك، سنردد كثيرا سؤال ادغار موران، إلى أين يسير العالم؟ ونردد معه نظرية الارتطام بالحائط، كنظرية تشهد على هذا الإصرار الممنهج لما تبقى من توازنات المنظومة البيئية. فصناعة الحروب، وصناعة الأغذية المسرطنة، وصناعة الأمراض كلها تعبير عن الاستقواء الذي يبيح كل شيء.
في سياق آخر، تسير المقاربة الحقوقية نحو اعتبار الحق في البيئة يدخل ضمن شبكة الجيل الثالث من الحقوق الأساسية، في لحظة يشهد العالم على تأخر مجتمعات عالمثالتية في استكمال شبكة حقوق الجيل الأول، ففي المغرب مثلا لازال النقاش الحقوقي لم يستكمل بعد بخصوص أعطاب الذاكرة السياسية، وتجاذبات سنوات الجمر والرصاص، فهل أصبح النضال حول البيئة زفير المضطهدين؟ وقضية من لا قضية له؟ بعد موت وتصحر بعض القضايا النضالية؟ وكيف يمكن لعالم مشدود بالانقسام أن يتوحد حول المأساة؟ أم أن النقاش حول البيئة يشكل حلقة من حلقات استراتيجيا الإلهاء؟
تحتاج البيئة إلى إرادة مدنية صلبة، وإرادة سياسية وحقوقية من أجل الترافع عن حق الانسان في العيش؛ إرادة كونية تختزل مكنونات الذات البشرية فطريا في الاستقواء. يجب على البشرية أن تُنصت إلى حكماء الأرض، إلى منتقدي سياسة الغرب المتوحش، كما عليها أن تراهن على إعادة بناء مدخل القيم الاجتماعية، فهل نقبل بالذئب حارسا لأحلامنا، كما قال الروائي جورج أورويل في رائعته مزرعة الحيوان؟ وهل نقبل بمغرب يحضر نفسه للهاوية؟ إن أخطر أصولية تُهدد وجودنا في هذا العالم هي أصولية السوق، التي تختفي في قناع ناعم وبارد “العولمة“، علينا أن نعيد بناء “ميثاق جديد مع الأرض“، علينا أن نقوم بفضح امبراطورية العار المتوحشة التي تصنع الفقر المهيكل، والتي تجعلنا نتسابق نحو اشباع الفانتزمات التدميرية. وعليه، فبشرية عالم اليوم لم تلد بعد الإنسانية“.
البيبليوغرافيا:
1- مصطفى صفوان، عدنان حب الله، اشكاليات المجتمع العربي، قراءة من منظور التحليل النفسي، المركز الثقافي العربي، الطبعة الاولى، 2015.
2- الصادق النيهوم، فرسان بلا معركة، ثالة للطباعة والنشر، 2010.
3- امحمد مهدان، السوسيولوجيا القروية بالمغرب، مقاربات وقضايا، 2013.
4- برهان غليون، نقد السياسة، الدولة، والدين، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية،2011.
5- ايمانويل ليفنانس، الزمان والاخر، ترجمة وتقديم، جلال بدلة، معابر للنشر، 2014
Pierre Vermeren , Ecole, Elite et pouvoir au Maroc et en Tunisie au 20 siècle, alizes,20036-
7- جاك لوغوف، التاريخ الجديد، ترجمة وتقديم، محمد الطاهر المنصوري، المنظمة العربية للترجمة، 2011.