
أمريكا والشرق الأوسط
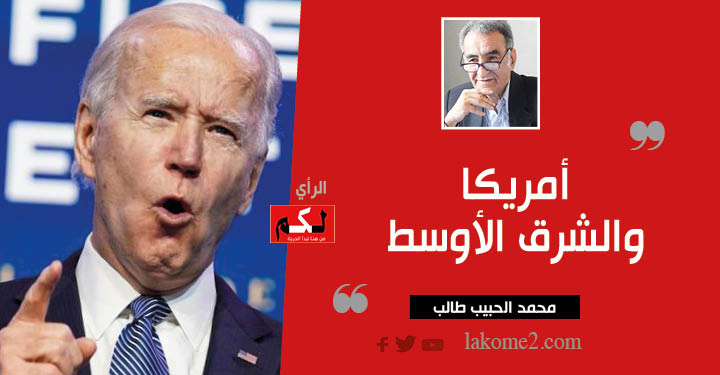
يشكل الشرق الأوسط البؤرة العالمية للتوتر العالي، فهو حلقته المركزية، وساحة الوغى لحروب متواصلة، وعليه يتوقف مستقبل السلم العالمي، كما كان في الماضي وكما هو عليه الى اليوم.
آراء أخرى
قد يبدو هذا التقدير، ليس هو الظاهر في الاختيارات الأمريكية الجديدة، فالأولوية لديها لمحاصرة التصاعد الاقتصادي الصيني، وعزل روسيا وخصوصا عن حلفائها الأوروبيين، لاسيما وأن أمريكا لم تعد بنفس الحاجة لاستيراد بترول المنطقة، بعدما أضحت من البلدان المصدرة له. لكن التحكم التجاري في منابعه ومساراته يظل مع ذلك، وسيلة للتحكم في حاجيات الدول له، وفي الحفاظ على مركزية الدولار في التعاملات الدولية، وطالما ظل (البترول ) لعقود قادمة المادة الرئيسية في استعمالات الطاقة عالميا.
وليس جديدا، أن العامل الآخر الذي يشد أمريكا إلى الشرق الأوسط، حماية إسرائيل، وضمان تفوقها، باعتبارها الأداة الضاربة لكل ما تبتغيه. وفي هده المسألة أيضا، قد يبدو الظاهر، أن لأمريكا أفضليات مصلحية أخرى لا تتطابق كل التطابق مع تركة ترامب في هذا الشأن، ولا مع الميولات والسياسات السائدة في إسرائيل .
ومرة أخرى، الظاهر لا يغير بتاتا من مكانة إسرائيل في الاختيارات الإستراتيجية الدائمة للولايات المتحدة، وكيفما كان القيمون على إدارتها.
تذكيرنا بهذه الحقائق الأولية المعروفة، يتوخى التشديد على أن ليس كل ما تخططه أمريكا لنفسها ، وكل ما تضعه من أولويات منتقاة بحسب ما تمليه مصالحها الجيوبولتيكية ومخاوفها البعيدة ، في ظروف مستجدة معينة، هي ذات الدينامية التي تجري بها صراعات الواقع.
فالواقع هو دائما أكبر وأعقد تشابكا من أي اختيار مسبق، فما بالك إذا كانت الولايات المتحدة كما أسلفنا القول في المقالة السابقة، تتخبط في “وضع استرتيجي دفاعي “رغم كل مظاهر القوة التي تبينها وتنطق بلسانها. ولدلك، فهي مجبرة على أن تنكب، أولا وأساسا، على“إيجاد حلول” لبؤر الصراع في المنطقة، تخرجها من ورطاتها وتخفف أعباءها الثقيلة عليها، وهي جميعا باتت ذات طابع دولي ، ولا تنفصل بالمرة عن صراعها الأوسع مع الصين وروسيا “العدوين الرئيسيين” لها.
في الحيز المتاح ، سأتطرق ، فقط ، لما يرتبط بالساحة العربية ، وفي مقدمته ، الاتفاق النووي وبعده في مقالة قادمة، سأتطرق إلى الحرب في اليمن ، ومآلات القضية الفلسطينية. وكالعادة، ليس ما يهمني تزويد القارئ بحزمة من المعلومات والوقائع المتوفرة لديه في جميع الأحوال، إلا بالقدر الذي يستهدف بناء المنطق السياسي، إما دعما أو نقدا. ولعل المدخل الأصوب لذلك ، التعرف ولو بسرعة على ما أتت به إدارة بايدن من جديد في القضايا السابقة ، لكن قبلها ، أذكر القارئ بما كتبته في مقالتي السابقة (تعليق سريع على فيلم أمريكي طويل ) من أحكام في توصيف الاستراتيجية ألأمريكية القديمة (ترامب) والجديدة (بايدن). وكانت أحكامي كالتالي:
أولا : إنها بحكم أطماعها الأمبريالية، هي على الدوام إستراتيجية حولاء تغلب على عقلانيتها البرغماتية مصالحها في الاستتباع والسيطرة، ودائما على حساب العقلانية ( الجديرة بهذا الإسم) الإنسانية العادلة.
ثانيا: أن مجمل بؤر النزاع في الشرق الأوسط هي من اصطنعها بالمباشر أو غير المباشر، والادارة الجديدة تحاول، بعد أن تمادت الإدارات السابقة عنها في توثيرها الى الحد الأقصى، أن تجد لها مخارج بأقل الخسارات على مصالحها واستراتجيتها الدولية.
ثالتا : على الرغم من اختلاف الأساليب بين إدارة ترامب (الهجومية والانعزالية) وبين إدارة بايدن( الدبلوماسية والتحالفية) ، فإن الطابع العام للوضع الاستراتيجي الفعلي للولايات المتحدة وحتى قبلهما، انها في وضعية دفاعية تصبو للحفاظ على مركزية انفرادها بقيادة العالم في مواجهة التصاعد الصيني والروسي المزاحمين لها.
تأخذني الأحكام السابقة الى الوقوف قليلا على نوع من الأدبيات السياسية العربية، تجد انتشارا متزايدا لها لدى شرائح واسعة من المثقفين في أجواء الإحباط النفسي الذي تولده بالضرورة الاوضاع العربية الراهنة.
ملخص هذا النوع من الخطاب السياسي، ان منه من يُعبر عن تمزق وجداني صادق، بفعل ما وصلت إليه الشعوب العربية من تراجعات مفجعة ومتتالية، ومنه من يستغل هذا الوضع النفسي الجماعي، لكي يجعل منه حالة مطلقة ثابتة ودائمة، ولامخرج آخر لها سوى بالاستسلام والتخلي عن كل المبادئ التحررية بدعوى أنها جُربت وتقادمت وهُزمت وغدت من المتاع الزائد للغة الخشب. إن هذين النوعين من الخطاب السياسي اللذين ينهشان جسد النخب العربية بوجه عام، يصبان، بصرف النظر عن النوايا الوجدانية لكل منهما، في تعميم طريقة في التفكير تعدم الممارسة النضالية الممكنة ، والعقلانية وحدها ، لإحداث التراكمات الضرورية للخروج من وضعية التراجع المهول الى الوضعية السوية للتقدم .وما يثير في هذا الشأن ليس منْ اختاروا عن إرادة وتصميم المضي إلى النهاية على الطريق، الذي لا كلمة تجمع شتى ألوانه سوى الطريق، النيوليبرالي، الذي أبهرتهم أضواؤه الجاذبة الراهنة، فلهؤلاء تفسير موضوعي، كإفراز أيديولوجي واجتماعي لابد منه في مراحل التراجع. ما يثير في الحقيقة أولئك الذين عن صدق وجداني يئسوا من شدة تلاحق التراجعات، وأعمت عيونهم كثرة الملابسات ودوام الاحتجازات. هؤلاء فقط أحسب أن الخلاف معهم في طريقة التفكير لا في الغايات التي نصبو إليها جميعا.
عطب تلك الطريقة في التفكير، أنها تنطلق من حالة التراجع الراهنة كحصيلة ثابتة ودائمة ونهائية. وبالتالي تضع كل التناقضات والاختيارات السابقة التي “إنتهت” الى هذه الحصيلة في سلة واحدة، تتساوى جميعا ، أكانت رجعية أو تقدمية أو وسطية، وفي جميع اختلاف المراحل، لتجعل من هذا الخليط الفاقد للصيرورة الموضوعية صفرا في حصيلتها العدمية .
ولذلك، لا تقدم هده الطريقة في التفكير أي جواب ملموس، نظري أو عملي، للمستقبل. سوى أنها تدعو بنرجسية ثقافية الى القيام بقفزة نوعية عملاقة، هنا والآن ، وإلا فالمصير إلى مزبلة التاريخ . ومن أين لنا بهذه” القفزة النوعية العملاقة، هنا والآن!” اذا ما أعدمنا صيرورة التناقضات ونوعياتها في ظروفها العينية كما جرت ، وتجري ، في الواقع ؟! اليس في هذه الدعوة شيء من الفكر السحري !؟
ربما يقربنا المثال التالي البسيط (والذي احتفظت به ذاكرتي مند الصغر) من فهم هذا الإشكال المعقد و الكبير. قرأت مرة في إحدى المجلات السؤال التالي: أثبت أن إثنين كرتي ثلج + ثلاث كرات ثلج أخرى= صفرا . وكان الجواب، أن الكرات الخمس ذابت وبالتالي صارت صفرا وليس خمسة. ونسي هدا الجواب، أنه استعمل خدعة منطقية، لأن ذوبان الكرات المفترض يعني تغيير المعطيات في المعادلة السابقة. وهدا هو عطب المنطق العدمي الذي يلغي البحث في الصيرورة والتمرجل وطبيعة كل من التناقضات العديدة والمختلفة على أكثر من صعيد ، ليخلص في النهاية الى نتيجة عدمية صفرية يعتقدها شبه ثابته ونهائية، مادام تجاوزها مستحيلا إلا بقفزة نوعية عملاقة، آلياتها غير موجودة أصلا في تصوره للمكونات الحاضرة مجتمعا ودولة وأحزابا سياسية ونخبا وطبقات اجتماعية إلى آخر القائمة ! فهل واقعنا العربي، وعلى الرغم من شدة تراجعه المزمن، هو كذلك؟
سأضع في هده المقالة مآل الأنفاق النووي في الصدارة، مع أن ايران ليست دولة عربية، لكنها إحدى الدول الصاعدة الدور في المنطقة، وشريك تاريخي لأكثر القوميات عطاءا في بناء أوج الحضارة العربية الاسلامية. ومآل الاتفاق النووي بحد داته، سيكون له الأثر البعيد على أوضاع الشرق العربي بوجهه عام، وعلى أبعد منه بكثير.
ولعله من المفيد، هنا ، التذكير بالكيفية التي استقبل بها العالم العربي الثورة الايرانية ، وهي أكبر ثورة شعبية في الربع الاخير من القرن العشرين . والملفت في هذا السياق ،أن الاستقبال جرى في ظروف عربية جد ملتبسة، حكمت التباساتها العلاقات العربية الايرانية الى اليوم. واختصارا لأهمها: خروج مصر السادات من الصراع العربي الاسرائيلي بإقرار اتفاقية كمبدافيد، وخروج المقاومة الفلسطينية، بعدها بقليل ، من لبنان في خضم حرب أهلية واجتياح إسرائيلي لأول عاصمة عربية. ومن هذه الزاوية بدت الثورة الايرانية المعادية ” للاستكبار الأمريكي والغربي عامة” ، والمشبعة عقائديا وشعبيا بحق الشعب الفلسطيني في تحرره الوطني، وكأنها “هبة من السماء” جاءت لتعوض فراغا استراتيجيا أحدثته اتفاقية كمبدافيد، وعونا جبارا للثورة الفلسطينية، أسقط أعتى وأقوى نظام في المنطقة حليف لإسرائيل ، لم يحلم بسقوطه في ذلك الوقت أي خيال عربي ثوري. لكن الجانب المضاد في التباسات الوضع العربي وقتها،“سيتسرطن“( من السرطان) بفعل عاملين: من جهة، بداية سطوة الأنظمة العربية المحافظة والمتحالفة مع الولايات المتحدة على القرار العربي الرسمي، وقبلها، وبتشجيع منها ، تسارع إنتشار الايديولوجيات الدينية التقليدية، سميت بعدها” بالصحوة الإسلامية “في كافة المجتمعات العربية، ومثَّل التحشيد الجهادي في افغانستان لمحاربة الحليف السوفياتي النذور الاولي لما سيأتي من تنظيمات إرهابية لاحقة.
ومن جهة ثانية ، نجحت الولايات المتحدة في إشعال الحرب الخليجية الأولى بين العراق والنظام الايراني الوليد لاحتواء النظامين في حرب ضروس دامت لسنوات أنهكت النظامين معا. والأخطر، أنها فاقمت الميولات الثقافية المذهبية الشوفينية الدفينة في عمق تاريخ الأيديولوجيات الدينية التقليدية. وفي هذا الإحياء لماض سحيق، والذي كانت تستبطنه الثقافة الدينية الشعبية، والرسمية، ما من مواطن، كيفما كان تموقعه الايديولوجي، إلا وطن في أذنيه شيء من تلك الثقافة الراسبة التي نشأ عليها في مجتمعه وأسرته. إنها الكارثة الثقافية / الأيديولوجية بكل المعاني!
واذا كان لابد من تشخيص مّا لهذه الالتباسات ،فيمكن إجمالها في المحيط العربي كالتالي :
• الأنظمة العربية في معظمها خشيت من هذه الثورة، ومن ما تحمله، كأي ثورة شعبية كبرى، من تداعيات سياسية وثقافية ستأكل من شرعيتها. وما كان بوسعها ،قبل الحرب وبعدها، إلا أن تستثمر ما لديها من قوة مذهبية عددية كبرى تقيها و تصد بها الرياح الآتية من أقلية مذهبية ممركزة في إيران!
• الحركات الاسلامية، ولها تاريخها المستقل السابق عن الثورة الايرانية، والتي كبر صيتها، واستفادت من الانكناء الديني المجتمعي، و من حاجة الأنظمة المحافظة إليها، تعاملت لمرحلة مع الثورة بحس برغماتي وحذر مذهبيا، لكن سرعان ما انضوت في الخيار المذهبي والسياسي (الخليجيي– التركي) ما أن فتحت أمامها أبواب السلطة بسماح غربي ومحلي، فكان لابد من تكيفها مع هذه الاستراتيجيات جميعا.
• الحداثيون الليبراليون ( والأصح النيوليبراليون) ، وهو اتجاه نما وتضخم خصوصا بعد انهيار ما كان يُطلق عليه “المعسكر الاشتراكي” وانتصار العولمة الرأسمالية عليه. هؤلاء يقزمون الصيرورة التاريخية الوطنية، أينما كانت، في مسألية واحدة: شكل النظام السياسي الذي ينبغي أن يكون على شاكلة النمودج الغربي، وبأي تحالف متاح كيفما كان نوعه ودوره، وإلا كان البلد خارج التاريخ. هؤلاء لا يعطون أي اعتبار لكل القضايا الأخرى التي تُفضي إلى التقدم والتحرر الوطني، وبالتالي لا يعطون أي اعتبار إلى أن صيرورة التحديث والتقدم قد تأخذ أشكالا ملتوية نابعة من تطور المؤهلات المجتمعية ولها وظيفة تاريخية تحديثية لمرحلة ما. أليس مدهشا أن يتباكى هؤلاء على ما يحسبونه “تحديثا” في عهد الشاه على سطحيته وزيفه الاجتماعي والتقدمي عامة، كما تباكوا، أيضا، على الليبرالية المهترئة والفاقدة للسيادة الوطنية قبل عبد الناصر وعلى الضد من تقدمية نظامه.
وليس بعيدا، فتجربة ما سمي بالربيع العربي في أكثر من بلد تبين لنا ظلامية الأفق الذي تؤدي اليه هذه الرؤية التبسيطية الاختزالية الفاقدة بالمطلق للحس التاريخي. وفي جميع الأحوال، فلقد بات من المؤكد، أن التحديث بأوسع مجالاته، لابد له من تواصل ثقافي إيديولوجي مع الثرات الثقافي للأمة، وأن اشكاليتنا الاسلامية بوجه عام تكمن في أن مجتمعاتنا لم تصل بعد إلى الصيغة الأرقى لهذا التفاعل التحديثي بين الموروث الثقافي الديني والثقافة الحداثية المعاصرة، وهذه اشكالية مفتوحة على التطور، ولاتجب أو تُغلق كل الابواب الاخرى للتقدم.
في هذه الأوضاع العربية الجامعة لخليط من المشاعر بين العدائية والحذر و التشوش والمعارضة، تجاه النظام الايراني وملفه النووي جاء بايدن بخطواته التالية:
من جهة، أكد في الملموس، أن الملف النووي له الأولوية في خياراته الشرق أوسطية، اذا ما أراد تحريك استراتيجيته العالمية إزاء الصين وروسيا. ومن جهة ثانية، أفصح وإدارته غير مامرة عن التزامهما بالعودة الى الاتفاق النووي الذي تخلى عنه ترامب، وأن الطريق إلى ذلك ليس إلا الطريق الديبلومي، لكنهما تركا هامشا مطاطا من الغموض للضغط والمناورة الديبلوماسية، في ما يخص، هل ستكون العودة التزاما حرفيا بنص الاتفاق، أم أنها ستكون لإدخال تغييرات عليه، تضيف تمديد المدة الزمنية لاشتراط نسبة تخصيب اليورانيوم في %3.5 والتي تنتهي في 2025، ومع إدراج الصواريخ الباليستية، وما تعتبره أمريكا أدرع ايرانية مسلحة في سوريا والعراق ولبنان وفلسطين (واليمن ايضا) المهددة لمصالح أمريكا وحلفائها وللأمن والاستقرار في المنطقة.
وكما هو التصور العام في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة، فإن “قوة التحريك” ستعتمد أساسا على استعادة التحالفات الدولية التي خربها ترامب، وفي مقدمتها تمتين التحالف مع الاتحاد الاوروبي.
وفي هذا الشأن بادرت المفوضية الأوروبية بتقديم مقترح عقد لقاء تحاوري غير رسمي للأطراف الخمسة التي وقعت على الاتفاق. لكنها تُلقي بالمسؤولية أساسا على إيران لما تعتبره خطوات تصعيدية، ردت بها إيران، و بعد طول إنتظار، على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وعلى عجز الدول الأوروبية في تنفيد ما في عهدتها منه. ولا عجب في هدا الانحياز الديبلوسي للدول الأوروبية المعنية بما التزمت به، لأنها لم تستطع أن تمارس باستقلالية عن العقوبات الأمريكية، ولأن لها ارتباطاتها البنيوية مع أمريكا وعلى أكتر من صعيد، ولها هي الأخرى مصالحها الثانوية الخاصة في بلدان المنطقة، وفي إضعاف الدور الإيراني كلما أمكنها ذلك. لكنها، تظل هي الأقرب إلى التمسك بما كان في الاتفاق مع لعب دور الوسيط ولو بانحياز محدود للجانب الأمريكي.
أما الرد الإيراني بوجه عام، فلقد كان على وعي مسبق. بما سيواجه العودة إلى التطبيق السليم للاتفاق من صعوبات داخلية أمريكية، ومن مناورات تستدعيها الحاجيات الأمريكية لضبط اعتوارات إستراتيجيتها أللامتوازنة بين مجموع ملفات المنطقة.فهي تريد الاتفاق مع إيران، لكنها تريد في نفس الآن، ألا يكون الاتفاق انتصارا لها : يسوق إلى تقوية مكانتها وأدوارها في الشرق الأوسط. وأمريكا تجد نفسها متورطة في جميع بؤر الصراع في المنطقة وتبحث لكل منها عن مسلك خاص يخفف الأعباء عنها بشرط ألا يخل بالتوازن العام الذي تريده في المنطقة. وهذا ما يفسر لنا التخبطات التكتيكية الواضحة التي تعاني منها الإستراتيجية الأمريكية الشرق أوسطية. فبجانب أنها مع الاتفاق النووي تناور علها تضيف إليه مكاسب أخرى. وبجانب أنها مع الوقف الفوري للحرب في اليمن، ولأسباب إنسانية، تُبقى على الحصار الشامل المضروب على شمال اليمن بكل ما يفشيه من جرائم أللاإنسانية فاقعة. وفي سوريا والعراق، تزيد من قواتها المسلحة في البلدين، وتعيد انتشارها للبقاء فيهما لزمن أطول، وهي تعرف جيدا، أنهما بؤرتين قابلتين لتفجير يورطها في أية لحظة في حرب تقلب كما تزعم من حسابات الدبلوماسية في تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة! ونفس التخبط سنتعرف عليه في لبنان وفلسطين. ألم تقل أن المطامع الامبريالية حبيسة لعقلانية برغماتية قاصرة وحولاء على الدوام!
لكل تلك الالتباسات، كان الرد الإيراني قطعيا وصارما:
• إيران غير مستعجلة لعودتها مع الجميع لما تم الاتفاق عليه، رغم جسامة العقوبات عليها.
• وترفض أية إضافة جديدة على نص الاتفاق كما هو. ولا نقاش بالمرة على قدراتها العسكرية الدفاعية، ولا إدماج لملفات إقليمية أخرى تخص سيادة بلدانها.
• كل الخطوات التصعيدية التي قامت بها للدفاع عن حقوقها المشروعة، و بما يسمح به الاتفاق نفسه في حالة الإخلال به، إيران على استعداد للتراجع عنها فور التزام الجميع بنصوص الاتفاق، وفي مقدمتها إلغاء جميع العقوبات.
• ومن تلك الخطوات التصعيدية، إعلان إيران أنها قادرة على تخصيب اليورانيوم بدرجة ستين في المائة وما فوق، بعد رفعها النسبة إلى العشرين في المائة المخصبة حاليا. ومنها أيضا، تعليق التفتيش المباغت لوكالة الطاقة الذرية الوارد في البروتوكول الإضافي الطوعي معها. ومع الاحتفاظ بمخزون كاميرات المراقبة لمهلة ثلاثة أشهر ليقرر بعدها في مصيرها..وشرط أن تلتزم الوكالة بالمهنية والحياد، وإلاستعيد إيران النظر جذريا في العلاقة معها.
الرسالة الإيرانية المضادة التي تحملها تلك المواقف الصارمة، مفادها، إذا لم تكن الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون على استعداد للعودة إلى الاتفاق النووي كما هو،فإيران هي الأخرى قادرة على المضي الى النهاية في المشروع النووي مهما كانت التضحيات والتحديات التي ستواجهها( وعلى نفسها جنت براقش الأمريكية ! )
هذا المنعطف الحرج والدقيق، يعود بنا إلى التصور الأصلي للحزب الديمقراطي الأمريكي من المسالة الإيرانية التي طال الصراع خلالها لأربعين سنة خلت، دون أن تتمكن أمريكا وبجميع الوسائل من الوصول إلى غاياتها. الطريق الذي نهجه ترامب بالضغط والعقوبات القصوى سوف لن يؤدي إلا إلى الصدام العنيف والحرب. وهذا مآل مكلف للغاية، وقد يؤدي إلى إشعال المنطقة برمتها. ولذلك، يبقى الرهان من الاتفاق النووي على الاحتواء في المدى البعيد. إذ كيفما استفادت إيران منه، فلا مناص له من أن يُفضي إلى تفكيك العصبية الوطنية التي تشد إليها بقاء النظام في مجموعه، كيما تُشرع الأبواب لنمو التناقضات الاجتماعية الداخلية ذات الأهداف الديمقراطية الليبرالية، ومن تم ستتمكن “الوسائل الناعمة” من الاختراق الاجتماعي السياسي الداخلي، كما الشأن مع الصين وروسيا والبلدان الأخرى، لتؤتي ثمارها المضاعفة وبأقل تكلفة. فالاحتواء على المدى البعيد هو الحل. ولذلك من المرجح أن تعود إدارة بايدن إلى هذه الجادة، ما لم يزداد حولُها وطمعها الامبريالي الدائم!














