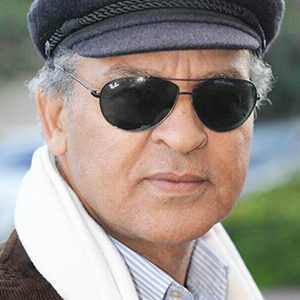مراجعاتٌ في الفكر والسياسة
(1)
آراء أخرى
عنوان هذه المقالة هو الاسم الذي اخترته لكتابي الأخير، الذي هو قيد المراجعة والإخراج، والذي سيظهر في نشرته الرقمية الأولى في شهر نونبر القادم، إن شاء الله.
يضمّ هذا الكتاب مقالاتٍ كتبتها بين سنتي2010 و2014، ناقشت فيها بعضَ المبادئ التي يقوم عليها المنهاجُ السياسي لجماعة العدل والإحسان، وانتقدت فيها أيضا بعضَ الاختيارات التي ما تزال الجماعةُ تتشبث بها في تدافعها السياسي.
لقد رأيت، بعد طول نظرٍ وتأملٍ وتردّد، أن أجمع هذه المقالاتِ في كتاب، لتكون سهلةَ التناول لكل من يعنيه الأمر، مِنَ المهتمين بالفكر السياسي للحركات الإسلامية عموما، وبالمنهاج السياسي لجماعة العدل والإحسان خصوصا.
لقد ناقشت الاختيارَ السياسي للجماعة، وانتقدت منه ما رأيت أنه يستحق النقد والتقويم، وذلك من أجل المشاركة-فيما أظن وأقدّر-في خلق نوع من الحيوية الإيجابية البناءة على مستوى نقد الفكر السياسي الإسلامي، وأيضا من أجل تسجيل ما أدّتني إليه تجربتي الشخصيةُ الطويلةُ في العمل السياسي الإسلامي من ملاحظات وانتقادات ومراجعات، وخاصة فيما يتعلق باجتهادات الأشخاص وآرائهم ونظراتهم، التي هي من بنات الظن والترجيح، وليست من المعتقدات القطعيات المطلقات التي لا يملك المرء إزاءها إلا التصديق والتسليم.
سجلت في هذه المقالات ملاحظاتي وانتقاداتي وآرائي التي كوّنتُها عبر تجربة ونظر، ومخالطةٍ وممارسة، ومعاينةٍ ومتابعة، لا أدعي فيها أن ما أقوله هو الحق والصواب، وإنما هي مقالاتٌ قائمة على العرض والتحليل والنقاش والنقد والترجيح، قد أكون فيها أصبت بعضَ الحقيقة، وقد لا أكون، لأن الموضوع السياسيَّ من الموضوعات التي تتعدد في شأنها الآراء والأفهام، وتتباين في تناولها زوايا النظر، وتختلف مناهجُ الاجتهاد وموجباتُ الترجيح والاختيار، ومن ثَمَّ، فإن مقياس الحق والباطل، مثلُه مثلُ مقياس الإيمان والكفر، لا يفيد شيئا في تقويم الفكر السياسي ونقده، لأنه سيكون مقياسا في غير طائل، لأن الفكر السياسيَّ الاجتهادي هو من الأعمال المباحة ما دامت الأصولُ العقدية محفوظة، والثوابتُ الإيمانية والمبادئ الأخلاقية مرعية ومعتَبَرة.
في جملة، مقالاتُ هذا الكتاب تُدافع عن التحرر من الإمعيّة والتبعية والتقليد الأعمى، بل إنها تُذكِّر بأمرٍ بديهيٍّ في مجال السياسة، بشقيها التنظيري والتطبيقي، وهو أن الجمودَ قاتلٌ، والتقليد مُخلِق ومُتلف، لأن السياسةَ، فكرا وممارسة، بطبيعتها، تأبى التحجُّرَ والتحنُّطَ والتكريرَ، لأنها مجال يمتاز بالحركة الدائبة، والتدافع المتجدد، والطوارئ والمفاجآت التي لا تكون في الحسبان.
(2)
هل هناك من فرق بين “المراجعة” و”النقد الذاتي”، أم هما بمعنى واحد، أم أحدهما عام والثاني خاص بتجربة بعينها؟
أنا في مقالات هذا الكتاب لا أرى أن المسألة المتعلقة بمفهومي “المراجعة” و”النقد الذاتي” ذات أهمية، ولذلك أكتفي باستعمال كلمة “مراجعات” متضمِّنة معنى النقد الذاتي، لأن من المعاني التي تحيل عليها كلمةُ “مراجعة” في اللغة، معنى المُعاودة والمساءلة وتجديدِ النظر والتدقيق والتمحيص والتصحيح والنقد.
والمراجعة، في شأن الأفكار والمواقف، قد تحصل بتغيّر جذري، أو بتغيّر جزئي، أو بتعديل في بعض المواقف دون أخرى، أو بتطوير في بعض الأفكار وأساليب العمل، أو بنقد للذات وتصحيح بعض الأخطاء، إلى غير أولئك من المبادرات والسلوكات التي يمكن أن تُعدّ في المراجعات. وإذا عُرف المقصود، فلا مُشاحَّة في العبارات.
إني أعتقد-وهذا رأيي على أي حال، وقد أكون مخطئا فيه-أن التنظيم الذي لا يراجِع نفسه من حين لآخر، ويقوِّمُ اختياراتِه، حسب الواقع، بملابساته ومتغيراته ومستجداته، ولا يقبل بالنقد الذاتي، هو تنظيم آيل، عاجلا أو آجلا، إلى التعثر والاضمحلال، وهذه سنة كونية، ولنا في كتاب العالم أمثلةٌ ناصعة للدرس والاعتبار. والذي أعرفه أن جماعة العدل والإحسان لم تدّع، في يوم من الأيام، أنها فوق المراجعة والنقد، وأن منهاجها هو منهاج مقدس ومعصوم لا يجوز عليه ما يجوز على الاجتهادات البشرية من إمكانية المراجعة والتعديل والتطوير.
هذا هو الأصل والمبدأ الثابت؛ ما من فكر بشري، مهما بلغت درجتُه في الفهم والفقه والصحة والرجحان، وكيفما كانت مكانةُ صاحب هذا الفكر في الدين والعلم والإبداع والإحسان، إلا وهو، بطبيعته البشرية النسبية، قابل للأخذ والرد، والنقد والنقض، والمراجعة والتغيير والتحوير والتطوير.
لكن الإيمان بالمبدأ والتنويهَ به في الكلام والأوراق والخطب والشعارات شيءٌ، والعمل به والتصرف على ضوئه في واقع الممارسة واتخاذ المواقف وحسم القرارات شيءٌ آخر.
(3)
ما تزال كتابات المرشد عبد السلام ياسين، رحمه الله، عموما-ومنها كتاب “المنهاج النبوي، تربية وتنظيما وزحفا” بوجه خاص-تمثل المرجعَ الأسمى لاختيارات الجماعة ومواقفها السياسية.
ومنهاج الجماعة، في الحقيقة، منهاجان متداخلان متعانقان متلازمان، أحدهما تربوي إحساني، والثاني سياسي نضالي. ومعنى كونهما متداخلَيْن متعانقَيْن متلازمَيْن أنهما صادران عن شخص واحد، تصوّرا وتفكُّرا وتنظيرا وتأليفا، وهو الأستاذ المرشد عبد السلام ياسين، رحمه الله.
وإذا كان الشأنُ التربوي، في منهاج الجماعة، هو الأساس الذي عليه البناء، وهو الأصل الذي إليه تَرجع كلُّ الفروع، فإن الشأن السياسي، في كتابات الأستاذ المرشد، وخاصة في كتبه التي تُوصف بالأمهات، قد ارتبط، في نشأته وتطوره ونضجه، بالشأن التربوي ارتباطَ التابع بالمتبوع، يلازمه ولا ينفكّ عنه.
وهذا الارتباطُ الجوهريّ البنيويُّ بين التربويّ والسياسيّ، في كتابات الأستاذ المرشد، يطرح، في تقديري، قضيةً إشكاليّةً في الفكر السياسي الإسلامي الحديث، عموما، وفي منهاج جماعة العدل والإحسان، بوجه خاص، وخاصة بعد وفاةِ المرشد، رحمه الله، ومصيرِ المسؤولية عن تراثه إلى من خلَفَه على رأس الجماعة، من قيادات الصف الأول، يمثلهم، أولا وأساسا، مجلسُ الإرشاد، وفي درجة ثانية ثانوية، الأمانةُ العامة للدائرة السياسية، التي يرأسها عضو من مجلس الإرشاد.
هذه الإشكاليةُ، في كلمة مختصرة، هي أن الأمر السياسيّ، بطبيعته، أمرٌ اجتهاديٌّ متغيّر، لأنه يقوم على النظر والظن والترجيح. أما الأمر التربويُّ، فهو في لبّه وطبيعته، راسخ في الديني الإيماني الغيبي، ولا شأن له بالاجتهاد، إلا في طرق التنفيذ، ووسائلِ العمل، وضوابطِ التنظيم، وهي أمورٌ لا تمسّ الأصولَ القطعية التي ينبني عليها العمل التربوي، وخاصة ما يرجع منها إلى القرآن الكريم والسنة الشريفة المطهَّرة.
فأصول التربية الإيمانية الإحسانيةِ ثابتة راسخة محفوظة، مهما تبدلت الظروفُ والأحوال، ومهما غفل الناسُ وفرّطوا، ومهما غلا الغالون، وتشدد المتشددون، وأفْرط المفْرطون، وألحد الملحدون، ولها اللاهون الفاسقون الظالمون. لكن الشأن السياسيّ، بطبيعته المشار إليها، وخاصة في جانبه النظريِّ الفكري، لا يمكن أن يوصف بالثبوت، إلا إن اعتبرناه تراثا محفوظا انتهى مِن السلف للخلف، وعَمَلاً من الأعمال المنجَزة، التي تشهد على زمانها، كما تشهد على اجتهاد صاحبها وأسلوبه في النظر والفقه والاستدلال والاستنباط. أما أن يصبح هذا الفكرُ السياسيّ الاجتهاديّ، القائمُ على الظن والترجيح، والمظروفُ بظروف صاحبه وواقعه وزمانه وأحوال هذا الزمان، مرجعا لكل زمان ومكان، ومعيارا “مطلقا” “متعاليا” لمعالجة كل أمور السياسة المتغيرة، اليوم وغدا، فذلك عين المستحيل، لأن طبيعة الفكر السياسي الاجتهادي تأبى هذا، وترفض أن يتحول المظنون إلى أصل قطعي، كما ترفض أن يتحول الرأي الناقص إلى حقيقة مطلقة كاملة.
فهناك فرق كبير، مثلا، بين معارضةِ النظام الملكيّ بخلفيّة سياسية، وبين أن تعارضَه بخلفية دينية؛ ففي المعارضة الأولى، أفكارٌ تقابلُ أفكارا، واجتهادٌ يقابل اجتهادا، وفكرٌ بشريٌّ يعارض فكرا بشريا، وفي المعارضة الثانية، عقائدُ في مقابل عقائد، وإيمانٌ بإزاء إيمان، ونصوصٌ “مقدسة” تعارضُ نصوصا أخرى “مقدسة”.
المعارضةُ السياسية فيها مجالٌ واسعٌ للحوار والتفاهم والتقارب والتعايش-هذا حينما تكون الظروف طبيعيةً، والأجواءُ سليمةً، والحقوق والحريات مرْعِيّة؛ أما في ظل الاستبداد والقمع والمنع والقهر، فالحُكم مختلِف. أمّا المعارضةُ الدينيةُ، فالأمر فيها إما مع الدين أو ضده، وهذا هو المدخل الواسع للتكفير والتقتيل والترهيب باسم الدين ومقدسات الدين.
ولعل المطابقةَ بين الشأنين التربويِّ والسياسيِّ، وجعلَهما متلازمَيْن، في منهاج جماعة العدل والإحسان، هو-في تقديري-السبب الرئيسيُّ وراء الكثير مما يطبع أنشطة جماعة العدل الإحسان اليوم، من جمود وانحسار وعزلة وانغلاق، في مجال التدافع السياسي، وكذلك في مجال التواصل مع مكونات الساحة السياسية المغربية، من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.
نعم، الاستبدادُ هو علّةُ العلل التي تسوم حياتَنا السياسية مِنْ كل ألوان الظلم والفساد والتخلف والتأزم والتعثر والاختناق، ومع ذلك، فالنقد الذاتيُّ واجب في جميع الأحوال، وإلقاءُ المسؤولية، كلِّ المسؤولية، على عاتق الاستبداد (النظام الجبْري)، هو، عندي، نوع من التهرب من واجب مواجهةِ الذات ومراجعة المواقف، وتقويم الاختيارات، لأن من أسهل الأمور، في السياسة وغيرها، أن تبقى متقوقعا في اتهام الآخر، وتستقيلَ وتستريحَ من كل ما يمكن أن يكلّفه النقدُ الذاتيُّ من حرج وأعباء ومسؤوليات.
(4)
الأصلُ في الفكر السياسيّ أنه فكرٌ ظنيٌّ اجتهاديٌّ ترجيحيّ، لا علاقة له بالقطعيات والمطلقات والمقدسات. وقد يُرجِّح الفكر السياسيُّ اليوم ما يردُّه غدا، وقد يستحسن الفكرةَ والرأيَ ويقبلهما في ظروف معينة، ويستقبحهما وينفيهما في ظروف أخرى مغايرة؛ وهكذا، لا يستقر الفكرُ السياسي على حال واحدة في جميع الظروف والأحوال، بل هو متغير بحسب هذه الأحوال، وإن بقيت الأصولُ والثوابت والمبادئ والكليات التي يقوم عليها الاجتهاد والترجيح هي هي، في جميع الأحوال والملابسات.
ومن هنا يجب التنويهُ بالقواعد التي استنبطها الأصوليون، والتي جعلوها بمثابة الموازين الثابتة في عِيار الأفكار وترجيح الأحكام، والتمييز، عند النظر والاجتهاد، بين الأصل الكلي الثابت، وبين الفرع الجزئي المتغير.
لقد اجتهد الأستاذ عبد السلام ياسين، رحمه الله، لزمانه، وكَتب ما كتب، منتقدا ومُنظّرا ومحلِّلا ومرجِّحا، وهو، في كل ذلك، لم يدَّعِ أن ما كتبه لا يجوز عليه النقدُ والمراجعةُ والتطويرُ والتمحيصُ، بل صرح بالعبارة الواضحة التي لا تقبل التأويل، أن ما كتبه إنما كان أقصى ما وصل إليه نظرُه واجتهادُه، ولِمَن سيأتي بعده أن يجتهد لزمانه، ويزيد وينقص، ويحوّر ويطور، بحسب ما يستجد من معطيات، ووفق ما يشهده الواقع من تغيرات وتحولات.
فكيف أصبح “المنهاج النبوي” منهاجا فوق النقد والتطوير والتحوير؟ ومَنْ هذا الذي قضَى أنّ فكر الأستاذ المرشد السياسيَّ الظنيَّ الاجتهاديَّ هو المقالة الفصلُ التي تنتهي عندها المقالات، وهو الاجتهادُ النهائيُّ الذي تقف عنده الاجتهادات، وهو الرأي القاطع الذي يَجُبُّ جميعَ الآراء؟
من حوَّل فكرا بشريا إلى صنمٍ مقدَّس؟
من حوّل تراثا سياسيا غنيا أراد له صاحبُه أن يكون مفتاحا للاجتهاد والإبداع والتحرر إلى فكر محنَّط جامد منغلق؟
إني هنا أتحدث عن فكر سياسي، لا عن هذا الشخص أو ذاك؛ فمقالاتي تدور حول أفكارٍ سياسيةٍ، تُراجعُها وتناقشُها وتنتقدها على أساس أنها أفكار اجتهادية، تصيب وتخطئ. وهل يمكن للمفكر العالم الفقيه المجتهد أن يخطئ؟ نعم، وذلك بصريح العبارة في الحديث المتفق عليه المشهور عن الحاكِم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد. فالمجتهد المصيبُ والمجتهد المخطئُ كلاهما مأجور، لأن خطأ المجتهد لم يكن في أمر ممنوع محرم، ولا كان خطأ مقصودا، وإنما كان في أمر فكري علمي فقهي ترجيحي استنباطي، فاستحق الأجرَ، وإن لم يُصِب، لما يكون منه من جهد وتقصٍّ في النظر وتتبع الأدلة واستعراض الأشباه والنظائر وسائر ما يتوسل به المجتهد لتحرير الدليل واستنباط الحكم.
(5)
عندنا في المغرب، ما تزال عقدةُ العُقد في العمل السياسي، وبالتحديد عند المعارِضين، هي الموقف من النظام الملكي. هذا من جهة المعارضين، وأما من جهة النظام المخزني، فإن عقدة العقد، في تقديري، هي الاستبدادُ والنظرُ إلى كلِّ مكونات الحياة السياسية على أنها توابع خادمة وأدوات منفذة، ليس لها من الأمر شيء إلا أن تسمع وتطيع!
سيظل مستقبلُنا السياسيُّ في مهبّ الريح ما دام النظام المخزني، وعمادُه المَلكية الوراثية “التنفيذية”، يرفض ألاَّ يرى فِيمنْ حوله إلا أصداءً لإرادته وتعليماته ورغباته، وما دام معارضوه-وأخصّ هنا المعارِضين الثوريِّين-لا يرون لمغربنا السياسي مستقبلا مع بقاء النظام الملكي.
هل من وصفة “سحرية” تضيّقُ الشُّقة بين الطرفين؟
هل عند الناس، في كلا الجانبين، إرادةٌ للبحث عن أرضية للتواصل والتفاهم والتقارب والإصلاح؟
أليس الأمر، أولا وآخرا، سياسةً؟ فإلى متى العَداءُ والتصادمُ والتنافر والتدابر؟
أليس في الناس، أكانوا ملكيِّين مخزنيِّين أومعارِضين ثوريِّين، مَنْ يقدر أن يبدع شيئا-كيفما كان هذا الشيء-يفتح لنا طريقا نحو الخلاص من هذا الداء العضال الذي لا يني يهدد حياتنا السياسية بكل الآفات والمصائب والفتن، داءِ الكراهية والعداوة والتنابذ والتزايُل؟
أنا أعرف أن الطريق إلى التصالح والتفاهم بين المخزن ومعارضيه ليس سهلا، بل إن الأمر، عندي، ما يزال من الأماني البعيدة، وسيظل كذلك ما دامت إرادة التقريب والإصلاح غائبة لدى الطرف القوي المهيمن، الذي هو النظام المخزني، وروحُه الملكية الوراثية التي تسود وتحكم بسلطات وصلاحيات شبه مطلقة، إن لم نقل مطلقة.
ومع كل هذا، فلا بد أن يكون هناك بداية؛ لا بد من خطوة أولى على الطريق للوصول إلى النهاية.
النظامُ الذي لا يقبل من الناس إلا أن يكونوا عبيدا، يسمعون ويطيعون-مع ما تعنيه العبودية من ذل ومهانة وسلب للإرادة-نظامٌ ذاهبٌ، عاجلا أم آجلا، مهما طال عمره، ومهما كان منه، من حين لآخر، من أصباغ ومساحيق ومناورات وترميمات لغرض التمويه والتدليس.
وقد يغُرُّ المستبدَ أن الناس باتوا عبيدا طوع البنان؛ لا، إنه غُرور يشبه السراب، لأن الناس مهما أصابهم من ذل وهوان وصَغار وخضوع للسلطة الغاشمة، فإلى حين، لأن جمرة الحرية والانعتاق والثورة على قيود الاستبداد والاستعباد ستظل كامنة تحت الرماد، تنتظر-وقد يكون الانتظار طويلا، لكن له نهاية مُجزية-من يُذكي لهيبَها ويؤجّج نارها، لتخرج من الضعف والكمون والهمود والخمود إلى الحياة والقوة والتوقّد والتلهُّبِ والأجيج.
إن في الناس دائما، ومهما كانت قوةُ القمع وضراوةُ البطش وفظاعةُ الغَشْم، أحرارا شرفاء أمناء يأبون حياة الدُّونِ، وحياة العبودية المقيتة، وحياة القيود المهينة، ويستشرفون حياة الحرية والكرامة والعزة والاستقلال.
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.