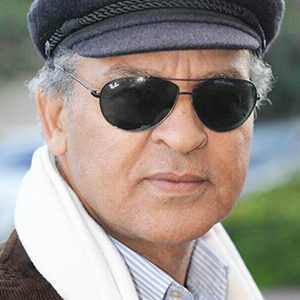اللغة وتدريس العلوم
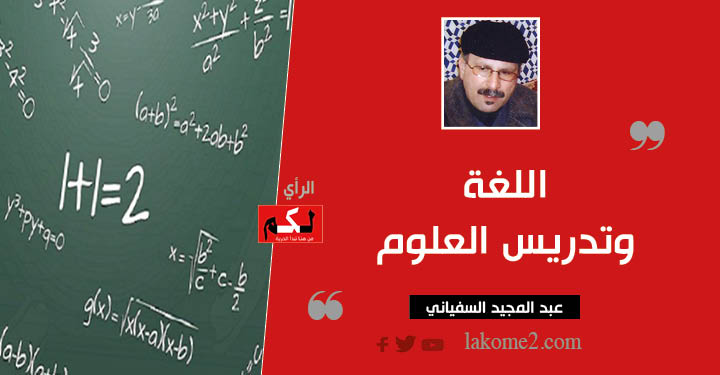
الملاحظ هو أن موضوع اللغة العربية وتدريس العلوم أثار سيلا من التعليقات والمقالات في مختلف وسائل الإعلام المتنوعة . وإذا كان هذا أمرا صحيا ومطلوبا بالنظر إلى أهمية الموضوع ورهاناته وانعكاساته المتعددة على الحاضر والمستقبل، فإن الذي يثير الانتباه هو بعض الضحالات في مقاربات الموضوع والتي لا تشترك إلا في الطعن في اللغة العربية بل والتحامل الفج عليها وعلى أهلها وتحميلها كل شرور النظام التعليمي والثقافي والاجتماعي الراهن، ومن بين هذه الشرور وأهمها ، التخلف العلمي ، مع أنه منذ القديم تقول الآية : “لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى”.
فليس من قبيل العاطفة أن نقول كيف يمكن للأشخاص الذين تربَّوا في حضن هذه اللغة وتعلموا التفكير والتفكير النقدي والحجاجي بها وسلكوا عبرها مراقي المدرسة والدراسة ، وأصبحوا كُتَّابا بها في الآداب والعلوم وكل المعارف الأخرى ، ثم يجحدون بعد هذا ويطعنون في مشروعيتها وقدرتها، مع العلم أن هذه اللغة من أجمل وأدق وأمهر وأمتع اللغات من حيث كفاءاتها وأساليبها التعبيرية :
آراء أخرى
رموني بعقم في الشباب وليتني
عَقِمْتُ فلم أَجزع لقول عُدَاتِي
أنا البحر في أحشائه الذُّرُ كامن ٌ
فهل سألوا الغواص عن صدفاتي
(حافظ إبراهيم)
من المغالطات الرائجة في أيامنا هذه أن اللغة العربية ليست لغة العلوم وغير قادرة على مواكبتها؛ فهي لغة متأخرة أو متخلفة عن العلوم ، لذلك وجب إزاحتها لفائدة لغات علمية أخرى .
1- أولا ، ليست اللغة هي التي تواكب العلوم. هذا طرح تبسيطي وسطحي . إن الذي ينتج ويواكب العلوم هو ثقافة المجتمع وبنياته ومستوى تطوره الاجتماعي
والحضاري . واللغة عنصر في هذه المواكبة .
2- كل اللغات هي أقدم من العلوم ومتأخرة أو متخلفة عنها. فهذه من الحقائق التاريخية والثقافية . وإن مراحل التقدم العلمي هي ما أرست الدعامات لوجود ما يسمى بـ ” لغة العلم “. وبدون هذه القاعدة التاريخية لا يمكن لأي لغة إلاَّ أن تكون متأخرة عن العلم أو العلوم.
3- لا دليل على أن اللغة العربية لا تواكب العلوم في المجتمعات العربية ، وأن التدريس بها أعجز عن استيعاب منطق العلوم والتعبير عن نظرياته ومفاهيمه ؛ والدليل أننا نفهم بيسر أن مفهوم الطاقة والكتلة والسرعة والتسارع والجاذبية هي مفهوم l’énergie و la masse و la vitesse و l’accélération و l’attraction .
ونفهم بيسر أن الزمان والمكان المطلقين وانفصالهما مع ” نيوتن ” ، وأن الزمان والمكان النسبيين ووحدتهما مع ” اينشتاين” ، هو ترجمة لمفاهيم le temps et l’espace absolus où relatifs ………
ونفهم بيسر أن انفصال الكتلة والطاقة مع ” نيوتن” أو وحدهما مع ” اينشتاين” لها مترجماتها المعروفة؛ وأن الذرة والنواة والموجات الكهرومغناطيسية والأشعة الحمراء ومفهوم الأفلاك والجهاز الهضمي والتنفسي أو العصبي … هي مفاهيم تكافئ مفاهيم l’atome – le noyau – les ondes électromagnétiques …؛ بل إن هذه الترجمات العربية تبدو لي أقرب إلى ذهن المتلقي وأيسر وأرفق بالأسماع من بعض مقابلاتها في لغات أخرى. إن مفهوم الجاذبية مثلا هو أكثر جاذبية من مفهوم l’attraction، ومفهوم الجهاز التنفسي أيسر على السمع من l’appareil respiratoire ، وكذلك مفهوم الدورة الدموية أهون وأيسر من la circulation du sang… . ونحن نستطيع أن نقول بأن الماء يتبخر عند الدرجة 100، وأن ارتفاع أو انخفاض الضغط الجوي يتبعه ارتفاع أو انخفاض السوائل في الأنابيب، وأن البارومتر هو جهاز قياس الضغط الجوي ، إلى غير ذلك من القوانين والنظريات العلمية . فأين هو مشكل اللغة العربية مع العلوم إذن؟ .
وحتى حينما لا يجد اللغويون ، وليس اللغة في حد ذاتها، ألفاظا عربية للترجمة أو حتى حينما لا يتوفقون في توليد المصطلح العلمي من لغتهم فإنهم يُعَرِّبون المفهوم وينقلونه إلى العربية مثل مفهوم الإلكترون والفوتون والبكتيريا وغير ذلك. والتعريب هو إمكان من إمكانات اللغة للتعبير عن المفهوم دون تغريب أو عسف . وهاتوا لي لغة لا يوجد فيها ما يشبه التعريب في العربية . إن نظرة على بعض اللغات الغربية مثل الفرنسية وعلاقتها باللسان اليوناني القديم لَتُفَاجِئُنا بذلك التواصل الجيني الوثيق بين اللغتين .
كما يجب ألا يغرب عن بالنا أن لغة العلوم وعلوم اليوم خاصة ، ليست هي لغة الإنشاءات وطبقات المعنى والظاهر والباطن والمحسنات والتأويلات … ، بل هي لغة تقنية محضة تشغل فيها الرياضيات عمدة التفكير والتحصيل والتعبير ، بدءا من H2O إلى أعقد القوانين والمعادلات. والرياضيات كما نعلم جميعا لغة رمزية مجردة وكونية غير منحازة لهذه اللغة الطبيعية أو تلك؛ لذلك فإن ترجمة سياقاتها ليست بالأمر العسير.
ومن المغالطات الرائجة أيضا في الموضوع الذي نحن بصدده ، هو تصنيف اللغات إلى لغات علم تنتج وتستوعب العلوم ، ولغات لا صلة لها بالعلم . وهو تصنيف لا أساس له ولا يمكنه إلاَّ أن يصبَّ في طاحونة الرؤى الاستشراقية العنصرية حول الفكر الآري وقوامه العقل والعلم ، والفكر السامي وقوامه العاطفة والشطحات الخيالية في اللغة والمعرفة . إنه تصنيف لا يوجد إلا في المخيلات ، وذلك لاعتبارات :
1- الاعتبار الأول هو أن اللغة، أي لغة – وكما قلت ذلك منذ زمن – لا تنتج العلوم أو ليست هي التي تنتج العلوم، وإلاَّ لما احتجنا إلى بنيات ومؤسسات وسياسات تعليمية وثقافية واجتماعية وتطور حضاري هو المسؤول عن إنتاج العلوم. إن هذه البنيات والمؤسسات والسياسات هي التي تنتج العلوم وليس اللغة. اللغة أداة تفكير وتعبير عن هذه العلوم بالقدر الذي هي أداة للتعبير عن الفكر الأسطوري والفلسفي والأدبي والديني وغيره.
2- لا توجد علاقة طبيعية بين اللغة والفكر عموما وضمنه الفكر العلمي خصوصا؛ بمعنى لا توجد علاقة طبيعية حتمية بينهما كتلك التي توجد بين النار والحرارة. اللغة نتاج اصطلاح أو مواضعة أو اتفاق كما لاحظ ذلك الدارسون القدماء والمحدثون في الثقافة العربية والغربية. وهذا الاصطلاح هو أساس تنوع اللغات وانتفاء الأصل الميتافيزيقي لها. نتفق على أن هذه الألفاظ أو هذه العبارات تدل على أفكار وموضوعات، فيسري الأمر. وإذا أردنا تغيير هذا الاتفاق وتلك العلاقات بين اللغة وما تدل عليه فليس من مانع يحول بين ذلك . نعبر عن فكرة الشجرة بلفظ الكتاب. ولا يحدث خلل في نظام الأشياء لأن هذا النظام من صنعنا واتفاقنا.
أمَّا الفكر العلمي فهو ليس نتاج اصطلاح واتفاق ذواتي كما اللغة ، مهما كانت لغة هذا التفكير ، بل هو حقائق وقوانين لها استقلالها الموضوعي عن الذوات ، حيث تفرض منطقها على الكل في تعدد انتماءاته اللغوية والثقافية والحضارية . فالفكر العلمي ضروري واللغة اصطلاحية والعلاقة بينهما اعتباطية؛ لهذا لا يمكن القول بـ ” لغة العلم” ولا بأن لغة ما هي لغة العلم دون غيرها .
لذلك فالمسؤول عن التخلف العلمي ليس هو اللغة، بل هو :
1- غياب أو قصور بنيات ومؤسسات وموارد مادية وبشرية كالجامعات ذات الكفاءات ومراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية المتطورة كمًّا وكيفا، ومعاهد الترجمة الحقيقية والمنفتحة على لغات وعلوم العصر، ودور النشر وشبكات التوزيع والإعلام، وصناعة الثقافة وغير ذلك…
2- غياب استراتيجية تحسم في السياسة التعليمية والثقافية والاجتماعية عموما . وكل هذا مرتبط بما سماه طه حسين في ” مستقبل الثقافة في مصر” بخيارات الدولة الوطنية .
هذا هو صلب الموضوع وما يعوزنا وما يجب أن نناقشه ونسلط عليه العرائض لا على اللغة.
إن من أسوأ الإيديولوجيات هو قلب العلاقات والأدوار فتصير الأسباب نتائج والعكس. إن هذا يذكرني بالانتقادات التي توجه عادة لمنظومة التعليم والتكوين باعتبار فشلها الماثل في تخريج العاطلين وانفصالها عن متطلبات سوق الشغل . ونحن نعلم كم عدد المهندسين وذوي التخصصات والكفاءات المتنوعة المطلوبة، هم في بحث وانتظار مملٍّ لفرص الشغل، ثم الهجرة بعد ذلك ؛ وكم هو خصاص الأطباء والممرضين مُهْوِلٌ في مغربنا؛ ونذكر العصي التي انهالت عليهم وعلى غيرهم من موارد التنمية الوطنية قرب البرلمان وبعيدا عنه. ومعنى هذا أننا نتجاهل أو نغفل قصور البنيات الاقتصادية ووسائل تدبيرها المتخلفة وعجزها عن استيعاب حتى خريجي الكليات الموسومة بالفشل التي هي أبعد ما يكون في هياكلها ومؤسساتها وإمكاناتها وبرامجها عن كليات الغرب المتقدمة. فمن المسؤول إذن؟ هل الكليات المنفصلة عن سوق الشغل أم البنيات الاقتصادية القاصرة عن استيعاب الخريجين ؟
إن قلب العلاقات والأدوار كما قلت لا ينتج إلاَّ المغالطات والخلط والغموض أي الإيديولوجيا السيئة كما حددها ماركس.
ليست اللغة العربية هي المسؤولة عن التخلف العلمي ، ولا لغات أخرى هي الطريق الملكي للعلوم . وكما قلت منذ زمن – وكما انتهى إلى ذلك أحد الكتاب المغاربة المتميزين ( )- فإن الروس أطلقوا أول قمر اصطناعي وحققوا نهضتهم العلمية بلغتهم القومية ، وكذلك الصين واليابان والهند وغيرهم . فكل هذه الأوطان خاضت معارك شاملة طويلة وشاقة، وأرست سياسات ومؤسسات عامة جعلت من اللغة أحد العناصر في تحقيق النهضة العلمية والتقنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية عموما. لذلك فنحن لا نجد لديهم كلاما حول ضرورة التعليم بلغات العلم لاستفادة مجتمعاتهم من سوق الشغل الذي تضمنه مجتمعات ولغات العلم لغيرهم . فإن أوطانهم هي سوق شغلهم ؛ إذ لا يمكن عزل السوق الاقتصادي عن طبيعة السياسات العامة لتدبير المجتمع في إطار ما يسميه “ألتوسير” بـ ” الكل البنيوي المعقد” .
لا ينبغي إذن أن ينطمس الحس النقدي في من عهدناهم عقولا نيرة، ولا ينبغي ذرُّ الرَّماد في العيون والهرولة ، ولا الانسياق مع الخزعبلات. فليست اللغة العربية أو لغة قريش ، كما يقولون ، آثمة إلى هذا الحدِّ؛ وليست لغات الغرب الأخرى نازلة مطهرة وقدسية وعلمية وحضارية مكتملة منذ بداياتها، بل إن تاريخها يشهد عليها … ، ومن ذلك أنه ، وإلى غاية القرن 18 م ، كان العلماء والفلاسفة أمثال ” غاليليو” و ” ديكارت” و ” سبينوزا” وغيرهم يكتبون مؤلفاتهم العظيمة باللغة اللاتينية ـ التي جرت العادة على اعتبارها لغة العلم آنذاك ـ وليس بلغاتهم الوطنية . ونحن نعلم الآثار الجليلة لمؤلفات هؤلاء بعد ترجمتها إلى اللغات القومية الأوروبية .
ومن المؤسف أيضا، وفي سياق الحملات على اللغة العربية وثقافتها ، أننا لا نرى الإرث الثقافي الباذخ لهذه اللغة العربية وذلك في مختلف المعارف من آداب ولغويات وبلاغة ونحو وعلم كلام وفلسفات وغير ذلك . فإن الذي ينكر هذا إمَّا جاحد أو جاهل .
فبهذه اللغة أبدع طرفة بن العبد وزهير بن أبي سلمى الحِكَمَ السارية … وأبدع محمود درويش والسَّياب والبياتي وصلاح عبد الصبور والمجاطي والشابي وأبو ماضي وجبران وميخائيل نعيمة وحنَّا مينه وطه حسين وحسن حنفي ومحمود أمين العالم والعروي والجابري وبلقزيز وسبيلا واللائحة طويلة. وبهذه اللغة يمكن للأجيال العربية استئناف التفكير والتفكير العلمي وإنتاج العلوم .
وأخيرا، مرحبا بلغات العالم؛ فلقد تعلمنا منها واستفدنا الشيء الكثير، حيث كان لها أثر في تفكيرنا وتصورنا للأشياء . وإنني لأدعو إلى تعزيز مكانتها في منظومتنا التعليمية ، بل وترسيمها في كليات العلوم بمعاملات لا تَقِلُّ عن معاملات المواد العلمية، وذلك ضمن تصور بيداغوجي محكم يربط اللغات بالنصوص العلمية
والترجمة وآفاق البحث العلمي…
غير أن الحقيقة الدامغة التي لا ترتفع وهي : دَرِّسُوا بما تشاؤون ، باللغات الأجنبية أو العربية ، بلغة الملائكة أو بلغة الشياطين ، فإنه لن تقوم لنا قائمة ، ولن نصل إلى أعتاب العلم ما دامت البنيات والمؤسسات والسياسات الاجتماعية والثقافية غير مؤهَّلة لإنتاج العلم .